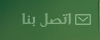القيمة الإنسانية في المنظور الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾
صدق الله العلي العظيم
انطلاقًا من الآية المباركة نتحدث في نقطتين:
- الفرق بين التكريم والتفضيل.
- بيان القيمة الإنسانية في الإسلام.
النقطة الأولى: الفرق بين التكريم والتفضيل.
نلاحظ أن الآية المباركة ذكرت عنوانين: عنوانًا في أول الآية، وهو عنوان التكريم، ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾، وعنوانًا آخر في ذيل الآية، وهو عنوان التفضيل، ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾، فما هو الفرق بين التكريم والتفضيل؟ التكريم هو إعطاء الشخص كرامته، بمعنى إعطائه حقه. كل إنسان له حق من الإنسانية، وإعطاؤه حقه من الإنسانية تكريمٌ. وأما التفضيل فهو تمييزه على غيره بنوع من أنواع التمييز.
مثال: أنت عندما تكون مدرسًا، وأمامك مجموعة من الطلاب، فإنك عندما تطرح سؤالًا على طلابك، فيبادر أحدهم للجواب، ويجيب عن السؤال جوابًا صحيحًا، هنا أنت تتعامل مع هذا الطالب بأسلوبين: تارة تتعامل معه بأسلوب التكريم، وتارة تتعامل معه بأسلوب التفضيل. تتعامل معه بأسلوب التكريم بمعنى: تعطيه حقه، بما أنه أجاب عن المسألة جوابًا صحيحًا فتكريمه أن تعطيه حقه، كأن تعطيه درجة أو خمس درجات، أو أن تمدحه وتثني عليه وتشجعه، فإعطاؤه حقه يسمى تكريمًا له؛ لأنك لو لم تصنع معه ذلك يعد ذلك إهانةً واحتقارًا له. وأما إذا لم تكتفِ بإعطائه حقه، بل انتقلت إلى أسلوب أرقى وأكبر من ذلك، فأعطيته جائزة أو هدية تميّزه بها على بقية الطلاب، فهذا يسمى تفضيلًا، وهكذا انتقلت من مرحلة التكريم إلى مرحلة التفضيل.
النقطة الثانية: القيمة الإنسانية في الإسلام.
هذه هي النقطة المهمة والمحورية في موضوعنا. الله «تبارك وتعالى» أعطى الإنسان كرامة تكوينية وكرامة قانونية، فالإنسان مكرّمٌ على المستويين: المستوى التكويني، والمستوى التشريعي والقانوني. أما الكرامة التكوينية فهي أن هذا الإنسان خُلِق على أفضل صورة وعلى أفضل شكل، ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾، وقال في آية أخرى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ * وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾. هذه كرامة تكوينية: خُلِق بأفضل صورة، وبأفضل وسائل يعيش بها؛ ليكتسب المعلومات من خلالها. إذن هناك كرامة تشريعية وقانونية.
شبهة علمانية:
هناك مجموعة من الأقلام العلمانية تحدثت عن الإسلام، فقالت بأن الإسلام ألغى القيمة الإنسانية، إذ إنه يكرّس على القيمة السماوية ويلغي القيمة الإنسانية. كل شيء يربطه بالسماء، وإذا لم يكن له ربط بالسماء فلا قيمة له، حتى ولو كان عنصرًا إنسانيًا. الإسلام يركّز على القيمة السماوية، ويلغي القيمة الإنسانية، وهناك عدة دلائل وصور من القوانين الإسلامية توحي بأن الإسلام لا يحترم القيم الإنسانية، وإنما يحترم القيم السماوية فقط.
الصورة الأولى: الكرامة للمسلم لا للإنسان.
أنَّ الإسلام يكرّم الإنسان لأنه إنسان، بل لأنه مسلم، فإذا كان مسلمًا فله كرامة، وإن لم يكن مسلمًا فلا كرامة له، فإذن هو لا يراعي القيمة الإنسانية، وإنما يراعي القيمة السماوية. ولذلك تلاحظ النصوص القرآنية تحث المسلم على إلغاء الطرف الآخر، ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾. الإسلام يحث أتباعه على إلغاء العنصر الآخر، على إلغاء الطرف الآخر، لأنه ليس سماويًا، وإن كان طرفًا إنسانيًا مثلًا. إذن، إذا لاحظنا هذه النصوص، وجدنا أن الإسلام لا يكرّم الإنسان لأنه إنسان، وإنما يكرّم الإنسان ويحترمه ويراه صاحب حرمة - ماله حرام، دمه حرام، عرضه حرام - إذا كان مسلمًا، وأما إذا لم يكن مسلمًا فلا حرمة له.
الصورة الثانية: إلغاء العلاقات الإنسانية.
الإسلام يلغي العلاقات الإنسانية، ويقول: هذه العلاقات الإنسانية لا قيمة لها عندي، وإنما المهم أن تكون علاقات في الله، فإذا لم تكن علاقات في الله فلا قيمة له. العلاقة المبنية على دوافع إنسانية، وإن لم تكن مرتبطة بالسماء، وإن لم تكن مرتبطة بالله، هذه العلاقة لا قيمة لها في نظر الإسلام، المهم أن تكون العلاقة في الله. ولذلك ترى بعض النصوص تركّز على هذا المعنى، كقوله تعالى في مدح النبي  : ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾، المسألة مسألة عنصرية، المسألة مسألة دينية، إذا كان سماويًا فهو مستحق للرحمة، وإذا لم يكن سماويًا فلا، فهو يدعو للعلاقات المبنية على العنصر السماوي، ويلغي العلاقات المبنية على العنصر الإنساني. ولذلك ورد عن الرسول
: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾، المسألة مسألة عنصرية، المسألة مسألة دينية، إذا كان سماويًا فهو مستحق للرحمة، وإذا لم يكن سماويًا فلا، فهو يدعو للعلاقات المبنية على العنصر السماوي، ويلغي العلاقات المبنية على العنصر الإنساني. ولذلك ورد عن الرسول  : ”أحبوا في الله، وابغضوا في الله“، أي: حبك يجب أن يكون لله لا لعنصر آخر، وبغضك يجب أن يكون لله لا لعنصر آخر، فالعناصر والدوافع الإنسانية لا قيمة لها، وإنما القيمة للعنصر السماوي، وللدوافع السماوية.
: ”أحبوا في الله، وابغضوا في الله“، أي: حبك يجب أن يكون لله لا لعنصر آخر، وبغضك يجب أن يكون لله لا لعنصر آخر، فالعناصر والدوافع الإنسانية لا قيمة لها، وإنما القيمة للعنصر السماوي، وللدوافع السماوية.
الصورة الثالثة: احتقار الطاقات الإنسانية.
ومن الصور التي تنعكس من خلال النصوص الإسلامية أن الإسلام يحتقر الطاقة الإنسانية إذا لم تُبْذَل لوجه الله. مثلًا: أديسون اخترع الكهرباء، لا قيمة له! العالم الفلاني توصل إلى الذرة، لا قيمة له! الإنسان الفلاني اخترع الطائرة، لا قيمة له! إذن، هو يلغي الطاقات الإنسانية، فكل الطاقات والجهود والقدرات التي بذلها الإنسان وكدح عليها إلى أن أخرجها إلى عالم النور، الإسلام يحتقرها ويلغيها؛ لأنها لم ترتبط بالسماء. ولذلك في النصوص الإسلام تقرأ مثلًا قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ﴾، وقال في آية أخرى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾. إذن، هو يحتقر الجهود والطاقات؛ لأنها لم ترتبط بالسماء.
إذن بالنتيجة: الإسلام يلغي القيمة الإنسانية، ويحصر القيمة والكرامة في العنصر السماوي. هذه هي المقالة التي يطرحها الكثير من الباحثين العلمانيين عندما يتحدثون عن الفكر الإسلامي. نحن عندما نريد أن نجيب عن هذه المقالة، نقول: هذه المقالة خاطئة جدًا، ولا تعكس واقع الفكر الإسلامي، وأنا الآن أركّز معك على أمور تبيّن لك أن الإسلام يهتم ويعنى بالقيمة الإنسانية أشدَّ اهتمام وعناية.
الأمر الأول: احترام الإسلام لمبدأ الإنسانية.
الإنسانية من حيث هي يحترمها الإسلام في عدة نصوص، كالنص الذي قرأناه وافتتحنا به المحاضرة: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾، ولم يقل: المسلمين، بل ابن آدم بما هو ابن آدم، بما هو إنسان، نحن أعطيناه كرامة تكوينية وكرامة تشريعية، فهو مكرّمٌ من حيث التكوين، ومن حيث التشريع والقانون. كذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ سواء كان أهلها كفّارًا أو مسلمين ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ﴾ سواء كانوا مسلمين أو كفارًا ﴿أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾، أي أن الناس لهم قيمة، فمن حقهم أن يُحْكَم بينهم بالعدل، ومن حقهم أن تؤدّى الأمانات لهم، فلهم قيمة وكرامة.
الإمام أمير المؤمنين  علي بن أبي طالب كان يفيض إنسانية، وكان يحترم مبدأ الإنسانية. يقول في عهده لمالك بن الأشتر: ”وأشعر قلبك الرحمة للرعية، واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعًا ضاريًا، تغتنم أكلهم؛ فإنهم صنفان: إما أخٌ لك في الدين، أو نظيرٌ لك في الخلق“، كلاهما يستحقان منك الرحمة واللطف، سواء كان أخاك في الدين أو نظيرًا لك في الخلق، أي: سواء كان مسلمًا أو نظيرًا لك في الإنسانية.
علي بن أبي طالب كان يفيض إنسانية، وكان يحترم مبدأ الإنسانية. يقول في عهده لمالك بن الأشتر: ”وأشعر قلبك الرحمة للرعية، واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعًا ضاريًا، تغتنم أكلهم؛ فإنهم صنفان: إما أخٌ لك في الدين، أو نظيرٌ لك في الخلق“، كلاهما يستحقان منك الرحمة واللطف، سواء كان أخاك في الدين أو نظيرًا لك في الخلق، أي: سواء كان مسلمًا أو نظيرًا لك في الإنسانية.
إذن الإنسان بما هو إنسان، مبدأ الإنسانية مبدأ محترم في الإسلام. نعم، إذا كان مقاتلًا محاربًا، إذا كان هذا الإنسان يحاربني ويعتدي عليَّ، ويعتدي على ثرواتي وأموالي وأرضي ووجودي، إذا كان هذا الإنسان في مقام المحاربة لي، وفي مقام الاعتداء عليَّ، فحينئذ تسقط قيمته، لا لإلغاء الإنسانية، بل لأجل الدفاع عن النفس. نحن لا نلغي حرمته ولا كرامته، بل هو إنسان له كرامة الإنسانية وحرمتها، ولكنني انطلاقًا من مبدأ الدفاع عني، عما يتعلق بي، من أرض وثروة ووجود وكيان، من باب الدفاع عن النفس: أنا أدفع هذا الإنسان وأحاربه.
ولذلك الآيات القرآنية تربط قتال المسلمين بقتال الكفار، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾، ويقول في آية أخرى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ هم أولًا قوتلوا، ثم أذن لهم في القتال، وإلا لو لم يقاتَلوا فإن الآخرين محترمون، وكرامتهم الإنسانية محفوظة. إذن، إذا كان هو في مقام المحاربة، وفي مقام المواجهة، وفي مقام إلغائي من الوجود، فأنا من باب الدفاع عن النفس أقاتله، وإلا فنحن لا نلغي مبدأ الكرامة الإنسانية.
الأمر الثاني: احترام الإنسان للعلاقات الإنسانية.
الإسلام يركّز على العلاقات الإنسانية بما هي إنسانية، مع غض النظر عن كونها بين مسلمين أو بين مسلم وكافر، لوجه الله أو لدوافع إنسانية، العلاقة الإنسانية يحترمها الإسلام، فقد ورد عن الرسول محمد  : ”الدين المعاملة“، أي أن الدين يرتكز على حسن المعاملة، مع أي شخص، ”إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق“، وفي صحيحة الحسين بن أبي العلاء عن الإمام الصادق
: ”الدين المعاملة“، أي أن الدين يرتكز على حسن المعاملة، مع أي شخص، ”إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق“، وفي صحيحة الحسين بن أبي العلاء عن الإمام الصادق  : ”ما بعث الله نبيًا قط إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة للبر والفاجر“. ولذلك، ورد عن الإمام زين العابدين
: ”ما بعث الله نبيًا قط إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة للبر والفاجر“. ولذلك، ورد عن الإمام زين العابدين  : ”لو أنَّ قاتل أبي الحسين ائتمنني على السيف الذي يقتل به والدي، لما خنته فيه“.
: ”لو أنَّ قاتل أبي الحسين ائتمنني على السيف الذي يقتل به والدي، لما خنته فيه“.
ولذلك، ترى القرآن الكريم يركّز على ناحية حفظ العلاقات الإنسانية بما هي إنسانية، وإن لم تكن سماوية. يقول القرآن الكريم: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾، لا مانع من أن تكون بينك وبين الكافر علاقة ودية، ما دام إنسانًا مسالمًا غير محارب. ما دام هو إنسانًا، فالعلاقة الإنسانية معه أمرٌ لا ينهى عنه الإسلام، ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾. إذن، الإسلام أيضًا لا ينهى عن العلاقة الإنسانية مع الطرف الآخر.
وأما الآية القرآنية: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾ أي: في وقت القتال، في وقت الحرب، في مجال الدفاع عن النفس، في مجال الدفاع عن الكيان الإسلامي، وليست الآية مطلقة. لا تتحدث الآية عن الكافر بصفة عامة، ولا تريد أن تلغي العنصر الإنساني بصفة عامة.
الأمر الثالث: اهتمام الإسلام بحفظ النظام.
الإسلام ينص على ما يسمّى بحفظ النظام، وهذا ما يعبّر عنه بسلامة البيئة وصيانتها، حفظ النظام ينص الإسلام عليه، ويراه من الواجبات الضرورية. أنت لا يجوز لك أن تقوم بأعمال تفسد البيئة وتلوثها، فمثلًا: لا يجوز لك أن تقوم بحرائق تفسد البيئة، تقضي على الزرع، أو تقضي على الحيوانات الأليفة، أو تقضي على الإنسان. حفظ النظام - أي: النظام الذي يحفظ الأعراض والأنفس والأموال من التلف - ولو لم يكن حفظًا فعليًا، بل حتى لو كان حفظًا مستقبليًا، حفظ النظام المتضمن لسلامة البيئة وصحتها يراه الإسلام من الواجبات الضرورية على كل إنسان.
مثلًا: الآيات القرآنية تركّز على هذا المعنى، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾، الإفساد في الأرض محرم، وقتل البيئة إفسادٌ في الأرض. كذلك قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ﴾. إذن بالنتيجة: القرآن ينص على حفظ النظام. تراعي قوانين المرور، تراعي قوانين الصحة، تراعي القوانين التي تحفظ الأعراض والأنفس والأموال، وسلامة البيئة وصحتها، كل القوانين التي تحافظ على نظام المجتمع وسلامة النفوس والأعراض والأموال والبيئة التي يعيش فيها الناس، هذا يسمّى بالنظام الذي يجب حفظه على كل فرد، ولكن لماذا يجب حفظه؟
الإسلام إنما يأمرك بالمحافظة على البيئة لا كرامة لها، بل كرامة لمن يعيش في هذه البيئة، كرامة للإنسان بما هو إنسان. ولذلك، أنت تقرأ في صحيحة جميل بن درّاج عن الإمام الصادق  : ”إن رسول الله ما بعث سرية حتى دعاهم وأجلسهم بين يديه وقال: سيروا باسم الله، وبالله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله، لا تغلوا“ أي: لا تقيدوا أحدًا، ”ولا تمثّلوا“ أي: لا تعتدوا على أجساد الموتى، ”ولا تغدروا“ أي: لا تستخدموا لغة الغدر والخديعة، ”ولا تقتلوا شيخًا فانيًا، ولا صبيًا، ولا امرأةً، ولا تقطعوا شجرًا“ لاحظ كيف هي المحافظة على البيئة، لأجل الإنسان، ولأجل كرامة الإنسان، ”ولا تحرقوا زرعًا، إلا أن تضطروا إليه“. إذن الرسول
: ”إن رسول الله ما بعث سرية حتى دعاهم وأجلسهم بين يديه وقال: سيروا باسم الله، وبالله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله، لا تغلوا“ أي: لا تقيدوا أحدًا، ”ولا تمثّلوا“ أي: لا تعتدوا على أجساد الموتى، ”ولا تغدروا“ أي: لا تستخدموا لغة الغدر والخديعة، ”ولا تقتلوا شيخًا فانيًا، ولا صبيًا، ولا امرأةً، ولا تقطعوا شجرًا“ لاحظ كيف هي المحافظة على البيئة، لأجل الإنسان، ولأجل كرامة الإنسان، ”ولا تحرقوا زرعًا، إلا أن تضطروا إليه“. إذن الرسول  يقرأ لنا تعاليم، ليست تعاليم سماوية فقط، بل تعاليم إنسانية. قوانين حفظ النظام، قوانين حفظ البيئة، قوانين سلامة البيئة، كل ذلك كرامةً للإنسان، واهتمامًا بالإنسان، وعنايةً بالإنسان.
يقرأ لنا تعاليم، ليست تعاليم سماوية فقط، بل تعاليم إنسانية. قوانين حفظ النظام، قوانين حفظ البيئة، قوانين سلامة البيئة، كل ذلك كرامةً للإنسان، واهتمامًا بالإنسان، وعنايةً بالإنسان.
الأمر الرابع: مراتب الارتباط بالسماء.
ذكر العلمانيون أن الإسلام يحتقر أعمال الآخرين إذا لم تكن لوجه الله «تبارك وتعالى»؛ استنادًا لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً﴾، فإن الإنسان بمجرد أن يقرأ هذه الآية يفهم منها أن أعمال الكفار لا قيمة لها، ولو كانت جهودًا وطاقاتٍ إنسانية. في مقام الجواب نقول: قصد وجه الله «تبارك وتعالى»، أو الارتباط بالسماء، على مرتبتين، وعلماء العرفان يذكرون هاتين المرتبتين.
الدرجة الأولى: قصد المملوكية الذاتية.
الإنسان إذا التفت إلى أنَّ الله يملك كلَّ ما في الكون ملكيةً حقيقيةً حقةً، هذه مصطلحات لست في مقام شرحها الآن.. إذا التفت الإنسان إلى أن جميع ما في الوجود من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة، من إنسان، من نبات، من حيوان، من أي شيء، جميع ما في الوجود ملك لله، الله يملكه ملكية حقيقية حقة، إذا التفت الإنسان إلى ذلك، والتفت إلى أن عمله أيضًا ملك لله، هذا العمل الذي أقوم به، الإتيان إلى الحسينية أو المسجد، الصلاة والصيام، هذه الأعمال كلها ملك لله «تبارك وتعالى»، ليس في الكون شيء.. حتى الإنسان وأعماله وأفكاره وخلجاته ونواياه، جميع ما في الكون ملكٌ لله «تبارك وتعالى»، إذن أنا أسلّم الملك لمالكه.
عملي ملك لله، فأسلمه له، أي: أقصد به وجه الله «تبارك وتعالى»، فأنا عندما أقصد التقرب إلى الله بصلاتي، بصيامي، بصدقتي، بصلة رحمي، حتى بتدريسي، حتى بتعليمي، حتى بعلاقتي مع الناس، حتى بارتباطي مع الناس، جميع حركاتي أقصد بها التقر إلى الله «تبارك وتعالى»، هذا معناه شعور بالمملوكية الذاتية. أشعر بأنني مملوك ملكًا ذاتيًا لله «تبارك وتعالى»، أنا مملوك بتمام أموري، فأنا أسلّم الملك لمالكه، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾. هذه هي الدرجة الأولى من درجات العلاقة مع الله، وهي الدرجة الأرقى والأكمل.
الدرجة الثانية: قصد الرحمة.
أنت عندما تقرأ القرآن الكريم، تجد أنه أحيانًا يسند العمل إلى الذات الإلهية، وأحيانًا يسند العمل إلى وجه الله «تبارك وتعالى»، أحيانًا الله «تبارك وتعالى» يقول: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ ادعوني أنا، ولم يقل: ادعوا وجهي. ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ إذا قصدني أنا ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾. وأحيانًا لا تقصد الذات، بل تقصد وجه الله، ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ﴾، وجه الله غير ذات الله، أحيانًا الإنسان يقصد ذاته، وأحيانًا يقصد وجهه «تبارك وتعالى»، فما معنى وجه الله؟
وجه الله صفته، كما أن الإنسان له ذات وله وجه، وجهه مظهره، أنا عندي ذات، عندي روح، وعندي وجههي، وجههي هو مظهري، كما أن للإنسان ذاتًا ووجهًا، الله «تبارك وتعالى» له ذات وله وجه، وجهه «تبارك وتعالى» هي أفعاله التي برأ بها هذا الوجود، هي وجهه، نحن لا نستطيع أن نعرف ذاته، لكن نستطيع أن نعرف وجهه، نحن لا نرى ذاته لكن نرى وجهه، نرى خلقه، الخلق وجهه، نرى الرزق، الرزق وجهه، نرى الرحمة، الرحمة وجهه، أفعاله - أو الصفات الفعلية بحسب مصطلح علماء الكلام - مظاهر ذاته، تجليات ذاته، بما أن أفعاله مظاهر ذاته وتجليات ذاته، فأفعاله هي وجهه «تبارك وتعالى».
إذن، أنا عندما أقصد وجه، يعني أقصد صفة من صفات الله الفعلية، أقصد صفة الرحمة، فقد قصدت وجهه، وهذا نوع من التقرب إلى الله، نوع من الارتباط بالله، وإن لم أقصد المملوكية الذاتية، لم أقصد الدرجة الأولى، بل قصدت الدرجة الثانية. مثلًا: أنا الآن ألتقي بإنسان فقير معدم يرثى له، هذا الإنسان الفقير إذا رأيته يرق قلبي له، وبدافع الرحمة أتصدق عليه، أو أكسوه، أو أطعمه، أو أنقذه من أمر هو فيه، بدافع الرحمة أحن عليه، وأنا في ذلك الوقت لم ألتفت إلى أنني مملوك لله، وأن الملك يرجع لمالكه، كل ذلك لم ألتفت إليه أصلًا، قصدت فقط التصدق على هذا الفقير بدافع الرحمة، متى ما قصدت التصدق بدافع الرحمة فهذا قصد صفة من صفات الله «تبارك وتعالى»، ألا وهي صفة الرحمة.
من صدرت منه هذه الأعمال بدافع الرحمة، أي: تجرد من أنانيته، تجرد من ذاته، سحق ذاته، سحق أنانيته، وصار يفعل بدوافع الإنسانية فقط، صار يعمل بدوافع الرحمة فقط، من قصد الرحمة فقد قصد صفة من صفات الله التي بثّها في هذا الكون، وهي صفة الرحمة، ومن قصد صفة الرحمة فقد قصد وجه الله «تبارك وتعالى». نحن لا نلغي الإنسان الكافر، حتى الإنسان الكافر إذا عمل عملًا إنسانيًا، فتارة الإنسان الكافر يخترع الكهرباء ويكتشف الذرة بدوافع شخصية بروجرماتية مصلحية، فهذا العمل لا قيمة له عند الله «تبارك وتعالى»، وإن كانت له قيمة بحسب المقاييس المادية، ولكن لا قيمة له بحسب المقاييس الإسلامية.
أما إذا لم تكن دوافعه شخصية، بل كانت دوافعه إنسانية بحتة، أي: قصد من خلال عمله الرحمة، يريد أن يبث الرحمة على المجتمع الإنساني، يريد أن يعالج وضعًا مقيتًا في المجتمع الإنساني بدافع الرحمة، فقد قصد وجهًا من وجوه الله، قصد الرحمة، وهي صفةٌ لله، ووجه من وجوهه، فقد قصد وجه الله من حيث يشعر أو لا يشعر.
نتيجة البحث:
إذن بالنتيجة: نحن لا نلغي الطاقة الإنسانية، ولا نلغي العمل الإنساني، إذا كان العمل الإنساني في إطار وجه الله، أي: في إطار الرحمة، وفي إطار الدوافع الإنسانية. ولذلك، تجد كثيرًا من النصوص تنصّ على احترام الإنسان بما هو إنسان إعظامًا للمقام الإنساني، وإعظامًا للدوافع الإنسانية، ففي بعض الروايات مثلًا يشار إلى هذا المعنى، كصحيحة ابن أبي عمير: كنتُ عند الإمام الصادق  ، فجاء شخصٌ، سأل بعض الحاضرين، قال: ما فعل غريمك؟ الغريم هو الإنسان المدين، قال: دعه، إنه ابن الفاعلة! التفت إليه الإمام الصادق بشدة وقال: ماذا تقول؟! قال: سيدي، إنه مجوسي، ينكح أمه وأخته! قال: ”ويحك! أليس ذلك في دينهم نكاحًا؟!“.
، فجاء شخصٌ، سأل بعض الحاضرين، قال: ما فعل غريمك؟ الغريم هو الإنسان المدين، قال: دعه، إنه ابن الفاعلة! التفت إليه الإمام الصادق بشدة وقال: ماذا تقول؟! قال: سيدي، إنه مجوسي، ينكح أمه وأخته! قال: ”ويحك! أليس ذلك في دينهم نكاحًا؟!“.
هم هذا هو دينهم، في دينهم يرون جواز نكاح الأمهات والأخوات، وما دام هذا دينهم، فلا يصح لك أن تنسبهم إلى الزنا، وهم يسيرون على طبق دينهم. لا يصح لك أن تقول: فلان ابن زنا لأن فعل شيئًا يعد عندنا في الإسلام زنا! هم في دينهم ليس كذلك. ولذلك، ورد عن الإمام الصادق  : ”لكل قوم نكاح“ أي: لكل قوم طريقة في الزواج، وطريقة في الطلاق، وطريقة في الفراق، فكل دين يُحْتَرَم على طبق قوانينه، هذا احترام لمبادئ الإنسانية، إعطاء كرامة للإنسان.
: ”لكل قوم نكاح“ أي: لكل قوم طريقة في الزواج، وطريقة في الطلاق، وطريقة في الفراق، فكل دين يُحْتَرَم على طبق قوانينه، هذا احترام لمبادئ الإنسانية، إعطاء كرامة للإنسان.
وفي رواية أخرى: صحيحة محمد بن مسلم: قال: إنسان قطع رأس إنسان، ما عليه؟ قال: عليه الدية «المقصود أنه قطع رأسه بعد موته، وإلا لو قطع رأسه وهو حي لقُتِل»، قال: لم؟ قال: ”لأن حرمته ميتًا كحرمته حيًا“. الإنسان محترم حيًا وميتًا، ولذلك يكون قطع رأسه، أو التمثيل بجسده، أو الاعتداء على بدنه، لا يجوز ولو كان كافرًا، فضلًا عما إذا كان مسلمًا.
الإسلام يجري على الأصول الإنسانية، يجري على المبادئ الإسلامية، يحمّل الإنسان إذا اعتدى على الإنسان الآخر، حتى أرش الخدش. مثلًا: الأم لا يجوز لها أن تضرب طفلها، إلا أن تستأذن من الأب، الأب له ولاية على الطفل، الأم ليس لها ولاية على الطفل، فلا يجوز لها ضرب طفلها. على كل حال، الأب أيضًا لا يجوز له أن يضرب ولده ضربًا مبرحًا، وإنما يضربه ضربًا تأديبيًا، بحيث لا يصل إلى حد الضرب المبرح، إذا كان طفله طبعًا غير بالغ. إذا افترضنا أن الأب ضرب طفله ضربة أوجبت احمرار وجهه، فإنه يدفع دية، مع أنه هو الأب! إذا خدش بولده خدشًا يصل إلى هذه الدرجة فإنه يدفع الدية، وتكون الدية ملكًا للطفل.
الإسلام يراعي حتى هذا المستوى، حتى هذه الدرجة، يراعيها الإسلام، ويقننها، ويشرّعها، كرامةً للإنسان، لا يجوز الاعتداء عليه بأي وسيلة من الوسائل، وهذه من ضروريات الإسلام، ومن بديهياته. أول من ضرب هذه البديهيات عرض الحائط، وأول من ضرب الأصول الإنسانية والمبادئ الإسلامية، واعتدى على الأجساد اعتداءً وحشيًا، هم بنو أمية. ولذلك يقال: أول رأس رُفِعَ على خشبة هو رأس عَمْرٍ بن الحمق الخزاعي، حيث قتله معاوية ورفع رأسه على خشبة، وأول رأس طيف به في البلدان هو رأس الحسين بن علي، مع أن حكومة بني أمية تدّعي أنها خلافة للنبي، وهي ترتكب هذا مع ذرية رسول الله.