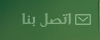دعوى تهافت أصول الفكر الإمامي ج2
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾
صدق الله العلي العظيم
تواصلًا مع حديثنا السابق، هناك فكرةٌ تطرحها مجموعةٌ من الأقلام، وهي أنَّ الفكر الإمامي يشتمل على تهافت في أصوله وفي أسسه، فالفكر الإمامي من جهةٍ يتبنى العقل الفطري، ومن جهةٍ أخرى يتبنى معتقداتٍ تتصادم مع صفاء العقل الفطري، ومع طبيعة العقل الفطري، ولكي ندلّل على ذلك نذكر ثلاث مفارقات، إذا تأملنا فيها وجدنا أن هناك تصادمًا بين المعتقد الإمامي، وبين نداء العقل الفطري، وما يقتضيه العقل الفطري.
المفارقة الأولى: أنَّ الفكر الإمامي يشتمل على المنهج التوفيقي.
الفكر الإمامي يقرّر معتقداتٍ معينةً، فأصول موضوعية مسلَّمة، ثم إذا اصطدم ببعض النصوص، أو اصطدم ببعض الأحداث التي تتنافى مع المعتقد، يرتكب التأويل، ويرتكب التبرير، يبرّر النصوص، ويبرّر الأحداث، بحيث لا تتنافى ولا تتصادم مع المعتقد الذي بنى عليه وأصّله في رتبةٍ سابقةٍ، فمثلًا: عندما تلاحظ الفكر الإمامي في مجال استدلالاته، تجده يسير تمامًا مع العقل الفطري، ما يقتضيه العقل الفطري هو يمشي معه، فعندما يأتي شخصٌ ويستدل على توحيد الله «عز وجل»، ما هو الدليل على أن الله «عز وجل» واحد؟
ربما يستدل شخصٌ على ذلك - كما في بعض الكتب الإسلامية - قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا﴾! الفكر الإمامي لا يقبل هذا الاستدلال، بل يقول: هذا استدلال لا ينسجم مع العقل، إذ كيف تستدل على وحدانية الله بكلام منسوب إلى الله؟! لعلَّ هذه الآية صدرت من شريك الله، لعل هناك إلهًا غير الله، هو الذي صدرت منه هذه الآية، أنت يجب أن تثبّت أولًا أن الله واحد، حتى يثبت أن هذا الكلام صدر من الله «عز وجل»، إذ لعله صدر من إله آخر يشترك مع الله في الألوهية، كيف تستدل على وحدانية الله بكلام الله نفسه؟! هذا استدلال خاطئ، لا بد أن تستدل بالعقل، لا بد أن تستدل بطريق آخر، كما يستدل به علماؤنا، ولا أريد أن أدخل في هذه الاستدلالات، إذ ليس المجال مجالها، هناك ملازمة بين وجوب الوجود وبين الوحدانية، من كان واجب الوجود فهو واحد، لأنه لو لم يكن واحدًا لكان محدودًا بشريك آخر، ولكان محدودًا بإله آخر، ومن كان محدودًا بإله آخر فلا يمكن أن يكون واجب واحد، وهذا يذكر في علم الكلام، لا نريد أن ندخل فيه.
نريد أن نقول: الإمامية لأنهم يسيرون على العقل الفطري، لا يقبلون هذه الاستدلالات الخاطئة، كالاستدلال على وحدانية الله بكلامه، أو يأتيك شخص آخر، تقول له: ما هو الدليل على أن القرآن غير محرّف؟ يقول لك: الدليل هو قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾، هذا استدلال دوري، أنت أولًا ثبّت أن هذه من القرآن حتى تستدل بها على عدم تحريف القرآن، لعل هذه ليست من القرآن، ما هو الدليل على أن هذه الآية من القرآن؟! أنت تستدل على أن القرآن غير محرف بآية من القرآن، هذه الآية ما هو الدليل على أنها غير محرفة؟! لعلها محرفة، هذا يسمى استدلالًا دوريًا، الاستدلال على عدم تحريف القرآن بنفس القرآن استدلال دوري، إذ لعل هذه الآية آية محرفة، فكيف تثبت من خلالها أن القرآن غير محرف؟! لا بد أن تستدل على عدم تحريف القرآن بدليل عقلي خارج من القرآن.
وهذا الدليل العقلي هو الملازمة بين المعجزة وعدم التحريف، لا يمكن أن يكون القرآن معجزةً للنبي منذ يومه وإلى يوم القيامة إلا إذا كان غير محرف، لا يجتمع التحريف مع كون القرآن معجزة للنبي محمد  .
.
الذي نريد أن نلخّصه وأن نصل إليه: أننا نلاحظ أن الفكر الإمامي فكر متنبهٌ ملتفتٌ، دائمًا يركز على الدليل العقلي، دائمًا يرجعون أدلتهم إلى البرهان العقلي، وهذا هو انسجام مع العقل الفطري، وسير على ضوء العقل الفطري، هذه صفحة جميلة جدًا في الفكر الإمامي أن يمشي على ضوء العقل الفطري، لكن من جهة أخرى تراهم يتشبثون بمعتقدات لا تنسجم مع العقل الفطري، ثم إذا اصطدموا بنص أو بحدث أولّوه، حتى لا يتنازلوا عن معتقداتهم.
مثال: الاعتقاد العصمة المطلقة.
الشيعة يعتقدون بالعصمة المطلقة، يقولون: النبي  أو الإمام
أو الإمام  معصوم عصمة مطلقة، لا يعصي ولا يخطئ ولا يسهو ولا ينسى، لا في مجال التشريع، ولا في مجال الممارسات الشخصية، معصوم عصمة مطلقة. بعد أن يقرروا هذه العقيدة يصطدمون مع النصوص، الله «تبارك وتعالى» يقول: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا * لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾، القرآن يقول: ذنبك، القرآن يقول: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى * وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى﴾، ماذا يفعلون؟!
معصوم عصمة مطلقة، لا يعصي ولا يخطئ ولا يسهو ولا ينسى، لا في مجال التشريع، ولا في مجال الممارسات الشخصية، معصوم عصمة مطلقة. بعد أن يقرروا هذه العقيدة يصطدمون مع النصوص، الله «تبارك وتعالى» يقول: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا * لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾، القرآن يقول: ذنبك، القرآن يقول: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى * وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى﴾، ماذا يفعلون؟!
يلتفون على النص، ويقومون بتأويله وتبريره، بحيث لا يصطدم مع معتقداتهم، ولا يتنافى مع معتقداتهم، وهذا ما يسمّى بالمنهج التوفيقي، فالمنهج التوفيقي هو أن تؤسّس أصلًا معينًا، ثم تؤول النصوص على طبق ما أسّست من فكر، وعلى طبق ما أسّست من أصول، هذا منهج توفيقي، والمنهج التوفيقي بعيدٌ عن العقل الفطري، مصادم مع العقل الفطري، إما أن تمشي على العقل في تمام أمورك، وإما أن تترك العقل جانبًا، أما أنك تعتمد العقل، ثم إذا واجهت نصًا، أو واجهت حدثًا، أوّلته على طبق معتقدك، فهذا ليس انسجامًا وتلاؤمًا مع طبيعة العقل الفطري.
الجواب عن هذه المفارقة:
نحن في جوابنا عن هذه المفارقة نقرّر أنَّ العصمة المطلقة لم يقرّرها الفكر الإمامي اعتباطًا، بل قرّرها لأن العقل الفطري يقتضي تقريرها. لأن العقل حكم بها، لذلك اعتبرها الفكر الإمامي من أصوله ومن معتقداته. كيف يحكم العقل بالعصمة المطلقة؟ نذكر هنا أمرين:
الأمر الأول: الملازمة بين إنكار العصمة المطلقة وتحقق الغرض من البعثة.
لولا العصمة المطلقة لانتقض الغرض من بعثة النبي، ومن نصب الإمام، ونقض الهدف قبيحٌ على الحكيم، لا يصدر من الحكيم. أنت تأتي إلى المسجد، أنت إذا جئت إلى المسجد بهدف معين، وهو الحصول على ثواب المشاركة في شعائر أهل البيت  ، وأنت تدري أن هذا الثواب لا يمكن أن تحصل عليه إلا إذا تجرّدت من المعصية حين دخولك إلى هذا المسجد، فلو اقترن دخولك المسجد بالمعصية لضاع الثواب، ولم تحصل عليه. إذا كنت تعلم بذلك، وأنت إنسان حكيم، جئت من أجل طلب الثواب، فدخلت المسجد، وارتكبت غيبة مؤمن في هذا المسجد، أنت أبطلت الثواب لأنك نقضت الهدف من مجيئك، نقضت هدفك بنفسك، الهدف من المجيء الحصول على الثواب، وأنت نقضت هذا الهدف بنفسك عندما قرنت دخولك وبقاءك في هذا المكان بالمعصية.
، وأنت تدري أن هذا الثواب لا يمكن أن تحصل عليه إلا إذا تجرّدت من المعصية حين دخولك إلى هذا المسجد، فلو اقترن دخولك المسجد بالمعصية لضاع الثواب، ولم تحصل عليه. إذا كنت تعلم بذلك، وأنت إنسان حكيم، جئت من أجل طلب الثواب، فدخلت المسجد، وارتكبت غيبة مؤمن في هذا المسجد، أنت أبطلت الثواب لأنك نقضت الهدف من مجيئك، نقضت هدفك بنفسك، الهدف من المجيء الحصول على الثواب، وأنت نقضت هذا الهدف بنفسك عندما قرنت دخولك وبقاءك في هذا المكان بالمعصية.
نقض الهدف، تضييع الهدف، قبيح من الحكيم، لا يصدر من الحكيم. الله «تبارك وتعالى» أيضًا لا ينقض أهدافه، ما هو هدفه تعالى من بعثة النبي محمد  ؟ الهدف من بعثة النبي هو أن يكون حجة يؤخذ بها، يؤخذ بكلامه، يؤخذ بتقريره، يؤخذ بجميع ما يصدر منه على أنه من الله «تبارك وتعالى»، ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾.
؟ الهدف من بعثة النبي هو أن يكون حجة يؤخذ بها، يؤخذ بكلامه، يؤخذ بتقريره، يؤخذ بجميع ما يصدر منه على أنه من الله «تبارك وتعالى»، ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾.
إذن، الهدف من بعثته أن يكون حجةً يؤخذ بما يصدر منه. هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق إلا إذا اطمأنت الأمة بأن هذا الشخص لا يخطئ، إذا اطمأن الناس، إذا وثق الناس أن هذا الشخص لا يخطئ، لا ينسى، لا يغفل، لا يعصي، إذا اطمأن الناس بأن هذا الشخص معصومٌ عصمةً مطلقةً لا يخطئ ولا ينسى ولا يغفل ولا يعصي، حينئذ يتحقق الهدف من بعثته، وهو أنه حجةٌ يؤخذ بما يصدر منه، وإلا فمتى ما تسرّب الشك إلى نفوس الناس، قالوا: من المحتمل أنه أخطأ، إذا تكلم بكلام أو صدر منه فعل، وقال الناس: من المحتمل أنه الآن أخطأ، من المحتمل أنه الآن نسي، من المحتمل أنه الآن عصى، إذا تسرب الشك إلى نفوس الأمة، واحتملوا أن نبيهم يخطئ أو يعصي أو ينسى، متى ما تسرب الشك فإن الأمة لن تأخذ بكلامه أو فعله حجة على الواقع، وحجة على كلام الله «تبارك وتعالى».
إذن، لا يتحقق الهدف من بعثته إلا إذا اطمأن الناس به، ولا يمكن أن يطمئن الناس إليه اطمئنانًا تامًا مئة بالمئة إلا إذا كان معصومًا، معصومًا عن الخطأ، معصومًا عن الزلل، معصومًا عن المعصية، إذا علموا أنه معصومٌ عصمةً مطلقةً اطمأنوا إليه اطمئنانًا تامًا، وإذا اطمأنوا إليه تحقق الهدف من بعثته، وما لم يطمئنوا إليه لم يتحقق الهدف من بعثته.
إذن، الله «تبارك وتعالى» حكيم، بعث النبي لهدف، وهو يعلم أنَّ هذا الهدف لا يتحقق إلا بالعصمة المطلقة، لذلك لا بد أن يرزقه العصمة المطلقة حتى يتحقق الهدف، فإنه إذا لم يعطه العصمة المطلقة فقد نقض هدفه بنفسه، ونقض الهدف قبيحٌ على الحكيم، لا يصدر من الإنسان العادي، فكيف منه «تبارك وتعالى»؟! إذن، المسألة مسألة عقلية، وليست مسألة نقلية، ولم نؤصلها مسلَّمًا من دون برهان، بل العقل هو الذي قادنا إلى أن نحكم، وإلى أن نقرّر العصمة المطلقة، العقل هو الذي قادنا إلى ذلك.
الأمر الثاني: خطأ التفكيك بين الجانب الشخصي والجانب التبليغي.
ربما يقول قائل: هذا في الأمور التبليغية، هو معصوم في الأمور التبليغية، إذا بلّغ عن الله فهو معصوم، لا يخطئ، لا ينسى، لا يذنب، كما ذكرت الآيات القرآنية: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا * لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾، النبي محاط بروح القدس، أينما يذهب هو محاط بروح القدس، روح القدس وظيفته المراقبة، ووظيفته المتابعة، بحيث لا يخطئ النبي، ولا ينسى، ولا يغفل، ولا يعصي، هذا بالنسبة للأمور التبليغية واضح، هو معصوم لأنه محاط بروح القدس.
أما في الأمور الشخصية، في ممارساته الشخصية، لماذا يجب أن يكون معصومًا؟ مثلًا: ربما يكون في علاقته مع زوجته مخطئًا، ربما يخطئ في علاقته مع زوجته، ربما ينسى في علاقته مع زوجته، إذن هو معصوم فيما يبلغه عن الله، أما في ممارساته الشخصية، مثلًا: النبي  التقى مع زوجته، نحن لا ندري، لعله أخطأ في علاقته مع زوجته، لعله أخطأ في تصرفه مع زوجته، لماذا نفترض أنه معصوم حتى في علاقته مع زوجته، وحتى في علاقته مع جاره، وحتى في علاقته مع ابنه، وحتى في علاقته مع الطبيعة؟! لماذا نفترض ذلك؟! أليس هذا مصادمًا مع العقل الفطري، أن تفترضه معصومًا حتى في ممارساته الشخصية، وكأنه إله لا يخطئ ولا ينسى ولا يغفل ولا يعصي؟!
التقى مع زوجته، نحن لا ندري، لعله أخطأ في علاقته مع زوجته، لعله أخطأ في تصرفه مع زوجته، لماذا نفترض أنه معصوم حتى في علاقته مع زوجته، وحتى في علاقته مع جاره، وحتى في علاقته مع ابنه، وحتى في علاقته مع الطبيعة؟! لماذا نفترض ذلك؟! أليس هذا مصادمًا مع العقل الفطري، أن تفترضه معصومًا حتى في ممارساته الشخصية، وكأنه إله لا يخطئ ولا ينسى ولا يغفل ولا يعصي؟!
نقول: لا، هو معصوم حتى في ممارساته الشخصية، والذي قرّر ذلك هو العقل أيضًا، نفس الدليل يأتي في الممارسات الشخصية. الرسول الأعظم  تارة يقوم بفعلٍ نعلم أنه تبليغٌ عن الله، مثلًا: في حجة الوداع، النبي ذهب، لم يعلم الناس الحج بالقول، بل اكتفى بأن قال: خذوا عني مناسككم، فصار يطوف والناس تطوف معه، سعى والناس تسعى معه، رمى الجمار ورمت الناس معه، وقف بعرفة وبمزدلفة ثم جاء إلى منى، رمى، ذبح، حلق، والناس تأخذ منه أفعاله؛ لأنه في مقام التبليغ عن الله «تبارك وتعالى».
تارة يقوم بفعلٍ نعلم أنه تبليغٌ عن الله، مثلًا: في حجة الوداع، النبي ذهب، لم يعلم الناس الحج بالقول، بل اكتفى بأن قال: خذوا عني مناسككم، فصار يطوف والناس تطوف معه، سعى والناس تسعى معه، رمى الجمار ورمت الناس معه، وقف بعرفة وبمزدلفة ثم جاء إلى منى، رمى، ذبح، حلق، والناس تأخذ منه أفعاله؛ لأنه في مقام التبليغ عن الله «تبارك وتعالى».
وأحيانًا يصدر فعلٌ من النبي  لا يدرى أنه تبليغٌ عن الله أو أنه سلوكٌ شخصيٌ، فمثلًا: نرى أن النبي يزور جاره اليهودي، لا ندري أنه عندما يزور جاره اليهودي هل هو في مقام التبليغ عن الله، أو أنه يمارس سلوكًا شخصيًا، إذا قلنا بأنه معصوم إذا كان يبلغ عن الله، وغير معصوم إذا كان يمارس سلوكًا شخصيًا، فنحن لا نعلم عندما زار جاره اليهودي هو معصوم في هذه الزيارة أو هو غير معصوم، من الذي يحدّد لنا ذلك؟ من الذي يحدّد لنا أن النبي في زيارته لجاره معصوم لأنه مبلغ عن الله أو غير معصوم لأنه يمارس سلوكًا شخصيًا؟ من الذي يحدّد لنا ذلك؟
لا يدرى أنه تبليغٌ عن الله أو أنه سلوكٌ شخصيٌ، فمثلًا: نرى أن النبي يزور جاره اليهودي، لا ندري أنه عندما يزور جاره اليهودي هل هو في مقام التبليغ عن الله، أو أنه يمارس سلوكًا شخصيًا، إذا قلنا بأنه معصوم إذا كان يبلغ عن الله، وغير معصوم إذا كان يمارس سلوكًا شخصيًا، فنحن لا نعلم عندما زار جاره اليهودي هو معصوم في هذه الزيارة أو هو غير معصوم، من الذي يحدّد لنا ذلك؟ من الذي يحدّد لنا أن النبي في زيارته لجاره معصوم لأنه مبلغ عن الله أو غير معصوم لأنه يمارس سلوكًا شخصيًا؟ من الذي يحدّد لنا ذلك؟
طبعًا الذي يحدّد لنا هو النبي نفسه، يقول: يا جماعة، أنا الآن لا أبلغ عن الله، بل أمارس سلوكًا شخصيًا، فلا تأخذوا بعملي هذا؛ لأنني لست الآن مبلغًا عن الله، أنا الآن أمارس سلوكًا شخصيًا، أو بالعكس، نرى النبي  .. كما في هذه الرواية التي هي محل خلاف: دخل بعض الصحابة على الإمام الصادق
.. كما في هذه الرواية التي هي محل خلاف: دخل بعض الصحابة على الإمام الصادق  وهو في الحمام يسبح، فرأوه يطلي، أي: يأخذ النورة ويزيل الشعر عن بدنه بها، يطلي بالنورة ليزيل الشعر عن بدنه، لكن نحن لا ندري لماذا لم يستخدم الحلق بالموس، لماذا لم يحلق شعر بدنه بالموس؟ لماذا يستخدم النورة؟ هل لأن استخدام النورة أفضل وأرجح شرعًا من الحلق؟ لماذا اختار الإمام هذا دون هذا؟ اختلفوا فيما بينهم، هل اختار الإمام النورة لأنها تعجبه، ولأنه يتأذى من الحلق، أم اختار النورة لأنها أرجح شرعًا، ولأنها أفضل شرعًا من استخدام الحلق في إزالة شعر البدن؟ صار عندهم تردد.
وهو في الحمام يسبح، فرأوه يطلي، أي: يأخذ النورة ويزيل الشعر عن بدنه بها، يطلي بالنورة ليزيل الشعر عن بدنه، لكن نحن لا ندري لماذا لم يستخدم الحلق بالموس، لماذا لم يحلق شعر بدنه بالموس؟ لماذا يستخدم النورة؟ هل لأن استخدام النورة أفضل وأرجح شرعًا من الحلق؟ لماذا اختار الإمام هذا دون هذا؟ اختلفوا فيما بينهم، هل اختار الإمام النورة لأنها تعجبه، ولأنه يتأذى من الحلق، أم اختار النورة لأنها أرجح شرعًا، ولأنها أفضل شرعًا من استخدام الحلق في إزالة شعر البدن؟ صار عندهم تردد.
إذن، إذا تردد الناس، لا ندري أن هذا سلوك شخصي، أو أنه تبليغ عن الله، من الذي يميّز؟ الذي يميّز هو الرسول، يقول: أنا الآن أبلغ عن الله، ولا أمارس سلوكًا شخصيًا، أو أنا أمارس سلوكًا شخصيًا ولا أبلغ عن الله، وهنا يأتي السؤال: إذا قال لنا النبي بأنه يمارس سلوكًا شخصيًا وليس مبلغًا، أو أنه مبلغ وليس يمارس سلوكًا شخصيًا، فهل هو معصوم في كلامه هذا، أم ليس بمعصوم؟! هو يقول: الآن أنا زيارتي لجاري تبليغٌ عن الله، هل هو في كلامه هذا معصوم أم غير معصوم؟! إذا قلتم معصوم فهذا كلامه ليس تبليغًا عن الله، بل هذا تحديد للموضوع، هذا الموضوع يدخل تحت التبليغ وهذا الموضوع لا يدخل تحت التبليغ، وإذا قلتم غير معصوم فقد اشتبه على الأمة كثير من أقوال النبي وأفعاله، حيث لا يستطيعون تمييزها ومعرفة أنها من الله فيأخذوا بها أو أنها ممارسة لسلوك شخصي فلا يحتجون بها.
إذن، إذا افترضنا أن النبي غير معصوم في الممارسات الشخصية، فنتيجة هذا الاعتقاد بأنه غير معصوم في الممارسات الشخصية سوف نلغي كثيرًا من أفعاله، ولا يمكننا الاحتجاج بها، لأننا لا نعلم أنها تبليغ عن الله أو من سلوكه، ولو أخبرنا هو فلعله أخطأ في إخباره، ولعله نسي، ولعله غفل. إذن فبالنتيجة: إذا اعتقدنا بهذا الفرز بين مقام التبليغ ومقام السلوك الشخصي سوف تختلط علينا أفعاله وسلوكياته، ونتيجة هذا الاختلاط والاشتباه ضياع الهدف من بعثته، ألا وهو الاحتجاج به  . القرآن يقول: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾.
. القرآن يقول: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾.
وهذا الفرز.. الرسول كأنما مزدوج الشخصية، له حالتان: حالة يحكي عن السماء، وحالة يحكي عن الجانب الإنساني في شخصيته، هذا الفرز بين ما هو إلهي وما هو إنساني، بين ما هو سماوي وما هو أرضي، هذا الفرز جاء من قِبَل صناديد قريش، هم الذين بدؤوا نظرية الفرز، أول من أسّس نظرية الفرز صناديد قريش. كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب عن النبي كل ما يقول، كل ما يتحدث به النبي يكتبه، فقال له صناديد قريش: ما بالك تكتب عن النبي كل ما يقول؟! إنه بشر يتحدث في الرضا والغضب! لعله كان زعلان، لعل مزاجه كان معكّرًا، لعله كان ناسيًا أو مخطئًا، لماذا تكتب له كل ما يقول؟! فقلتُ ذلك للنبي  ، فقال: ”اكتب كل ما صدر مني، فوالله ما صدر من فيَّ إلا الحق“، أنا لا عندي كلامان: كلام هكذا وكلام كذا، وهذا ما يؤكده القرآن الكريم في إطلاق الآية المباركة: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾.
، فقال: ”اكتب كل ما صدر مني، فوالله ما صدر من فيَّ إلا الحق“، أنا لا عندي كلامان: كلام هكذا وكلام كذا، وهذا ما يؤكده القرآن الكريم في إطلاق الآية المباركة: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾.
إذن، الحكم بالعصمة المطلقة حكمٌ قضى به العقل، ولم تقض به النصوص أو الروايات، ولم تقض به ارتكازات إمامية لا أصل لها، وبما أنَّه قضى به العقل، إذن أي نص يخالف ظاهره ما حكم به العقل، فإنّ حكم العقل قرينة على أن المراد الجدي من هذا النص هو ما ينسجم مع القرينة العقلية، فمثلًا: يأتيك إنسان عاقل، ويتكلم بكلام ظاهره مناف للعقل، يقول لك: والله أنا اليوم ارتفعت إلى السماء، والتقيت بالله «عز وجل»، ثم رجعت إلى الأرض! ظاهر كلامه يتنافى مع العقل، لكنه إنسان عاقلٌ، وملتفتٌ إلى ما يقول، ماذا تصنع؟ أنت كإنسان عربي تسمع كلامًا ظاهره يتنافى مع العقل، ماذا تقرّر؟ من الطبيعي أن تقول: إذن هو يقصد غير ما هو ظاهر كلامه، يقصد: ارتفعت روحي - لا جسمي - عن الأرض، والتقت بالعالم الأقدس - عالم الملكوت - وتشبعت بالأنوار الإلهية والملكوتية، ثم رجعت إلى الأرض وأنا محفوف بهذه الأنوار، ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾.
إذن، أنت إذا سمعت كلامًا يتنافى مع العقل، وهو صادرٌ من عاقلٍ، تعتبر العقل قرينةً على أنَّ المراد بهذا الكلام ما ينسجم مع حكم العقل. لذلك، نحن عندما نقرأ قوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا * لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ﴾، نقول: ذنبك أي ذنب قومك في حقك. علماء الأدب يقولون: المصدر تارة يضاف إلى فاعله، وتارة يضاف إلى مفعوله. مثلًا: أنت ترى شخصًا فتقول: أعجبني ضربك، ما معنى ذلك؟ هل المقصود: أعجبني أنك ضربتَ فلانًا أم أعجبني أنك ضُرِبْتَ من قِبَل فلان؟ كلمة ضرب كلمة مشتركة، لا ندري أنها مضافة للفاعل، أي: الضرب الذي صدر منه، أو مضافة للمفعول، أي: الضرب الذي وقع عليه. لو افترضنا أنَّ هذا الإنسان ضارب ومضروب، وأنت تأتي إليه وتقول له: أعجبني ضربك، يقول لك: ما الذي أعجبك؟ أعجبك أني ضَرَبْتُ أم أني ضُرِبْتُ؟ كلمة ضرب تحتمل المعنيين.
كذلك كلمة الذنب ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ﴾، هل المقصود: الذنب الذي صدر منك، فهو مضاف إلى الفاعل، أم الذنب الذي وقع عليك، فهو مضاف إلى المفعول؟ كلمة ذنب كلمة مشتركة، ككلمة ضرب، ولذلك نحن نقول: بما أن العقل يقول بأن النبي معصوم، فالذنب هنا مصدرٌ مضافٌ إلى المفعول لا إلى الفاعل، أي: الذنب الذي وقع عليك من قِبَل قومك، لا الذنب الذي صدر منك. نحن ما خالفنا.. علماء الأدب هم الذين يقولون: قد يضاف إلى فاعله، وقد يضاف إلى مفعوله.
وكذلك سورة عبس وتولى، فقد ذكرنا في عدة سنوات سابقة أنها لا تنسجم مع خلق النبي الأعظم  ، الذي قال عنه القرآن الكريم: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾، ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾، من كان رؤوفًا رحيمًا فإنه لا يعبس في وجوه المسلمين، ومن كان ذا خلق عظيم فليس من شيمه ولا من صفاته العبوس في وجه المؤمنين، ولذلك نقول بأن عبس وتولى نزلت في غيره، ولم تنزل في شخصه
، الذي قال عنه القرآن الكريم: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾، ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾، من كان رؤوفًا رحيمًا فإنه لا يعبس في وجوه المسلمين، ومن كان ذا خلق عظيم فليس من شيمه ولا من صفاته العبوس في وجه المؤمنين، ولذلك نقول بأن عبس وتولى نزلت في غيره، ولم تنزل في شخصه  .
.
المفارقة الثانية: التلازم بين العصمة والجبر.
الفكر الإمامي يقرّر أن العصمة هي امتناع الذنب نتيجة العلم، العصمة ناشئة عن العلم، متقوّمة بالعلم، فمثلًا: أنا أعلم بأنَّ البول قذرٌ، وأنَّ شرب البول منشأ للأمراض، إذا علمت بأن البول أو المني أو البراز قذر ومنشأ للأمراض، هل أقدم على شربه؟! لا أقدم على شربه، أمتنع عن شربه، إذن شرب البول امتنع مني؛ لعلمي بخطره، ولعلمي بنتائجه السلبية، فأنا معصوم عن شرب البول، ومعصوم عن أكل القذارات.
مثال آخر: أنا أعلم بأن هذا سلك كهربائي مفتوح، إذا وضعت يدي على هذا السلك فإنني سأصاب بلسعة كهربائية قد تودي بحياتي، فهل أقدم على وضعي يدي على السلك الكهربائي؟! لا أقدم. إذن بالنتيجة: أنا معصومٌ عن وضع يدي، أنا معصومٌ عن لمس السلك الكهربائي؛ لعلمي بخطره. إذن العصمة هي امتناع الذنب الناشئ عن العلم.
نفس الشيء، النبي  أو الإمام
أو الإمام  علم بأخطار المعاصي، وعلم بأخطار الذنوب، وعلم بأسرار الطاعات، علمًا يقينيًا، كعلمي بخطر السلك الكهربائي، كما أن علمي بخطر السلك الكهربائي علم حسي يقيني، كذلك النبي
علم بأخطار المعاصي، وعلم بأخطار الذنوب، وعلم بأسرار الطاعات، علمًا يقينيًا، كعلمي بخطر السلك الكهربائي، كما أن علمي بخطر السلك الكهربائي علم حسي يقيني، كذلك النبي  علم بأخطار الذنوب وبأسرار الطاعات علمًا يقينيًا، أوجب ذلك أن يمتنع عن المعاصي والذنوب، وأن يواظب على الطاعات والقربات. هذه هي حقيقة العصمة.
علم بأخطار الذنوب وبأسرار الطاعات علمًا يقينيًا، أوجب ذلك أن يمتنع عن المعاصي والذنوب، وأن يواظب على الطاعات والقربات. هذه هي حقيقة العصمة.
ربما يقول قائل: هذه الحقيقة لا تنسجم مع العقل الفطري؛ لأنَّ معنى ذلك أنه مجبورٌ. إذا كان يعلم علمًا يقينيًا بخطر الذنوب وبأسرار الطاعات، فإنه سيمتنع عنها قهرًا، وإذا كان ممتنعًا عنها قهرًا فهو مجبورٌ على ترك المعصية، ومجبورٌ على فعل الطاعة، ومن كان مجبورًا فلا ثواب له، ولا فضل له على غيره. هذا الإنسان العادي يعيش صراعًا بين النفس والعقل، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين  : ”إن الله خلق الملائكة بعقل دون شهوة، وخلق البهائم بشهوة دون عقل، وركّب في الإنسان عقلًا وشهوة، فمن غلب عقلُه شهوتَه فهو خيرٌ من الملائكة، ومن غلبت شهوتُه عقلَه فهو أدنى من البهائم“.
: ”إن الله خلق الملائكة بعقل دون شهوة، وخلق البهائم بشهوة دون عقل، وركّب في الإنسان عقلًا وشهوة، فمن غلب عقلُه شهوتَه فهو خيرٌ من الملائكة، ومن غلبت شهوتُه عقلَه فهو أدنى من البهائم“.
الإنسان العادي يعيش صراعًا بين النفس والعقل، بين الشهوة والضمير، إلى أن يتغلب في الصراع بجدارة، إلى أن ينجح في عملية الصراع، ويقوم بالطاعة، ويبتعد عن المعصية، ولذلك له ثواب وفضل؛ لأنه قاوم نفسه، ونجح في الصراع. أما الإمام المعصوم فلا يخوض صراعًا، هو يعلم علمًا يقينيًا بخطر المعاصي والذنوب، وإذا كان يعلم بذلك فهذا العلم أوجب أن يمتنع عنها، فلم يخض صراعًا، فأي فضل له على غيره؟! وأي رجحان له على غيره، حتى يكون مستحقًا للثواب؟! إذن، القول بالعصمة في الممارسات الشخصية يصطدم مع العقل الفطري؛ لأنه يوجب بطلان الثواب، وبطلان الفضل في المعصوم  .
.
الجواب عن هذه الفكرة:
يقرّر الفلاسفة أنَّ العلم ليس سببًا لحدوث المعلوم، لماذا؟ الفلاسفة يقولون: الفعل الاختياري مسبوقٌ بعدة مقدمات ومبادئ، فمثلًا: أنت عندما تأتي إلى المسجد، فإنك لستَ مجبورًا، بل هذا عمل اختياري تقوم به باختيارك، هذا العمل حتى يصدر منك باختيارك له مبادئ معينة: المبدأ الأول: أن تتصوّر العمل، تتصوّر أنك ذهبت إلى المسجد.
المبدأ الثاني: أن تصدّق بفائدته، تقول: لماذا أنا ذاهب؟ هذا الخطيب يتحدث كثيرًا ويعكّر مزاجي! لماذا أذهب إلى المسجد؟! تتحدث عن الفائدة والغاية والهدف من ذهابك إلى المسجد، تقول: الغاية هي الثواب وإن أطال الخطيب، وتصدّق بأن هذه الفائدة فائدةٌ راجحةٌ؛ لأنها ثواب جزيل من قِبَل الله «تبارك وتعالى».
المبدأ الثالث: دفع العوائق، هل هناك موانع من ذهابي للمسجد؟ هل سيارتي معطلة؟ هل هناك مانع في الطريق أم ليس هناك مانع؟ أدفع هذه الموانع والعوائق، فإذا تصورت وصدّقت بالفائدة ودفعت بالعوائق، يحصل عندي الشوق والرغبة للذهاب إلى المسجد، إلى أن تصل هذه الرغبة وهذا الشوق إلى حد أن الدماغ يرسل رسالة إلى البدن بأن يتحرك، نتيجة الشوق والرغبة الدماغ يرسل رسالة إلى عضلات البدن وأعضائه بأن تتحرك، فأتحرك وأذهب إلى المسجد.
إذن، الفعل الاختياري لا يصدر منك إلا بعد مقدمات ومبادئ معينة، ولذلك فالعلم مجرد مبدأ من مبادئ العلم الاختياري، وليس سببًا لوقوعك في المعلوم، ليس علةً لوقوعك في الأمر المعلوم، بل هو مجرد عنصرٍ من عناصر الفعل، ومجرد مبدأ من مبادئ الفعل. أنا الآن مثلًا أعلم بأن هذا السلك الكهربائي سلك خطير، هذا مجرد عنصر، هذا العنصر لا يجبرني على تركه، فقد أقول: فلأنتحر لأصبح شهيدًا! مع أنني أعلم بخطره، قد أقدم على العمل، وأعاند علمي، وأواجه علمي، وأقدم على العمل بإرادتي وباختياري.
مثال آخر: هذا موجود في الهند، قد يعلم الإنسان بأن هذا البول قذر، ولكن حتى يتحدث عنه الإعلام - كما شاهدت في التلفاز - وتكتب عنه الصحافة يشرب كأسًا من بول الإنسان الآخر! حتى يتحدث عنه الإعلام، ويقال بأنه إنسان مقدام، ذو رياضة نفسية، يقدم على ما لا يقدم عليه بشر! إذن، مجرد العلم بالخطر، أو مجرد العلم بالضرر، لا يعني أنَّ الإنسان يمتنع عليه أن يفعل الفعل، بل العلم مجرد عنصر، هو أحد عناصر العمل الاختياري، ولكن هناك عناصر أخرى.
أنا أعلم بخطر السلك الكهربائي، وهذا هو العنصر الأول. العنصر الثاني: أن أصدّق وأن أذعن بأن هذا الخطر لا ينفعني، أي: يودي بحياتي، وإذا ذهبت حياتي ذهبت سدى، وأعاقب على ذلك، هذا العنصر الثاني: أن أصدّق بالفائدة. والعنصر الثالث: أن يحصل عندي كراهة، وأن يحصل عندي نفور من هذا الفعل، وأن يصل النفور إلى حد أن أمتنع باختياري وإرادتي عن ممارسة هذا السلوك.
إذن، ليس العلم سببًا للوقوع في العمل، وليس العلم سببًا لترك العمل، وإنما العلم مجرد عنصر من العناصر، والفعل الاختياري والترك الاختياري كلاهما يستند إلى مقدمات ومبادئ، العلم أحدها، فلا ملازمة بين العصمة وبين الجبر، المعصوم يستطيع أن يمارس المعصية، المعصوم يستطيع أن يرتكب الخطأ، ولذلك القرآن يتحدث عن ذلك، يقول: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا﴾ أي أنه يستطيع ويتمكن، ولكنه امتنع عن ذلك باختياره وإرادته، ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾، وقال في آية أخرى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾، وفي آية ثالثة: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ أي: بلّغ ولاية الإمام أمير المؤمنين  ، ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ أي أن جهودك السابقة كلها تذهب هباء منثورًا، لا ثواب ولا أجر لك فيها.
، ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ أي أن جهودك السابقة كلها تذهب هباء منثورًا، لا ثواب ولا أجر لك فيها.
إذن فبالنتيجة: من الممكن عقلًا أن يخطئ النبي أو أن يذنب، ولكنه هو يمتنع عن ذلك بإرادته وباختياره، والعلم أحد العناصر التي اقتضت منه الامتناع عن الذنب وعن المعصية، وكما ذكرنا في الليلة السابقة: أنَّ الإمام أو النبي عنده سيطرة تامة على نفسه، يسيطر عليها حتى من الغفلة، حتى من النسيان، حتى من السهو، حتى من الخطأ، ولا تستغرب من ذلك.
مثلًا: قد تقول لشخص: حضّر محاضرة، فيحضّرها ولكن بمجرد أن يأتي لإلقائها ينسى بعض المعلومات أو يخطئ في بعضها، هذا ليس عنده سيطرة تامة على ذهنه. بينما هناك إنسان آخر عندما يحضّر المحاضرة يحضّرها بدقة، ويلقيها بدقة، لا يغيب عنه شيء، لا يخطئ، لا يقدّم نقطة على نقطة، لا يقدّم قولًا على قول، لا يقدّم كلامًا على آخر، بل يعرض المحاضرة بدقة متناهية، فما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما في القوة الذهنية، الثاني أقوى ذهنًا من الأول، ولذلك سيطرته على نفسه وعلى معلوماته وعلى كلامه تكون أكثر من سيطرة الأول على كلامه.
إذن، المعصوم لا يخطئ، لا ينسى، لا يسهو، هو مسيطر على نفسه سيطرةً تامةً، بحيث لا يتسرب إليه خطأ أو نسيان أو غفلةٌ أو معصيةٌ، نتيجة السيطرة التامة على ذهنه في استقبال المعلومات، وعلى عقله في تحليل المعلومات، وعلى أعصابه وجوارحه في مجال التطبيق، وفي مجال الممارسة، ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾.
عصمة المعصوم منذ الولادة:
وهذه السيطرة منذ الولادة. ربما يستغرب الإنسان ويقول: كيف يكون هذا الإنسان منذ ولادته يمتلك علمًا وإرادةً حتى يسيطر بها على أعصابه وعلى نفسه؟! هذا وليد، فكيف عنده إرادة يسيطر بها على نفسه منذ أول يوم؟! نعم، الفلاسفة يقولون: هناك عقل نظري، وهناك عقل عملي. العقل النظري هو الذي يدرك ما ينبغي أن يُعْلَم، مثلًا: أنا أدرك بعقلي أن الواحد نصف الاثنين، أو أنا أدرك بعقلي أنه إذا بلغت درجة حرارة الماء مئة فإنه يغلي، هذا يسمى عقلًا نظريًا، أمور نظرية يدركها العقل. وهناك عقل عملي، وهو الذي يدرك ما ينبغي أن يُعْمَل. أنا أدرك أن الظلم قبيح، وأن الأمانة شيء جميل، هذا نسميه عقلًا عمليًا، فالعقل العملي هو الذي يدرك الأمور السلوكية وما ينبغي أن يُعْمَل.
متى ما حصل الإنسان على العقل العملي حصل على الإرادة، فهما متلازمان. إذا حصل الإنسان على العقل العملي فإنه يملك إرادة، لا ينفك العقل العملي عن الإرادة. المعصوم منذ ولادته يمتلك عقلًا عمليًا، أي: عقلًا يدرك ما ينبغي أن يُعْمَل، فهو منذ ولادته يمتلك إرادةً وسيطرةً. اقرأ قوله تعالى حديثًا عن النبي عيسى بن مريم «عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام»: ﴿قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا * قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا * وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾، كيف يوصيه بالصلاة والزكاة وهو طفل رضيع؟! الطفل الرضيع لا يصلي ولا يزكي، لكن هذا يختلف عن غيره، هذا أعطي عقلًا عمليًا، إذن هو يمتلك إرادة. هو منذ طفولته، وهو في المهد رضيعًا يمتلك عقلًا عمليًا، وهو في المهد رضيعًا يمتلك إرادة، وهو في المهد رضيعًا يمكن أن يصلي ويمكن ألا يصلي، ولذلك أُمِر بالصلاة والزكاة وهو رضيع في المهد.
إذن، النبي منذ ولادته يمتلك علمًا وعقلًا، إذن يمتلك إرادة، يمتلك عقلًا عمليًا، إذن يمتلك إرادة. إذن، هو يعيش الصراع بين الرذيلة والفضيلة منذ ولادته، هو يعيش الصراع بين الطاعة والمعصية منذ ولادته، وهو منذ ولادته مأمورٌ بالطاعة، ﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا * وَبَرًّا بِوَالِدَتِي﴾، لم أُؤمَر على هذه الأمور وأنا رضيع إلا لأنني قادر على فعلها وتركها، ولو لم أكن قادرًا على ذلك لما أُمِرْت بها وأنا رضيع. إذن، هو يمتلك العلم والعقل العملي والإرادة والسيطرة منذ ولادته.
الرازي في تفسيره ينقل عن النبي محمد  : ”كنتُ نبيًا وآدم بين الماء والطين“، ”لم يزل الله ينقلني من أصلاب الطاهرين وأرحام المطهرات، إلى أن أخرجني إلى عالمكم هذا، لم يدنسني دنس الجاهلية“، الذي كان نبيًا قبل ولادته، الذي كان طاهرًا قبل ولادته، معناه أنه منذ ولادته عالمٌ مريدٌ قادرٌ على الطاعة وعلى ترك الطاعة.
: ”كنتُ نبيًا وآدم بين الماء والطين“، ”لم يزل الله ينقلني من أصلاب الطاهرين وأرحام المطهرات، إلى أن أخرجني إلى عالمكم هذا، لم يدنسني دنس الجاهلية“، الذي كان نبيًا قبل ولادته، الذي كان طاهرًا قبل ولادته، معناه أنه منذ ولادته عالمٌ مريدٌ قادرٌ على الطاعة وعلى ترك الطاعة.
إذن فبالنتيجة: معتقد الإمامية بالعصمة المطلقة أمرٌ قرّره العقل، وتأويلهم للنصوص التي تتنافى مع العصمة ليس من باب التأويل، بل من باب استخدام العقل قرينةً على تحديد المراد الجدّي من النصوص، والعقل من القرائن التي تتحكّم في ظواهر الكلمات، وتصرفها إلى ما ينسجم مع حكم العقل، كما ذكرنا وكما شرحنا.
لذلك، دائمًا أفعالهم «صلوات الله وسلامه عليهم» على ضوء ما يأمر به الله «تبارك وتعالى»، لا يتخلفون عن أمره، ولو كان هذا الفعل مستنكرًا لدى الناس، حتى لو كان الفعل الناس تستنكره، إذا الله أمر به فإنهم يسيرون على ما أمر به الله تعالى، لا على ما يستقبحه الناس أو ما يستذوقونه. ولذلك، عندما خوطب الحسين  ، قالوا: علام خروجك، وأنت تعلم بأن الكوفة قد غدروا بأبيك وبأخيك من قبل، فلماذا تقدم عليهم؟ قال: ”لقد أمرني رسول الله بأمرٍ، وأنا ماضٍ فيه. لقد رأيتُ جدّي رسول الله
، قالوا: علام خروجك، وأنت تعلم بأن الكوفة قد غدروا بأبيك وبأخيك من قبل، فلماذا تقدم عليهم؟ قال: ”لقد أمرني رسول الله بأمرٍ، وأنا ماضٍ فيه. لقد رأيتُ جدّي رسول الله  وهو يقول: بني حسين، إنَّ لك لدرجةً في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة“.
وهو يقول: بني حسين، إنَّ لك لدرجةً في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة“.