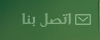مقارنة بين الفكر الديني والفكر الليبرالي
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾
صدق الله العلي العظيم
سؤال حول المحاضرة السابقة:
[...] مع أنكم ترون أن الدعوة للإسلام من أهم الواجبات ومن أعظم القربات؟ الجواب عن هذا السؤال:
وكذلك بعض الدول الأوروربية التي تراجع نفسها الآن، وتضع بعض القوانين التي تقيّد حركة الدعوة إلى الإسلام، وتقيّد حركة نشر الإسلام في تلك المناطق. إذن، المجتمعات الأخرى تعيش نفس الهاجس الذي يعيشه المجتمع الإسلامي، وهو أن نشر الدعوة إلى الإسلام في تلك المجتمعات يهدّد الترابط الاجتماعي، يهدّد الترابط الديمغرافي في تلك الدول، ولنفس هذه العلة ولنفس هذا السبب منع الإسلام إعلان الارتداد في وسط المجتمع الإسلامي؛ لأنّه يهدّد الهوية الاجتماعية لهذا المجتمع، ولهذه الحضارة، بنفس هذا الوجه، ولنفس هذه النكتة.
ثانيًا: نحن إنما نفتح المجال للدعوة إلى الإسلام في المجتمعات الأخرى بالمقدار المسموح به، لا أكثر من ذلك، وهذا ما يسمّى عندنا بقاعدة الإلزام. المجتمعات المسيحية لأنها هي تأذن وتسمح بإعلان الإسلام ونشره فيها بمقدار معين، فمعنى ذلك أنها لا ترى أن نشر الإسلام بهذا المقدار المسموح يزلزل كيانها الاجتماعي، أو يؤثر على ترابطها الاجتماعي، وبما أنها لا ترى ذلك، لذلك نحن نسمح بالدعوة إلى الإسلام في هذه المجتمعات؛ باعتبار أن هذه المجتمعات لا ترى أن إعلان الإسلام يؤثر على تماسكها وعلى هويتها الإسلامية العامة.
أما في مجتمعنا الإسلامي، فإن إعلان الارتداد يجرّ إلى إعلان ضرب المقدّسات والرموز، ويجر إلى إعلان التجاهر بالفواحش والمعاصي المعروفة في المجتمع الإسلامي، وبالتالي فهو يؤثر على الهوية الدينية لهذا المجتمع، وعلى الترابط الديمغرافي في هذا المجتمع، ولذلك يكون إعلان الارتداد عندنا ممنوعًا وموضوعًا لآثار وخيمة معروفة لدى المسلمين. هذا ما يتعلق بالسؤال عن المحاضرة السابقة.
ما زال حديثنا في المقارنة بين الفكر الليبرالي والفكر الديني. الفكر الليبرالي يؤكّد أنَّ الفارق بين الليبرالية والدين هو الفارق بين النظرة المثالية والنظرة الواقعية. الفكر الديني يركّز على النظرة المثالية، بينما الفكر الليبرالي يركّز على النظرة الواقعية. الفكر الديني يرى أنَّ إنسانية الإنسان بالسمو الروحي، وبالكمال الروحي، فالإنسان هو الذي يستطيع أن يسيطر على نفسه، وهو الذي يستطيع أن يسيطر على غرائزه، وهو الذي يستطيع أن يسيطر على شهواته، فالإنسان هو الذي يعيش حالةً من الارتفاع عن الشهوات وعن الغرائز وعن الميول، وهو الذي يستطيع أن يحدّد حركة الشهوات وحركة الميول وحركة الغرائز، فيمنع النفس عن اللهث وراء الدنيا، وهذا ما يسمّى بفضيلة الزهد، أو يمنع الناس من الجري وراء الشهوة، وهذا ما يسمّى بفضيلة العفة، فالإنسان هو من يعيش حالةً من الارتفاع الروحي بفضيلة الزهد وبفضيلة العفة، هذه هي النظرية الدينية.
أما الفكر الليبرالي فيقول: لماذا كل هذا التعقيد؟! لماذا لا تنظرون للإنسان نظرة واقعية؟! الإنسان خُلِق وهو يمتلك غرائزَ وشهواتٍ وميولًا، وبما أنه خُلِق وهو يمتلك الغرائز والشهوات والميول، إذن فمقتضى النظرة الواقعية للإنسان أن نجعل هذا الإنسان يتصرف بواقعه، يتصرف كما خُلِق، فيشبع شهواتِه وغرائزَه وميولَه بأي كيفية يريد، من دون تجميد ولا إلغاء ولا قيود، النظرة الواقعية أن نترك الإنسان كما خُلِق، وأما أن نطلب من الإنسان أن يسحق غرائزه، وأن يسحق ميوله، بدعوى وحجة أن يحصل على فضيلة الكمال الروحي، وأن يحصل على فضيلة السمو الروحي، فهذه نظرة مثالية معقدة. فلننظر للإنسان نظرة واقعية: هذا الإنسان مجموعة شهوات، فليشبع شهواتِه، وليشبع غرائزَه وميولَه بالحرية التي أُعْطِيَت له.
إذن، ليس في ساحة الفكر الليبرالي فضيلةٌ اسمها الزهد، وليس في ساحة الفكر الليبرالي فضيلةٌ اسمها العفة، بل ليس في ساحة الفكر الليبرالي فضيلة إلا ألا تعتدي على غيرك، الفضيلة هي ألا تعتدي على غيرك، وأما أن تتسم بفضيلة الزهد أو فضيلة العفة فهذه ليست فضائل، بل هذه مجرد أوهام وأنظار مثالية. النظرة الواقعية للإنسان هي أن الإنسان حرٌ في إشباع شهواته وغرائزه وميوله، وبناءً على هذا تتفرع عدة أصول تعرضنا لها ليلة السابقة، وأتعرض لها في هذه الليلة من أجل وضع النقاط على الحروف.
الأصل الأول: ليس هناك إنسان معصوم.
جميع أبناء البشر متساوون في العناصر البشرية، كل فرد من أبناء البشر يملك عقلًا وغريزةً وشهوةً، وبما أن جميع أبناء البشر متساوون في العناصر البشرية، فمن أين جاءت العصمة؟! كيف يتميز بعضهم على البعض الآخر بالعصمة مع أنهم متساوون في العناصر البشرية؟! هذا هو الأصل الأول، ونحن نسلّط الضوء على هذا الأصل من خلال ذكر أمرين:
الأمر الأول: ما هو الهدف من وجود الإنسان على هذه الأرض؟
هل الهدف هو الهدف الواقعي الذي يطرحه الفكر الليبرالي، وهو أن الإنسان يوجد على الأرض، ويعمل في سبيل بناء حياته، ويشبع شهواتِه وغرائزَه بالطريقة التي يهواها، وبالطريقة التي يرتاح إليها؟ هل هذا هو الهدف المسمى بالهدف الواقعي، أم أن هناك هدفًا أكبر من ذلك؟ لو كان الهدف من وجود الإنسان هو ما يسمى بالهدف الواقعي، وهو أن الإنسان يشبع ميوله، ويبني حياته الفردية والاجتماعية بالطريقة التي يريدها، لو كان هذا هو الهدف لكان وجود الإنسان ظلمًا له، هذا الوجود يعتبر ظلمًا، من حق الإنسان يعترض على خالقه، يقول له: أنت خلقتني من أجل أن أشبع شهواتي وميولي وغرائزي وأبني حياتي الفردية والاجتماعية فقط؟! إذا كنت قد خلقتني لأجل هذا فقد ظلمتني؛ لأنَّ هذه الحياة مليئة بالآلام، ومليئة بالظروف القاسية، ومليئة بالمعاناة، ومليئة بالأوجاع، واللذة التي أحصل عليها نتيجة إشباع ميولي، ونتيجة حصولي على الثروة، ونتيجة حصولي على المنصب، اللذة التي أحصل عليها لا تعادل الآلام التي أتجرعها وأتحملها في إطار هذه الحياة.
لو كنتَ خلقتني فقط لأجل أن أحصل على اللذة - لذة إشباع الميول، لذة الثروة، لذة الحياة - فإن هذه اللذة لا تعادل الآلام القاسية التي أتحملها في مضمار هذه الحياة، فإذن وجودي ظلم، وأنت ظلمتني؛ لأنك عرّضتني لألم لا تعادله اللذة التي أحصل عليها. هذا الظلم لا يرتفع ولا يندفع إلا بأن يكون الهدف من وجودي غير ذلك، الهدف من وجودي أن أكون معصومًا، العصمة هي الهدف من وجود الإنسان.
بعبارة أخرى: الهدف من وجود الإنسان أن يرتفع عن الأرض، أن يرتفع عن النفس، أن يرتفع عن الشهوات والغرائز، الهدف من وجود الإنسان أن ينصهر بالقيم الإنسانية، بالصدق، بالعدل، بالأمانة، بالإخلاص، أن ينصهر بهذه القيم، والانصهار بهذه القيم هو العصمة، ما معنى العصمة؟! بعض علمائنا يقول: العصمة هي الصدق، ليست شيئًا آخر، الصدق هو العصمة، الصدق في مواطن ثلاثة: الصدق في القول، والصدق في السلوك، والصدق في الشخصية، بأن يكون ظاهرك موافقًا لباطنك، من كان صادقًا في هذه المواطن الثلاثة في القول، في السلوك، في الشخصية، فهو إنسان معصوم. ولذلك، ترى القرآن الكريم أشار إلى المعصومين بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾، الصادق معصوم.
إذن، الهدف من وجودنا في الحياة هو العصمة، أن نكون معصومين، أي: أن نكون منصهرين بالقيم الإنسانية، أن نكون منصهرين بالقيم المعنوية، وهذا ما يعبّر عنه بالكمال، بالسمو، بالارتفاع عن النفس وشهواتها، وهذا هو العصمة، فالهدف من وجود الإنسان هو العصمة، ولأن هذه العصمة تعبّد لك الطريق للعالم الآخر، من كان معصومًا في هذه الدنيا، من كان صادقًا في هذه الدنيا، فُرِشَت له الأنوار في العالم الآخر، إذن فبالنتيجة: وجودي ليس ظلمًا لي، وُجدت وتحمّلت الآلام وتحمّلت الظروف القاسية، وجعلت من نفسي معصومًا، لكي أعبّد الطريق أمامي للدار الثانية، للعالم الآخر، فوجودي ليس ظلمًا لي، لأن هذا الوجود سيمتد بأنواره وبظلاله في العالم الآخر. هذا هو الأمر الأول: تحديد الهدف.
الأمر الثاني: هل يمكن أن يكون الإنسان معصومًا؟
بعد أن عرفنا أن الهدف من وجود الإنسان أن يكون معصومًا، فهل يمتلك الإنسان القدرة والطاقة لأن يصبح معصومًا أو لا يمتلك؟ الهدف أن يكون كاملًا، أن يكون معصومًا، لكن هل الإنسان يمتلك الطاقة والقدرة على أن يكون معصومًا أم لا؟ ربما يقول أخي الليبرالي بأنه لا يمكن للإنسان أن يتجرّد من شهواته وغرائزه وميوله، ويصبح إنسانًا معصومًا، هذا يعني أنه يتجرد من إنسانيته، لا يمكن لإنسان أن يسمو فوق الشهوات كلها، ويصبح إنسانًا معصومًا، هذا يعني أنه ليس إنسانًا، هذا أمر غير ممكن.
إذا قال: غير ممكن، فهذا مصادمٌ مع الوجدان تمامًا، فمثلًا: انظر إلى هذا الجندي الذي يستشهد في سبيل الدفاع عن وطنه، أو في سبيل الدفاع عن حضارته، هذا الجندي الذي يخوض المعركة محاربًا للإرهاب، هذا الجندي الذي يخوض المعركة وهو يعلم أنه سيُقْتَل في هذه المعركة، هذا الجندي عندما يخوض المعركة وهو عالم بقتله وبفناء حياته، ماذا يصنع؟ هذا الجندي يضحّي بأكبر لذة عرفها الإنسان - وهي لذة الحياة، لذة الوجود - في سبيل الكمال النفسي، في سبيل أن يحصل على درجة من السمو والكامل النفسي، وهي أنه ارتفع عن النفس، ارتفع عن الجسم، ارتفع عن الأرض، ارتفع عن الشهوات والميول. في سبيل أن يحصل على هذه الدرجة من السمو، يضحي بأكبر لذة للإنسان، وهي لذة الحياة.
إذا كان الإنسان قادرًا على أن يضحّي بأكبر لذة - وهي لذة الحياة - ألا يستطيع أن يضحّي بلذة أقل منها، كلذة الجنس، ولذة الشهوة، ولذة المنصب، ولذة الدنيا، ولذة الجاه؟! من الطبيعي أنه يستطيع فعل ذلك. ألا يستطيع هذا الإنسان أن يضحّي بلذة المنصب وبلذة الثروة فيصبح زاهدًا؟! ألا يستطيع هذا الإنسان أن يضحّي بلذة الجنس بالطريق غير المشروع فيصبح عفيفًا؟! إذا كان قادرًا على أن يضحّي باللذة الأكبر - وهي لذة الحياة - هان عليه أن يضحّي باللذة الأقل، واللذة الأخف.
إذن، الإنسان يمتلك طاقةً على أن يرتفع عن الأرض، يمتلك طاقة على أن يسمو على نفسه، وعلى أن يكتمل فوق نفسه، ويضحي بأعظم اللذائذ، وهذا ما يسمى بالسمو الروحي، وما يسمى بالكمال الروحي، وهذا هو درجة من درجات العصمة، وهذه هي رتبة من رتب العصمة، العصمة أن تضحي بهذه اللذات في سبيل ذلك الكمال الروحي. إذن، من الممكن أن يصبح الإنسان معصومًا، من الممكن أن يضحي باللذات في سبيل الكمال الروحي، فإذا كان هذا من الممكن، فلماذا نستغرب على محمد وآل محمد أنهم أناس معصومون؟! انصهروا بالمبادئ، انصهروا بالقيم، ضحوا باللذات، وصلوا إلى درجة عالية من الارتفاع عن الأرض، ومن الارتفاع عن الشهوات وعن الميول وعن الغرائز، كما ورد عن أمير المؤمنين  : ”وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى“.
: ”وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى“.
الأصل الثاني: ليس هناك مقدّس على الإطلاق.
لا يوجد عندنا شيء مقدس، لا كتاب مقدس، ولا إنسان مقدس، ولا فكر مقدس، لا يوجد عندنا شيء مقدس، متى ما آمنت بأن هناك شيئًا مقدسًا خرجت من عالم التحليل إلى عالم الخضوع والتجليل، قيّدت عقلك بألا يفكر، بألا ينقد، بألا يحلّل، لأنك أمامك شيء مقدس، فلا مجال لعقلك أن ينقد أو يحلل أو يفكر.
هذا الأصل يرجع في الواقع إلى بحث علمي، وهو مصادر المعرفة، هل مصدر المعرفة واحد أم متعدد؟ هذا يرجع إلى هذا البحث، لماذا؟ لأننا عندما نقول: لا يوجد مقدس، بل كل شيء قابل للنقد والتحليل، فمصدر المعرفة مصدر واحد، وهو العقل، لا يوجد عندنا مصدر آخر، معنى لا يوجد مقدس أنه لا يوجد مصدر آخر للمعرفة، المصدر الوحيد للمعرفة هو العقل، ولذلك من حق العقل أن ينقد وأن يحلل أي شيء؛ لأنه هو المصدر الأول والأخير، مصدر المعرفة هو العقل.
متى ما آمنت بوجود مقدس، صار هناك مصدران للمعرفة: المصدر الأول هو العقل، والمصدر الثاني هو ذلك المقدس. عندما تقول: القرآن كتاب مقدس، فمعنى ذلك أن مصدر المعرفة شيئان: العقل والقرآن. معنى المقدس هو هذا، الليبراليون عندما يقولون: مقدس، فلا يقصدون ما يُقَبَّل مثلًا! لا علاقة لهم بهذه القضايا، وإنما مقصودهم بالمقدّس: المصدر الذي يتعبّد به من دون نقاش، هذا معنى المقدس، عندما تقول: القرآن مقدس، فمعنى ذلك: كلام القرآن يؤخذ به تعبدًا بدون مناقشة.
إذن، عندما نقول: لا مقدس، فمعنى ذلك أن مصدر المعرفة واحد، وهو العقل. عندما نقول: هناك مقدس، فمعنى ذلك أن مصدر المعرفة متعدد: العقل ومصدر آخر للمعرفة. إذن، المقارنة بين الفكر الليبرالي والفكر الديني في وجود المقدس وعدم وجوده ترجع إلى بحث تعدّد المصدر ووحدة المصدر للمعرفة، ولذلك نحن نقول: مصدر المعرفة متعدد، وليس مصدرًا واحدًا. مصدر المعرفة: إما العقل، وإما المُخْبِر الذي يُقْبَل قولُه.
مثلًا: أنا عندما أزور الطبيب، وأجلس بين يديه، وأذكر له الأعراض التي أشعر بها، أقول: عندي أعراض معينة أشعر بها في جسمي، الطبيب من خلال دراسة هذه الأعراض، ومن خلال القيام ببعض الوظائف المختبرية، يتوصل إلى نتيجة، يقول بأن جسمي يحمل المرض الفلاني، هذا كلام طبيب هل يقبل التحليل والنقد أم يؤخذ به؟ الطبيب يقول لك: أنت الآن جسمك يعيش المرض الكذائي، جسمك يعيش المرض الفلاني، فهل كلام الطبيب يؤخذ به، أم أن كلام الطبيب خاضع للنقد والتحليل بحسب عقلك؟!
من الطبيعي أن كلام الطبيب يؤخذ به، هو يتحدث في مجال اختصاصه، فبما أنه مختص، ويتحدث عن مجال اختصاصه، إذن إخباره يؤخذ به من دون مناقشة ولا تحليل. إذن، صار مصدر المعرفة متعددًا، هناك مصدر وهو العقل، وهناك مصدر آخر وهو المخبِر الذي يؤخذ بقوله، لأنه صاحب اختصاص في مجاله، فيؤخذ بقوله في مجال اختصاصه.
مثال آخر: ما هو الفرق بين خواطرك وخواطري؟ أنا الآن جالس وأفكر، خواطري أنا أعلم بها، ولكن خواطرك لا أعلم بها، كيف أتوصل إلى خواطرك؟ من أين أستطيع أن أعرف خواطرك التي تجول في ذهنك؟ من أين أتوصل إلى معرفة ما يدور في خلدك؟ لعل شخصًا جالسًا هناك في المأتم أمامي وهو يفكر في شيء آخر مثلًا، يفكر في حبيبته، وفي أسهمه في البنك، وفي القضايا الأخرى. أنا أعرف خواطري، ولكن كيف أعرف خواطرك؟!
ليس هناك مجال، العقل لا يستطيع أن يكتشف خواطرك، لو اعتمدت على العقل كمصدر للمعرفة فإن العقل لا يستطيع أن يكتشف ما هي خواطرك، ما هو الذهن الذي يجول في ذهنك، لا يمكن لي أن أكتشف ما يخطر في ذهنك إلا عن طريق إخبارك أنت، فإذا أخبرت وكنتَ ثقةً قبلتُ كلامَك من دون مناقشة ولا تحليل ولا نقد. إذن، مصدر المعرفة متعدد.
من هنا نقول: النبي مقدس، القرآن مقدس، ما معنى مقدس؟ يعني: هذا مصدرٌ للمعرفة كما أن العقل مصدرٌ آخر، هناك معلومات لا أستطيع أنا معرفتها من غير طريق الوحي، كعالم القبر، وعالم البرزخ، وعالم الحساب، وعالم القيامة، وعالم ما وراء الموت، من أين أستطيع التعرف على هذه العوالم بالعقل؟! العقل لا يمكنه أن يكتشف هذه العوالم، إذن أنا أحتاج إلى مصدر آخر، المصدر الآخر هو الوحي المتمثل في القرآن أو في لسان النبي  ، ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾، إذن القرآن مقدس، النبي مقدس، أي أن النبي والقرآن مخبرٌ يُقْبَل خبره؛ لأنه مختصٌ بهذا المجال، مختصٌ بالمعلومات الغيبية، والمختص يُقْبَل خبرُه في مجال اختصاصه، هذا معنى المقدّس. إذن، الفرق بين الاعتراف بالمقدس وعدم الاعتراف به هو الفرق في أن مصدر المعرفة متعدد أم أن مصدر المعرفة واحد.
، ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾، إذن القرآن مقدس، النبي مقدس، أي أن النبي والقرآن مخبرٌ يُقْبَل خبره؛ لأنه مختصٌ بهذا المجال، مختصٌ بالمعلومات الغيبية، والمختص يُقْبَل خبرُه في مجال اختصاصه، هذا معنى المقدّس. إذن، الفرق بين الاعتراف بالمقدس وعدم الاعتراف به هو الفرق في أن مصدر المعرفة متعدد أم أن مصدر المعرفة واحد.
الأصل الثالث: ارتباط قيمة الأشياء بالتجربة.
من الأصول التي تعرّض لها المفكّر الليبرالي هي أن قيمة الأشياء إنما تُعْرَف بالتجربة، نحن لا نستطيع أن نكتشف قيمة الأشياء من عقولنا، نجلس بالبيت، ونغلق باب الغرف علينا، ونقول: بعقولنا نكتشف قيم الأشياء، هذا صواب وذاك خطأ، هذا حسن وذاك قبيح! لا يمكن اكتشاف قيم الأشياء إلا من خلال التجربة، كل ما لم يخضع للتجربة فلا يمكن اكتشاف قيمته، اكتشاف القيمة منوطٌ بإقامة التجربة.
نحن أيضًا كفكر ديني نقول: لا. نحن نقول بأنَّ الميزان في تقويم الأشياء ثلاثة: ميزان عقلي، وميزان تجريبي، وميزان أخلاقي، والسر في ثلاثية الموازين هو أن المعلومات على أقسام ثلاثة: قسم من المعلومات معلومات عقلية، وقسم من المعلومات معلومات مادية، وقسم من المعلومات معلومات سلوكية، ولكل قسم من المعلومات ميزانٌ تقوَّم به هذه المعلومات.
مثلًا: المعلومات العقلية كنسبية الحقيقة وإطلاقها، الفكر الليبرالي يقول: الحقيقة نسبية، بينما الفكر الديني يقول: الحقيقة مطلقة وليست نسبية، هذه الفكرة من المعلومات العقلية، هذا لا يمكن اكتشافها بالتجربة، ما هو ربطها بالتجربة؟! ما هي علاقتها بالتجربة؟! تحليل هذه الفكرة - وهي أن الحقيقة مطلقة أو نسبية - فكرةٌ لا يمكن تقويمها إلا بالميزان العقلي، إلا بالعقل، ولا يمكن تقويمها بالتجربة، لا علاقة لها بالتجربة.
القسم الثاني من المعلومات: المعلومات المادية، مثل: هل يمكن أن يطير الإنسان في الفضاء بلا وسيلة؟ لا تستطيع أن تعرف هل هذا ممكن أو لا - أي: أن تحدّد أن للأرض جاذبية أو ليست لها جاذبية - إلا بالتجربة، هذه معلومات مادية، لا يمكن تحديدها إلا عن طريق التجربة. متى يغلي الماء؟ في أي درجة حرارة يغلي الماء؟ هل تستطيع أن تكتشف هذا بالعقل؟! لا، لا يمكن أن تكتشفه إلا عن طريق التجربة، عن طريق التجربة تكتشف أنَّ الماء إذا بلغت درجة حرارته مئة فإنه يغلي، فهذه قضايا مادية لا يمكن اكتشافها إلا بالتجربة.
القسم الثالث من المعلومات معلومات سلوكية، كالحسن والقبح. هل الحرية الجنسية أمر حسن أم أمر قبيح؟ هل الشذوذ الجنسي أمر حسن أم أمر قبيح؟ يقول لك: هذا اعرضه على التجربة وبعد ذلك تكتشف أنه حسن أو قبيح بعد أن ترى سلبياته وإيجابياته! لا، ليست المسألة مسألة تجربة؛ لأنَّ جمال الأفعال وقبحها يرجع إلى التقويم الفطري والوجداني.
مثلًا: هذا الإنسان يفتح التلفاز، فيقول قائل: فجّر انتحاري نفسه، وقتل مئة وخمسة وعشرين شخصًا، بدون ذنب ولا جرم، بمجرد أن يسمع الإنسان أو يشاهد في التلفزيون هذا النوع من المجازر الرهيبة، إنسان يقتل مئة وخمسة وعشرين شخصًا بدون ذنب ولا جرم، هل يلتذ أو ينقبض؟! نحن نتحدث عن الإنسان الطبيعي، الإنسان الطبيعي عندما يشاهد هذه المجزرة فهل يلتذ أو ينقبض؟! من الطبيعي أن ينقبض، وبما أنه ينقبض فمعنى ذلك أنَّ هذا العمل قبيحٌ، لا داعي للتجربة، أمر تنقبض منه النفس، أمر تشمئز منه النفس، النفس الإنسانية بما هي نفس إنسانية.
لو وقف شخص في الشارع، وأخذ طفلًا، وذبحه بلا ذنب ولا جرم، فإن النفس الإنسانية تشمئز وتنقبض من ذلك، ولو سئلت النفس: لماذا تشمئز ولماذا تنقبض من هذا العمل؟ تجيب بأنَّ هذا العمل يتنافى مع فطرة الإنسان، ومع طبيعة الإنسان بما هو إنسان. بينما تأتي إلى شخص آخر: شخص يدخل إلى مجتمع فقير، ويبذل ثروته في إنعاش هذا المجتمع الفقير، يبني مدارسَ ومستشفياتٍ ومرافقَ وخدماتٍ، يبذل ثروته في إنعاش المجتمع الفقير، النفس تلتذ بهذا العمل لا أنها تنقبض منه، والتذاذ النفس بهذا العمل يعني أنَّ هذا العمل جميلٌ، ولو سئلت النفس: ما هو سر انجذابها؟ لأجابت بأن هذا منسجم مع الفطرة والطبيعة البشرية.
إذن، المقياس في جمال الأشياء وقبحها هو التذاذ النفس البشرية وانقباضها، وليس الميزان إقامة التجربة واكتشاف السلبيات والإيجابيات بعد ذلك. النفس الإنسانية بما هي لو عُرِضَ عليها الشذوذ الجنسي، فإنها تشمئز وتنفر، ترى أن هذا لا يليق بطبيعتها، لا يليق بفطرتها، وما تشمئز منه النفس فهو عملٌ قبيحٌ، وما تلتذ به النفس - لأنه ينسجم مع صفائها ونقائها - فهو عمل جميل، فالميزان ليس هو التجربة في القضايا السلوكية، بل الميزان هو التقويم الوجداني والفطري.
الأصل الرابع: مساحة الحقوق والوظائف.
الفكر الليبرالي يقول بأنَّ الفكر الديني مشحونٌ بالوظائف، وقليلٌ في الحقوق، فعندما تقرأ القرآن مثلًا تراه مليئًا بالوظائف، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾، ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، كله وظائف ووظائف ووظائف، فالفكر الديني يركّز على الوظائف التي تقيّد حرية الإنسان، وتضيّق المساحة التي يتحرك فيها الإنسان، بينما الفكر الليبرالي يركّز على الامتيازات والحقوق، ما هو حقي أنا؟ حقوقي ما هي؟ امتيازتي ما هي؟ حق الحياة، حق التعليم، حق التأمين الصحي، حق التصويت، حق الحرية، حق الحكم، حق، حق، حق... إلخ، فالفكر الليبرالي يركّز على الحقوق والامتيازات، بينما الفكر الديني يركّز على الوظائف التي تضيّق المساحة التي يتحرّك فيها الإنسان.
نحن نسلّط الضوء على هذا الأصل:
أولًا: هناك شبه مغالطة؛ لأنه لا يوجد حقٌ بدون وظيفة، الحق ممزوج دائمًا بالوظيفة، ولهذا بعض فقهائنا - كالسيد الخوئي «قدس سره» - أنكر الحق، وقال: لا يوجد شيء اسمه حق، كلها أحكام؛ لأنه لا يتصوّر حقٌ إلا وهو مستبطنٌ في داخله لتكليف ووظيفة، متى ما تصورنا حقًا رأينا في داخله تكليفًا ووظيفةً، فلا يوجد شيء اسمه حق، بل هذه كلها أحكام، فلا يوجد شيء اسمه حق بدون وظيفة.
مثلًا: أنا من حقي الحياة، أي: يحرم عليك أن تقتلني، فهو حقٌ بالنسبة لإنسان، لكنه وظيفةٌ وتكليفٌ بالنسبة لإنسان آخر. أنا مثلًا من حقي التعليم، من حقي التأمين الصحي، أي: يجب على الدولة أن توفر لي مرافق التعليم والصحة، فصار الحق من جهتي وظيفةً من جهة الدولة، لا يوجد حقٌ إلا ومعه وظيفةٌ، لا يوجد حقٌ إلا ومع تكليفٌ. إذن، إذا كان لي مئة حق بحسب الفكر الليبرالي، فعليك مئة وظيفة، وإذا كان لك أنت مئة حق، فأنا عليَّ مئة وظيفة ومئة تكليف، لا يوجد حقٌ إلا ومعه وظيفةٌ وتكليفٌ.
إذن، القرآن الكريم المملوء بالوظائف هو مملوء بالحقوق؛ لأنَّ هذه الوظائف تعني حقوقًا بالنسبة للآخرين، فعندما يقول مثلًا: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾، فهذا يعني: يحرم عليك أكل المال بالباطل، وهذا وظيفة، فإذن من حق الذي يتعامل معك أن يصل إليه المال عن طريق قانوني، فهو وظيفةٌ عليك وهو حقٌ للإنسان الآخر.
ثانيًا: هذا استقراء ناقص، أنت إذا تستقرئ القرآن تجد الحقوق فيه أكثر من الوظائف، الحقوق والامتيازات فيه أكثر من التكاليف، ونفس الحقوق التي يطرحها الفكر الليبرالي يطرحها القرآن، ويطرحها الإسلام، ففي حق الحياة مثلًا يقول: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾، ويعبّر عن حق الشخصية بحق الكرامة: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾، وقال عن حق الحرية في التنقل: ﴿وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾، وعبّر عن حق امتلاك الثروة بقوله: ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾، مما يعني أن الحقوق موجودة في القرآن، كذلك أيضًا حق العلم مثلًا، كما قال تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾.
إذن، مساحة الحقوق أكبر من مساحة الوظائف والتكاليف في القرآن الكريم، فمثلًا: القرآن عندما يتعرض إلى الممنوعات يقول: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾، أنا لا أجد غير هذه الأشياء، وما سواها مباحٌ. إذن، صارت مساحة الحق أكثر من مساحة الوظيفة، مساحة الوظيفة محدودة معدودة ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾، وما سواه فهو حقٌ. ولذلك، بعض علمائنا استدل على أصالة الحل، بمعنى أن الأصل فيما على الأرض من نبات أو حيوان هو الحل، إلا أن يمنع منه الشارع، استدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾.
إذن بالنتيجة: مساحة الامتيازات والمباحات والحقوق أكبر من مساحة الوظائف والتكاليف، ومن أعظم هذه الحقوق التي نصَّ عليها القرآن: حق الحياة ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾، ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾. حق الحياة قد يكون حقًا خاصًا، كحقي أنا في الحياة، وقد يكون حقًا عامًا، كحق المجتمع، فكما أن من حق الفرد الحياة، من حق المجتمع أيضًا الحياة، وحياة المجتمع هي بأن يحصل على معيشة كريمة، ومعيشة عزيزة.
ولذلك، ترى أبطال الإسلام يضحون بحياة الفرد في سبيل حياة المجتمع، بطل الإسلام يضحي بحقه في الحياة في سبيل حق المجتمع في الحياة، ”إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمًا“، ”ما خرجت أشرًا ولا بطرًا ولا مفسدًا ولا ظالمًا، وإنما خرجتُ لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر“، ضحى بحقه في الحياة في سبيل حق المجتمع.