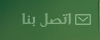أبعاد نظرية وحدة الوجود
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾
صدق الله العلي العظيم
استمرارًا للكلام حول الآية المباركة نتحدث في محورين:
المحور الأول: معنى مصطلح وحدة الوجود.
ذكرنا في الليلة السابقة ما هو وجه الربط بين إرادة المخلوق وإرادة الخالق، فإن الآية المباركة حيث تقول: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ تفرض ارتباطًا وثيقًا بين الإرادتين: إرادة الخالق وإرادة المخلوق، فما هو وجه هذا الربط؟ وما هو وجه العلاقة بين فعل المخلوق وفعل الخالق؟ وذكرنا في الليلة السابقة أن من النظريات التي طُرِحَت انطلاقًا من الآية المباركة في تحديد الربط بين فعل المخلوق وفعل الخالق هي نظرية وحدة الوجود التي يطرحها العرفاء، ولأن هذه النظرية غامضة ومبهمة كان لا بد أن نخصّص وقتًا لبيان حدود هذه النظرية وأبعادها. عندما يقال لدى العرفاء أو علم العرفان مصطلح وحدة الوجود، فما هو المقصود بوحدة الوجود؟ هذا المصطلح طُرِحَت له عدة معانٍ، بعضها مقبولٌ، وبعضها مرفوض.
المعنى الأول: وحدة حقيقة الوجود.
الوجود معناه هو الثبات والتشخّص والتحقّق، التحقّق هو الوجود، والتشخّص هو الوجود، فيقال بأنَّ جميع الموجودات متحدةٌ في حقيقة الوجود، نظير الاتحاد في حقيقة النور، فمثلًا: عندما نتحدث عن الأنوار، ما هو الفرق بين نور الشمس ونور المصباح؟ لا فرق بين نور الشمس ونور المصباح في حقيقة النور، النور هو ما كان ظاهرًا بنفسه مظهرًا لغيره، حقيقة النور واحدة، سواء كان النور نور المصباح أو كان النور نور الشمس، الحقيقة واحدة، المعنى واحد، إنما الاختلاف بين نور المصباح ونور الشمس اختلاف بالدرجة فقط، وإلا الحقيقة واحدة، نور الشمس أقوى وأكثر شعاعًا من نور المصباح، وإلا في حقيقة النور هما شيء واحد، نور المصباح ونور الشمس حقيقة واحدة، الفرق بينهما بالدرجة، درجة الضوء في الشمس أقوى شعاعًا من درجة الضوء في نور المصباح.
هنا أيضًا من يقول بوحدة الوجود بهذا المعنى يقول: الله تبارك وتعالى له وجود، الإنسان له وجود، كلاهما متحد في حقيقة الوجود، إنما الاختلاف في درجة الوجود، الله موجود، الإنسان موجود، متحدان في حقيقة الوجود، معنى الوجود هو التحقق، الله متحقق، الإنسان أيضًا متحقق، إنما درجة الوجود عند الإنسان درجة محدودة، مشوبة بالعدم، مشوبة بالظلمة، بينما وجود الله عز وجل وجود لا يحده عدم ولا تشوبه ظلمة، فالفرق بين الوجودين اختلافٌ بين الدرجة، وليس اختلافًا في الحقيقة، كالاختلاف بين درجات النور، حيث إن هناك نورًا للشمس أقوى من نور المصباح. هذا المعنى الأول لمصطلح وحدة الوجود، وقد طرحه جمع من الفلاسفة.
المعنى الثاني: وحدة الموجود.
المقصود بوحدة الوجود وحدة الموجود، ومعنى وحدة الموجود أن الوجود الإمكاني للإنسان، الإنسان وجوده وجود إمكاني، يمكن أن يعرضه العدم في أي لحظة، الوجود الإمكاني مع الوجود الواجبي - وهو وجود الله عز وجل - الذي لا يعرضه عدم ولا تشوبه ظلمة، هذان الوجودان اتحدا، هذا المعنى من وحدة الوجود كفر، ولا يقول به أحد، وجود الله لامحدود، ووجود الإنسان محدود، ولا يعقل الاتحاد بين اللامحدود وبين المحدود، هذا المعنى أصلًا غير معقول، فضلًا عن كونه كفرًا، ولا يقول به أحدٌ من المسلمين، فوحدة الوجود بمعنى وحدة الموجود، أي أن وجود الإنسان اتحد مع وجود الله عز وجل، هذا المعنى مرفوض، غير معقول، فضلًا عن كونه كفرًا وإلحادًا، ولا يقول به أحد من الإمامية ولا من المسلمين.
المعنى الثالث: انحصار الوجود الحقيقي في الله.
المقصود بوحدة الوجود أن الوجود الحقيقي لله عز وجل، وغيره وجود مجازي، وجود وهمي، وليس وجودًا حقيقيًا، ومعنى هذا الكلام كما يحاول بعض العرفاء وبعض أهل المعرفة، يقول: المستفاد من بعض النصوص، ومنها هذا الدعاء الشريف الذي يُقرأ في أيام شهر رمضان، وهو دعاء يا مجير، ”تعاليت يا موجود“، ما معنى هذه الفقرة؟ كل الناس موجودون، لماذا يخص الله ويقول: تعاليت يا موجود؟! الإنسان موجود، الشمس موجودة، القمر موجود، فلماذا يقول الإمام  في الدعاء: تعاليت يا موجود؟! ما هو المقصود بهذه الفقرة؟
في الدعاء: تعاليت يا موجود؟! ما هو المقصود بهذه الفقرة؟
المقصود به الوجود الحقيقي المحض، الوجود الحقيقي المحض لله عز وجل، وما سواه وجودات وهمية، وجودات مجازية، وجودات خيالية، وليست وجودًا حقيقيًا، الوجود الحقيقي هو لله عز وجل، فلا وجود لغيره. هذا المعنى الثالث لمصطلح وحدة الوجود، ألا وجود لغير الله، وهذا المصطلح بهذا المعنى يناقش فيه السيد الخوئي «قدس سره» في كتابه «التنقيح في شرح العروة الوثقى»، يناقش في هذا المعنى لهذا المصطلح ألا وهو مصطلح وحدة الوجود.
يقول: ما معنى هذه الكلمة؟ نحن عندما نقول: لا وجود لغير الله، الله هو الموجود فقط، غيره وجوده خيالي، وجود وهمي، فما معنى هذا الكلام؟ هل نقصد بهذا الكلام أنه لا وجود حقيقةً لغير الله؟ نحن نتخيل أننا موجودون والحال أننا لسنا موجودين، نتخيل أن الشمس والقمر موجودان وهما غير موجودين؟! إذا كان المقصود بهذا الكلام أن ما سوى الله وهم وخيال وليس موجودًا أصلًا فهذا الكلام سفسطة، يتنافى مع شهادة الوجدان؛ فإن الوجدان شاهدٌ على أن الإنسان موجودٌ، وأن الكائنات التي برأها الله وأبدعها موجودة، لذلك هذه الكلمة المشهورة لديكارت: «أنا أفكر إذن أنا موجود»، التفكير حياة، والحياة دليلٌ على الوجود. إنكار وجود ما سوى الله، ألا يوجد شيء إلا الله، ما سواها وهم أو خيال، هذا يتنافى مع شهادة الوجدان، هناك موجود، كما أن لله وجودًا، للكائنات أيضًا وجود.
وإذا كان المقصود بهذا الكلام أن الوجود المحض لله، أي أن وجود غيره وجود لكنه مشوب بالعدم، وجود الإنسان مثلًا محدود في القدرة، محدود في العلم، محدود في الحياة، وجود محاط بالحدود من كل مكان، وجود الإنسان وجود محاط بالحدود، في قدرته محدود، في حياته محدود، في طاقته محدود، بما أن وجود الإنسان وجود محاط بالحدود فهو وجود ضعيف، لا يستحق أن يسمّى وجودًا، هو وجود في الواقع لكنه لضعفه ولمحدوديته لا يستحق أن يسمّى وجودًا، ﴿وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾، إذا كان الذباب [...] على هذا الإنسان، ”تؤلمه البقة، تنتنه العرقة، تقتله الشرقة“، فهذا وجود ضعيف جدًا، لا يستحق أن يسمى بالوجود.
بينما الوجود الحقيقي هو الوجود المحض الذي لا يشوبه حد، ولا يشوبه ظلمة، علمه عين ذاته، قدرته عين ذاته، حياته عين ذاته، لا حد لكماله عز وجل، ﴿اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾، فالوجود الحقيقي المحض له تعالى دون غيره، لذلك قال في الدعاء الشريف: ”تعاليت يا موجود“، أي: يا موجودًا بالوجود المحض، الذي لا يشوبه ضعف ولا عدم ولا نقص، فإذا كان المراد بوحدة الوجود أن الوجود المحض الذي لا يشوبه نقص ولا عدم خاصٌّ بالله عز وجل فهذا المعنى معنى صحيح، إذا كان المراد بوحدة الوجود هو هذا المعنى فهذا معنى صحيح، بل لا يمكن إنكاره، بل هو من ضروريات الدين.
المعنى الرابع: فناء الممكن في الواجب.
إن المراد بوحدة الوجود فناء الممكن في الواجب، ما معنى فناء الممكن في الواجب؟ علاقة الإنسان بالله تمر بدرجات، تمر بمراتب:
الدرجة الأولى: التوكل.
﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾، ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾، التوكل بمعنى الثقة بالله، أن يثق الإنسان بأن الله لا يصنع به إلا ما هو صلاحٌ له، هذا يسمى بالتوكل، هذه أول درجة من درجات العلاقة مع الله.
الدرجة الثانية: التسليم.
التسليم بمعنى أن تسلّم نفسك، القرآن يحكي عن هذه الدرجة: ﴿وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا﴾، أن تفوّض كل أمورك إلى الله، أن تقول: أنا عبد مملوك لله، يتصرف بي كيفما شاء ومتى شاء وبالنحو الذي شاء، لا يوجد عندي أي اعتراض، ولا يوجد عندي أي عتاب، ولا يوجد عندي أي تألم وأي تأفف، أنا مسلم لله بكل ما يفعل بي، ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ إشارة إلى مرتبة التسليم، ﴿إِنَّا لِلَّهِ﴾ نحن ملك لله، والمالك يتصرف في ملكه بما يريد، هذه الدرجة تسمى درجة التسليم.
وبعض المفسّرين يفسّر الآية المباركة، وهي قوله عز وجل: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾، يقول: المقصود بالتسليم هنا درجة التسليم، وليس المقصود بالتسليم السلام، السلام غير التسليم، قال: وسلموا تسليمًا، ولم يقل: وسلموا سلامًا، فهو يشير إلى درجة التسليم، وليس يشير إلى التحية.
الدرجة الثالثة: درجة الرضا.
هل أنت راضٍ؟! هناك كثير من الناس يقول: أنا مسلّمٌ لله عز وجل، ولكنني لست راضيًا! الله تبارك وتعالى مثلًا حرمني من الرزق، أو حرمني من الذرية، أو حرمني مثلًا من العلم، أنا أسلّم لله، إذ ما باليد حيلة، ولكنني لست راضيًا، لم أصل إلى هذه الدرجة، درجة الرضا. درجة الرضا درجةٌ أعلى، وهي أن يعتبر الإنسان النوائب نعمًا من الله، هذا الحرمان يعتبره الإنسان نعمة، يحمد الله ويشكره عليها، العبد يشكر الله على الفقر ويعتبر الفقر نعمة، العبد يشكر الله على عدم الذرية ويعتبر عدم الذرية نعمة.
عندما يصل العبد إلى هذه المرتبة - أن يعتبر المصائب نعمًا، أن يعتبر النوائب نعمًا يحمد الله ويشكره عليها عن قناعة - فهو قد وصل إلى مرتبة الرضا، وهذا ما عبّر عنه الحسين بن علي  : ”رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه، ويوفّينا أجور الصابرين“، وكما كان النبي الأعظم محمد
: ”رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه، ويوفّينا أجور الصابرين“، وكما كان النبي الأعظم محمد  عندما ذهب إلى الطائف يدعوهم للإسلام، وأمروا صبيانهم وسفهاءهم، فخرجوا يلقفون النبي بالحجارة والأشواك، حتى دميت رجلاه وأثخن بالجراح، فاستند إلى جدار بستانٍ، ورفع يديه إلى السماء، وقال: ”اللهم اهد قومي؛ فإنهم لا يعلمون، لك العتبى حتى ترضى“، هذا إشارة إلى مرتبة الرضا، هذه المرتبة الثالثة في الوصول إلى الله عز وجل.
عندما ذهب إلى الطائف يدعوهم للإسلام، وأمروا صبيانهم وسفهاءهم، فخرجوا يلقفون النبي بالحجارة والأشواك، حتى دميت رجلاه وأثخن بالجراح، فاستند إلى جدار بستانٍ، ورفع يديه إلى السماء، وقال: ”اللهم اهد قومي؛ فإنهم لا يعلمون، لك العتبى حتى ترضى“، هذا إشارة إلى مرتبة الرضا، هذه المرتبة الثالثة في الوصول إلى الله عز وجل.
الدرجة الرابعة: مرتبة الفناء.
بمعنى أن يصل الإنسان إلى العبادة إلى حد يفنى في الله، فلا يرى لنفسه وجودًا، هذه نتيجة انصهاره بالعبادة، إذا انصهر الإنسان في العبادة، إذا انصهر الإنسان في العروج نحو الله سيصل إلى درجة ألا يرى غير الله، لا يرى لنفسه وجودًا ولا إنية ولا نفسية، فلا يرى غير الله، هذه المرتبة المسماة بالفناء هي التي يعبّر عنها الإمام أمير المؤمنين  : ”ما رأيت شيئًا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه“، وهذه المرتبة هي التي يعبّر عنها الحسين بن علي
: ”ما رأيت شيئًا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه“، وهذه المرتبة هي التي يعبّر عنها الحسين بن علي  في دعاء يوم عرفة: ”متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدلّ عليك؟! ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك؟! عميت عينٌ لا تراك عليها رقيبًا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودّك نصيبًا“.
في دعاء يوم عرفة: ”متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدلّ عليك؟! ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك؟! عميت عينٌ لا تراك عليها رقيبًا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودّك نصيبًا“.
هذه الدرجة المسماة بدرجة الفناء هي التي يسمّيها العرفاء بوحدة الوجود، وحدة الوجود معناها أن تصل في الانصهار بالعبادة إلى درجة لا ترى لنفسك وجودًا، بل ترى أن لا موجود إلا الله، هذه درجة من العبادة، درجة من العروج إلى الله، هذه درجة روحية، درجة وجدانية، يدركها من وصل إليها، عندما نفسّر وحدة الوجود بهذا المعنى فنحن لا نلغي وجود الإنسان، بل الإنسان موجود، ولا ندّعي أن الوجود الإمكاني اتحد مع الوجود الواجبي، لا يعقل اتحاد المحدود مع اللامحدود، هذا كله لا نقول به، ولكن نقول: قد يصل بالإنسان العروج والقرب من الله إلى حد أينما يتوجه يرى الله عز وجل، ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾، هذا المعنى من وحدة الوجود ليس معنى مستنكرًا، بل هو ظاهر عدة من الروايات والأدعية الشريفة.
المعنى الأخير: وحدة الانتساب.
من معاني مصطلح وحدة الوجود ما ذكرناه في الليلة السابقة، وهو وحدة الانتساب، ومعنى وحدة الانتساب أن الفعل الواحد يُنْسَب إلى الله وإلى العبد. نأتي مثلًا إلى عمل يقوم به الإنسان، نظير ما في الآية المباركة: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى﴾، نقول: هذا الرمي الذي صدر عن النبي  ، النبي بدأ المعركة، وفي معركة بدر أخذ حجرًا ورمى به القوم، وقال: شاهت الوجوه، فانقلب الفضاء غبارًا. هؤلاء يقولون: هذا الرمي نستطيع نسبته إلى النبي، نقول: رمى النبي، ونستطيع نسبته إلى الله، نقول: الله رمى، فعلٌ واحدٌ يمكن نسبته لفاعلين: لله وللعبد، هذا معنى وحدة الوجود، بمعنى وحدة الانتساب، نسبة الفعل إلى العبد ونسبة الفعل إلى الله عز وجل.
، النبي بدأ المعركة، وفي معركة بدر أخذ حجرًا ورمى به القوم، وقال: شاهت الوجوه، فانقلب الفضاء غبارًا. هؤلاء يقولون: هذا الرمي نستطيع نسبته إلى النبي، نقول: رمى النبي، ونستطيع نسبته إلى الله، نقول: الله رمى، فعلٌ واحدٌ يمكن نسبته لفاعلين: لله وللعبد، هذا معنى وحدة الوجود، بمعنى وحدة الانتساب، نسبة الفعل إلى العبد ونسبة الفعل إلى الله عز وجل.
مثلًا تقول: رأيت بعيني، ويصح أن تقول: رأتك عيني، تستطيع نسبة الرؤية إلى العين، وتستطيع نسبة الرؤية إلى نفسك، يصح أن تقول: سمعتك أذني، ويصح أن تقول: سمعتك بأذني، فتنسب السمع إلى نفسك وتنسب السمع إلى الأذن. إذن، بعض الأفعال يمكن نسبتها إلى فاعلين، كذلك ما يصدر من العبد المخلوق يمكن نسبته إلى المخلوق ويمكن نسبته إلى الخالق، نقول: رمى النبي، ونقول: رمى الله.
هذا المعنى من وحدة الوجود - بمعنى وحدة الانتساب - أيضًا يناقش فيه بعض علمائنا، كسيدنا الخوئي «قدس سره»، يناقش في هذا المعنى، يقول: ما هو المقصود بالوحدة في الانتساب؟ هل المقصود النسبة المجازية، أم المقصود النسبة الحقيقية؟
إذا كان المقصود بالنسبة المجازية فهذا ليس محل بحث، مثلًا نقول: بنى البنّاء المسجدَ وبنى التاجر الفلاني المسجد، تستطيع نسبة المسجد إلى من بناه، وتستطيع نسبته إلى من بذل الأموال في سبيل بنائه، تقول: فلان بنى المسجد؛ لأنه البنّاء، وتقول: التاجر بنى المسجد؛ لأن بأمواله وبأمره قام هذا المسجد، إلا أن هذه النسبة مجازية، في الواقع الذي بنى المسجد هو البنّاء فقط، نسبة البناء إلى التاجر نسبة مجازية. إذا كان المقصود النسبة المجازية، أن ننسب الفعل إلى الله، فعل صدر من الله ننسبه إلى الله مجازًا، فهذه النسبة المجازية ليست محل بحث علمي حتى نضيّع الوقت فيه، النسبة المجازية تصح.
وأما إذا كان المقصود النسبة الحقيقية، أي أن هذا العمل فاعله الله حقيقةً، العبد هو الذي قام، تقول: الله هو الذي قام؟! العبد هو الذي والعياذ بالله زنا أو شرب الخمر، هل يمكن نسبة ذلك إلى الله؟! هل يمكن نسبة ذلك إلى الله نسبة حقيقية؟! الفعل الصادر من العبد هل يمكن نسبته إلى الله نسبة حقيقية؟! السيد الخوئي يقول: لا، لا يمكن. نستطيع أن نقول: هناك خالق، وهناك فاعل، فرق بين الخالق والفاعل، الله خلق الفعل؛ لأنه هو الذي أعطى المدد والوجود، أما الذي تلبّس بالفعل وأراده فهو العبد.
ولذلك نلاحظ الآية المباركة: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا * وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا * كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ﴾، المدد من عندنا، نحن الذين نمد، نحن دورنا دور المدد، دور العطاء، الفاسق يريد حياة، نعطيها إياه، المؤمن يريد حياة، نعطيها إياه، هذا يصرف الحياة في الفسق، هذا يصرف الحياة في الإيمان، ﴿كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾، ففرق بين الخالقية وبين الفاعلية.
نحن نقول: القيام فعله العبد، ولكن الذي خلق القيام - بمعنى وهب الحياة والقدرة بحيث وُجِد القيام والقعود - هو الله، ففرق بين الأمرين، لا يمكن أن ننسب فعل العبد إلى الله نسبةً حقيقيةً، العبد هو الذي شرب الخمر، العبد هو الذي زنى، العبد هو الذي صلى، العبد هو الذي صام، هذا الفعل لا ينتسب إلى الله حقيقة. نعم، القدرة والطاعة التي بها وُجِد الفعل مصدرها الله عز وجل، فنسبة الله للفعل نسبة الخالقين، ونسبة الإنسان للفعل نسبة الفاعلية، هو الذي أراد وهو الذي فعل وصنع، فهذا المعنى الأخير من وحدة الوجود - والذي أشرنا إليه في الليلة السابقة - إذا كان المراد به النسبة المجازية فلا إشكال فيها، وإذا كان المراد به النسبة الحقيقية فهو معنى غير صحيح.
هذا كله يتعلق بالمحور الأول من حديثنا، وهو الربط بين إرادة العبد وإرادة الله، الذي تحدثت عنه الآية المباركة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾.
المحور الثاني: إشكالية الشرور.
هل أن الشرور والقبائح خلقها الله؟ الله ما فعلها، ليس الله هو الذي يفعل القبيح، وليس الله هو الذي يفعل المحرم، العبد هو الذي زنى وشرب الخمر، لكن هل الله هو الذي خلق القبائح، هو الذي خلق الشرور؟ وهل ينسجم ذلك مع كماله عز وجل، فإن الكمال لا يصدر عنه إلا الكمال، فكيف يصدر عنه الشرور والقبائح؟! كيف يكون الله مصدرًا للأمراض، مصدرًا للويلات، مصدرًا للكوارث، مصدرًا للقبائح؟! هذه الشبهة وهذا السؤال أجيب عنه في كلمات علمائنا وفلاسفتنا بجوابين:
الجواب الأول: عدمية الشرور.
أن الشرور والقبائح ليست من الوجود حتى يخلقها الله، بل هي من سنخ العدم، والعدم غير مخلوق، العدم لاشيء حتى يُخْلَق، فمثلًا: نحن عندما نأتي إلى العدل والظلم، العدل أمر وجودي، العدل إعطاء كل ذي حق حقَّه، هو إعطاء فهو وجود، أما الظلم ليس أمرًا وجوديًا، الظلم عدم، الظلم عدم إعطاء ذي الحق حقه، فالظلم أمرٌ عدميٌ، والعدل هو الأمر الوجودي، فنقول: الله صنع العدل لأن العدل وجود، ولم يصنع الظلم لأن الظلم لا يُصْنَع، الظلم أمرٌ عدميٌ، وهو عبارة عن عدم العدل.
نظير البصر والعمى، البصر وجود، أما العمى ليس وجودًا، العمى هو عدم البصر. نظير العلم والجهل، العلم وجود، أما الجهل ليس وجودًا، العلم هو عدم العلم. هذه الشرور أمور عدمية، والأعدام لاشيء حتى يقال: خلقها الله! الله يخلق الشيء، يخلق الوجود، وأما اللاشيء فليس شيئًا حتى يتعلق به خلق الله تبارك وتعالى.
مثلًا من باب المثال: سأل المنصور العباسي الإمام الصادق  يومًا من الأيام، كان جالسًا في المدينة المنورة، والإمام الصادق في نفس المجلس موجود، صارت ذبابة تذهب وتأتي على وجه المنصور، كلما أبعدها رجعت إليه، فغضب المنصور، قال: يا أبا عبد الله، لماذا خلق الله الذباب؟! قال: ليذلَّ به أنوف الجبابرة!.. هنا أحيانًا الإنسان يتساءل، يقول: هذا الذباب مصدر شر، الذباب خلقه الله، إذن الله خلق الشر! لا، الشر نشأ عن أمر عدمي، وهو عدم الانسجام بين خلايا بدن الإنسان وبين الذبابة، وإلا كلاهما وجود، كلاهما طاقة.
يومًا من الأيام، كان جالسًا في المدينة المنورة، والإمام الصادق في نفس المجلس موجود، صارت ذبابة تذهب وتأتي على وجه المنصور، كلما أبعدها رجعت إليه، فغضب المنصور، قال: يا أبا عبد الله، لماذا خلق الله الذباب؟! قال: ليذلَّ به أنوف الجبابرة!.. هنا أحيانًا الإنسان يتساءل، يقول: هذا الذباب مصدر شر، الذباب خلقه الله، إذن الله خلق الشر! لا، الشر نشأ عن أمر عدمي، وهو عدم الانسجام بين خلايا بدن الإنسان وبين الذبابة، وإلا كلاهما وجود، كلاهما طاقة.
الإنسان طاقة، والذبابة طاقة، وكل طاقة تؤدي دورها في هذا الكون، في هذه الحياة، فكل منهما خير، وكل منهما وجود، لكن نتيجة عدم الانسجام بين خلايا البدن وبين هذه الطاقة يحصل الشر، فالشر يرجع إلى أمر عدمي، عدم الانسجام بين خلايا بدن الإنسان وبين هذه الذبابة، وإلا كلاهما وجود، كلاهما طاقة، كلاهما خير، فالله خير لا يصدر عنه إلا الخير، وهو وجودٌ لا يصدر عنه إلا الوجود، وهو كمال لا يصدر عنه إلا الكمال، وأما الشرور فهي كلها أمور عدمية، أو ناشئة عن أمور عدمية.
الجواب الثاني: ضرورة الشرور في الابتلاء.
الله خلق الشرور، لكن هذا لا يعد ظلمًا للعباد، ولا يعد خلاف الكمال؛ لأنه خلق الشرور كما خلق الخير امتحانًا لإرادة العبد، فبما أن الهدف من صنع الشرور وصنع الخير امتحان إرادة العبد، من أجل أن يصل العبد إلى كماله بجدارة واستحقاق، كان بإمكان الله أن يخلق الإنسان مؤمنًا من البداية، كان بإمكان الله أن يخلق الإنسان تقيًا من البداية، لكن الله خلق الإنسان وهو يعيش صراعًا بين شهوة وعقل، عقله يدعوه إلى الخير، شهوته تدعوه إلى الشر، خلق الإنسان يعيش صراعًا بين الشهوة والعقل، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين  : ”إنَّ الله خلق الملائكة عقلًا بلا شهوة، وخلق البهائم شهوةً بلا عقل، وركّب في الإنسان عقلًا وشهوةً، فمن غلب عقله شهوتَه فهو خيرٌ من الملائكة، ومن غلبت شهوتُه عقلَه فهو أدنى من البهائم“.
: ”إنَّ الله خلق الملائكة عقلًا بلا شهوة، وخلق البهائم شهوةً بلا عقل، وركّب في الإنسان عقلًا وشهوةً، فمن غلب عقله شهوتَه فهو خيرٌ من الملائكة، ومن غلبت شهوتُه عقلَه فهو أدنى من البهائم“.
الله خلق الإنسان صراعًا بين الشهوة والعقل من أجل أن يصل إلى كماله عن جدارة واستحقاق، وعن إرادة وبطولة في هذا الميدان، ميدان الصراع بين العقل والشهوة، ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾، وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى * وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾.
إذن، لماذا خُلِق الشر؟ لأنه لو لم يُخْلَق الشر لما عاش الإنسان صراعًا بين الخير والشر، ولما وصل الإنسان إلى الكمال بجدارة واستحقاق، لو كان الإنسان لا يعيش إلا الخير لكان مجبورًا على أن يكون خيِّرًا، لكن خُلِق له طرفان: خير وشر، ليميّز بينهما، ويحكّم إرادته في الصراع بينهما، ليصل إلى كماله عن إرادة وبطولة وجدارة واستحقاق، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي  : ”وإنما هي نفسي أروّضها بالتقوى“. إذن، الشر مخلوقٌ، لكن خُلِق لأجل امتحان الإنسان.
: ”وإنما هي نفسي أروّضها بالتقوى“. إذن، الشر مخلوقٌ، لكن خُلِق لأجل امتحان الإنسان.
قال تبارك وتعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا * إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ﴾، هو محل ابتلاء أينما ذهب، منذ ولادته وحتى وفاته، كل لحظة هو في ابتلاء، كل لحظة هو في امتحان، ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾، ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ﴾، وقال تبارك وتعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾، ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾، ﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾.
إذن، دار الدنيا دار الامتحان، دار الابتلاء، لتمحيص إرادة الإنسان، لتمحيص شخصية الإنسان، من أجل أن يصل الإنسان إلى كماله عن جدارة واستحقاق، وليس هذا منافيًا للعدالة، ولا منافيًا للرحمة، ولا منافيًا للكمال، ما دام الهدف من صنع الشرور وصنع الخير هو صقل شخصية الإنسان، لكي يصل إلى كماله الروحي عن جدارة واستحقاق.
لذلك، هذه الأحداث التي تمر علينا في هذه الأيام ليست شرًا، بل هي خيرٌ، الأحداث تجمع الكلمة، الأحداث تظهر قوة الدين وقوة المذهب، الأحداث تؤلّف بين القلوب وتربط بين النفوس، الأحداث تمحِّص المؤمن من غيره، والصابر من غيره، والمجاهد من غيره، كل هذه الأحداث والآلام والآهات التي تمر على الأمة هي تمهيدٌ وإرهاصٌ لظهور المهدي المنتظر «عجل الله تعالى فرجه الشريف»، لأنها تعبّد الأرضية، لأنها تميّز وتغربل الصالح من غيره، وتربط الناس بإمامهم وأملهم المهدي المنتظر «عجل الله تعالى فرجه الشريف».
وهذا امتدادٌ لتاريخ أهل البيت، هل مرَّ على شيعة أهل البيت زمانٌ كانوا فيه خالين وخالصين من كل المشاكل والابتلاءات والامتحانات؟! أبدًا، منذ يوم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، منذ أول يوم توفي فيه رسول الله  بدأ مسلسل الامتحان والابتلاء، وبدأ مسلسل الجهاد والتضحية والفداء، ومنذ تضحية فاطمة الزهراء «صلوات الله وسلامه عليها» إلى يومنا هذا والمذهب الإمامي يقدّم التضحيات، يقدّم العطاء، يقدّم البطولات، على مدى كل زمن، وبحسب ما تقتضيه الظروف، فهذا التاريخ هو كله تاريخ عطاء، تاريخ تضحية، تاريخ فداء.
بدأ مسلسل الامتحان والابتلاء، وبدأ مسلسل الجهاد والتضحية والفداء، ومنذ تضحية فاطمة الزهراء «صلوات الله وسلامه عليها» إلى يومنا هذا والمذهب الإمامي يقدّم التضحيات، يقدّم العطاء، يقدّم البطولات، على مدى كل زمن، وبحسب ما تقتضيه الظروف، فهذا التاريخ هو كله تاريخ عطاء، تاريخ تضحية، تاريخ فداء.
فمن الجميل أن ينتسب الإنسان إلى هذا التاريخ، لا أن يتبرّأ منه، لا أن يتخلّص منه، لا أن يتأفأف منه، يقول: إلى متى نحن في هذه المشكلة؟! غيرنا مرتاح، نحن دائمًا ابتلاء، ودائمًا مشاكل، ودائمًا قضايا! هذا تاريخك، أنت تنتمي إلى هذا التاريخ، تاريخ العطاء، تاريخ التضحية، تاريخ الفداء، تاريخ الحسين وآل الحسين، أنت تفخر بهذا التاريخ، لا أنك تتبرم من هذا التاريخ، لا أنك تحاول التجرّد والخروج عن هذا التاريخ، هذا تاريخك، هذا معدنك، هذه سلسلة أجدادك وآبائك إلى أن جئت، منذ يوم الحسين بن علي  وهذا التاريخ يبقى، تضحية من جهة وثبات من جهة، مهما صنع الظالمون من الظلم، كما ورد عن السيدة العقيلة بطلة كربلاء زينب بنت أمير المؤمنين
وهذا التاريخ يبقى، تضحية من جهة وثبات من جهة، مهما صنع الظالمون من الظلم، كما ورد عن السيدة العقيلة بطلة كربلاء زينب بنت أمير المؤمنين  : ”فكد كيدك، واسع سعيك، وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا، ولا تميت وحينا، وإن رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي: ألا لعنة الله على القوم الظالمين؟!“.
: ”فكد كيدك، واسع سعيك، وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا، ولا تميت وحينا، وإن رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي: ألا لعنة الله على القوم الظالمين؟!“.