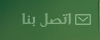القانون الجزائي في القرآن وَسنة النبي محمد (ص)
الليلة الرابعة من محرم الحرام 1441هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: 33]
صدق الله العلي العظيم
في عصر النبي الأعظم  دخلت مجموعة من بني سليم، أو من بني ضبة، أو من العرنيين على اختلاف الروايات إلى المدينة المنورة، وقالوا: يا رسول الله إننا مرضى أصابنا مرض أو وباء أو عدوى فأخرجنا من المدينة لعلنا نشفى أو نطيب، فبعثهم الرسول
دخلت مجموعة من بني سليم، أو من بني ضبة، أو من العرنيين على اختلاف الروايات إلى المدينة المنورة، وقالوا: يا رسول الله إننا مرضى أصابنا مرض أو وباء أو عدوى فأخرجنا من المدينة لعلنا نشفى أو نطيب، فبعثهم الرسول  إلى منطقة بيت المال، وهي المنطقة التي تُخزن فيها الزكوات: الإبل، البقر، الغنم، والغلات الأربع، منطقة خارج المدينة هي مخزن للزكوات، ومنها توزع الزكاة على المسلمين، أخرجهم الرسول إلى تلك المنطقة فبقوا فيها أياماً يأكلون من لحومها ويشربون من ألبانها، يقتاتون على مزروعاتها إلى أن شفوا وبرئوا من مرضهم، فارتكبوا جريمةً، قتلوا مجموعة من عمال الزكاة، وسرقوا من الأموال ما أرادوا وهربوا، فأرسل رسول الله
إلى منطقة بيت المال، وهي المنطقة التي تُخزن فيها الزكوات: الإبل، البقر، الغنم، والغلات الأربع، منطقة خارج المدينة هي مخزن للزكوات، ومنها توزع الزكاة على المسلمين، أخرجهم الرسول إلى تلك المنطقة فبقوا فيها أياماً يأكلون من لحومها ويشربون من ألبانها، يقتاتون على مزروعاتها إلى أن شفوا وبرئوا من مرضهم، فارتكبوا جريمةً، قتلوا مجموعة من عمال الزكاة، وسرقوا من الأموال ما أرادوا وهربوا، فأرسل رسول الله  إليهم علي بن أبي طالب
إليهم علي بن أبي طالب  فأسرهم، وأتى بهم إلى النبي
فأسرهم، وأتى بهم إلى النبي  ، فلما مثلوا بين يدي رسول الله
، فلما مثلوا بين يدي رسول الله  أمر بقتلهم، وفي رواية أنه أمر بقطع أيديهم وأرجلهم، وهذا الحدث اتفق عليه المؤرخون شيعة وسنة.
أمر بقتلهم، وفي رواية أنه أمر بقطع أيديهم وأرجلهم، وهذا الحدث اتفق عليه المؤرخون شيعة وسنة.
ومن هنا أصبح هذا الحدث وأمثاله من القصص التي حدثت في زمان النبي  واتخذ فيها النبي هذا الإجراء وهو إجراء القتل أصبح مادة للطعن من قبل بعض المستشرقين، أن النبي ليس قائد رحمة، وإنما هو قائد يعيش روحاً دموية، وإلا فلماذا قام بهذا الإجراء وهو قتل هؤلاء! ألم يكن بإمكانه سجنهم! ألم يكن بإمكانه إصلاحهم! لماذا قام بهذا الإجراء، هل يتناسب هذا الإجراء مع روح الرحمة التي مدحها به القرآن الكريم وقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107] فكيف قام بهذا الإجراء القاسي بحق هؤلاء! من هنا نحن نحتاج إلى أن نضع النقاط على الحروف، وذلك بالحديث عن محورين رئيسين:
واتخذ فيها النبي هذا الإجراء وهو إجراء القتل أصبح مادة للطعن من قبل بعض المستشرقين، أن النبي ليس قائد رحمة، وإنما هو قائد يعيش روحاً دموية، وإلا فلماذا قام بهذا الإجراء وهو قتل هؤلاء! ألم يكن بإمكانه سجنهم! ألم يكن بإمكانه إصلاحهم! لماذا قام بهذا الإجراء، هل يتناسب هذا الإجراء مع روح الرحمة التي مدحها به القرآن الكريم وقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107] فكيف قام بهذا الإجراء القاسي بحق هؤلاء! من هنا نحن نحتاج إلى أن نضع النقاط على الحروف، وذلك بالحديث عن محورين رئيسين:
- فلسفة نظام العقوبة في القانون الوضعي.
- فلسفة نظام العقوبة في القانون الإسلامي.
المحور الأول: فلسفة نظام العقوبة في القوانين الوضعية.
إذا رجعنا إلى علم القانون يذكر علماء القانون: لا يوجد مجتمع ليس فيه عقوبة، وأقدم المقررات التي اتفقت عليها المجتمعات الإنسانية هو نظام العقوبة، فما وُجِد مجتمع إنساني إلا ومعه نظام عقوبة، إذن نظام العقوبة هو نظام عقلائي، وكل المجتمعات العقلائية وضعت نظام عقوبة، فما هي فلسفة العقوبة في القانون الوضعي؟
نحن أمامنا عدة نظريات وعدة مدارس نتعرض إليها بشكل إجمالي ومتسلسل، ويمكنكم الرجوع إلى كتاب «النظام العقابي الإسلامي دراسة ومقارنة» للدكتور أبو الفتوح، أو كتاب «عقوبة الإعدام حل أم مشكلة» للدكتور غسان رباح أو مجلة الحقوقية التي أخرجتها وزارة العدل المصرية العدد الثاني، فهذه الكتب تناولت فلسفة نظام العقوبة في القوانين الوضعية، وأمامنا عدة نظريات وعدة مدارس.
النظرية الأولى: نظرية النفع الاجتماعي.
روسو هو من نادى بهذه النظرية في مقاله العقد الاجتماعي، فقال: كل مجتمع اتفق أفراده على عقد وميثاق بينهم، وهذا العقد عبارة عن حماية الحقوق وحماية الحريات، حق الملكية، حق العامل في عمله، حق المجتمع في الأمن، كلها حقوق، وكل مجتمع اتفق على عقد ألا وهو حماية الحقوق والحريات، وهذا عقد اجتماعي موجود في كل مجتمع، فإذا افترضنا أن شخصاً ارتكب جريمة قتل إنسان، أو سرق مال، أو اعتدى على عرض، فهو يعتبر أنه قد نقض العقد؛ لأن العقد يحمي الحريات والحقوق فإذا ارتكب جريمةً فقد نقض العقد، وإذا نقض العقد استحق العقوبة، إذن فلسفة العقوبة هي عبارة عن حماية العقد الاجتماعي، ومن أجل أن يبقى هذا العقد لابد أن نعاقب من ينقضه ومن يخرج عنه.
مسألة العقد الاجتماعي هي مسألة موجودة لدينا نحن في الفقه الإمامي، يقول السيد السيستاني دام ظله: أي بلد يدخله الإنسان بطريقة رسمية يعتبر دخوله عقد، فإذا أردت أن تدخل أي بلد كان شرقي أو غربي، مسلم أو كافر لا فرق فيها، أي بلد تدخله بطريقة رسمية تعتبر الفيزا عقد، وتوقيع الجمرك للدخول يعتبر عقد؛ بمعنى أن الدولة تقول لك نحن نعطيك الفيزا لكن بشرط أن تلتزم بأنظمتنا وقوانينا مقابل أن نحترم حقوقك، وأن نحترم جميع حرياتك، فهناك عقد بينك وبين الدولة التي تدخلها، أن تلتزم بأنظمتها بإزاء أن تحترم الدولة شخصيتك وحقوقك، لذلك السيد السيستاني يُحرِّم مخالفة النظام في أي بلد حرمة شرعية؛ لأن مخالفة النظام هو إخلال بالعقد الذي بينك وبين الدولة، وهذا عقد عقلائي أمضاه القرآن الكريم بقوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1].
النظرية الثانية: نظرية الردع والتعويض.
المدرسة التقليدية في علم القانون، القانوني الإيطالي بيكاريا، والقانوني الإنجليزي غونتام صاحب كتاب «رسالة الثواب والعقاب»، كلاهما ناديا بهذه النظرية نظرية الردع والتعويض، فما معنى هذه النظرية؟ يقولون لنفترض أنه لا يوجد عقد اجتماعي، وروسو يركز على وجود عقد، فلو لم يكن هناك عقد فهل هذا معناه أنه لا يوجد عقوبة؟ ولماذا نربط العقوبة بالعقد؟ لو لم يكن هناك عقد اجتماعي أي لا عقوبة، هو أمر غير ممكن، فلو كان المجتمع متناحر ومختلف وليس بينه أي عقد ولا ميثاق، يأكل بعضه بعضا فهل هذا معناه لا يوجد عقوبة؟ لابد من العقوبة، ولا ربط للعقوبة بالعقد الاجتماعي لأن فلسفة العقوبة تكمن في الردع والتعويض، فالإنسان عندما يرتكب جريمة والعياذ بالله، قتل نفس، هتك عرض، سرقة مال، عندما يرتكب الجريمة بالنتيجة لابد من عقوبته من أجل أولاً ردع غيره أن لا تحدث نفسه بارتكاب الجريمة، وثانياً تعويض الخسارة التي وقعت على المجني عليه من الجاني، فلابد من عقوبته تعويضاً للخسارة.
إذن من منطق الردع وتعويض الخسارة لابد من تسجيل العقوبة كان هناك عقد اجتماعي أو لم يكن، بل أضافت هذه المدرسة المدرسة التقليدية بنداً آخر ألا وهو تقنين العقوبة، ونلاحظ التعبير الجميل عند أصحاب هذه المدرسة يقولون ليست الجريمة ظاهرة إنسانية، بل إن الجريمة كائن قانوني، مثلا الفن ظاهرة إنسانية، والرياضة ظاهرة إنسانية، الإبداع ظاهرة إنسانية، أما عندما نأتي إلى المعاملات كالبيع والإجارة والمضاربة والشركة فهذه ليست ظاهرة إنسانية بل كائن قانوني، أي أن هذه المعاملة لها أحكام قانونية تنظم عملية البيع وعملية الإجارة والشركة وما أشبه ذلك، فهذه كائنات قانونية لا ظواهر إنسانية.
والجريمة ليست ظاهرة إنسانية بل كائن قانوني، لذلك لابد لكل جريمة من قانون يحكمها، والقاضي لا يعمل برأيه، ولابد من تقليص سلطة القاضي، القاضي فدوره فقط هو تطبيق القانون على ضوء اللائحة القانونية للجرائم.
النظرية الثالثة: نظرية العدالة.
كتب الفيلسوف الألماني كانت كتاب «نقد العقل النظري» وكتاب «نقد العقل العملي»، وفي كتابه الثاني طرح نظرية في فلسفة العقوبة، قال: كلتا النظريتين السابقتين فاشلتين، النظريتان السابقتان نظرية النفع الاجتماعي أو نظرية الردع والتعويض كلاهما يربطان العقوبة بوجود مجتمع، فإذا كان المجتمع موجود إذن لابد أن نقيم العقوبة حماية لهذا المجتمع وتعويضاً لخسارة المجتمع، ولكن المسألة ليست مربوطة بالمجتمع، فلو افترضنا أن الناس يعيشون مستقلين، وكل واحد يعيش حياته منعزلاً ومنفرداً عن الآخر ولا وجود لجو اجتماعي إطلاقاً، واعتدى إنسان على آخر بقتل أو بسرقة أو بهتك فهل هذا يعني أنه لا توجد عقوبة لأن المجتمع غير موجود! لابد من تسجيل العقوبة حتى لو لم يوجد مجتمع؛ لأن العدالة قيمة مطلوبة في حد ذاتها.
عقوبة المذنب عدالة، والعدالة مطلوبة في حد ذاتها أراد أم لم يُرد، وُجِد مجتمع أو ما وجد، العدالة شي مطلوب في حد ذاته إذن لابد من عقوبة المذنب.
النظرية الرابعة: النظرية الإصلاحية.
مدرسة معروفة في الفلسفة اسمها المدرسة الوضعية ولها عدة تعاليم وتأملات في شتى الميادين ومنها هذا الميدان، ميدان فلسفة العقوبة، تقول المدرسة الوضعية أن الجريمة ليست سبب بل إنها نتيجة، ومعنى ذلك أن تطبيق العدالة ليس بعقوبة من أجرم، وإنما يكون تطبيق العدالة بمعالجة أسباب الجريمة، ففرق بين أن نطبق العدالة بعقوبة المذنب، وبين أن نطبق العدالة بمعالجة أسباب الجريمة، فلو أن إنساناً سرق أموال، يُنظر لماذا سرق الأموال، لعل هذا الذي سرق نتيجة الفقر والفاقة؛ أي نتيجة خلل اقتصادي وعدم تناسب بين مستوى الإنتاج ومستوى التوزيع، فانتشرت حالة من الفقر، ونتيجة انتشار هذه الحالة سرق فلان أموال فلان، فبدل أن تعاقب السارق لابد أن تعالج أسباب الجريمة، وتعالج هذا الخلل الاقتصادي، إنسان قتل إنسان لكن لعله قد قتله لأزمة نفسية عنده، فبدل أن تعاقبه تعالج الأزمة النفسية التي دفعته إلى أن يرتكب جريمة القتل.
فهذه المدرسة الوضعية تبنت النظرية الإصلاحية، والنظرية الإصلاحية هي عبارة عن أن الجريمة نتيجةٌ وليست سبب، فلابد من علاج أسباب الجريمة والسبب في الإخلال بالعدالة، بل انبثقت حركة من هذه المدرسة تسمى حركة الدفاع الاجتماعي، وهذه الحركة ألغت العقوبة أصلاً حتى لو كان قاتلاً مغتصباً أو ارتكب جريمة فظيعة، قالوا لابد من تأهيله وإعادته إلى الاندماج في مجتمعه مرة أخرى، فلماذا نخسره ونقتل طاقته وهو إنسان، والإنسان طاقة، فلماذا نسحق هذه الطاقة! بل علينا أن نعيد برمجته وتأهيله، ونتيجة إعادة تأهيله يعود إنساناً فاعلاً في بناء المجتمع.
النظرية الخامسة: المدرسة التوفيقية.
المدرسة التوفيقية هي آخر المدارس التي ظهرت في تحديد فلسفة نظام العقوبة، وقد تبنت الجمع بين الحقين: الحق العام، والحق الخاص، فالحق العام هو حق المجتمع، حق المتجمع في الأمن، حقه في حماية الحقوق والحريات، وهناك حق خاص وهو حق هذا المذنب في تأهيله ورعايته وفي إعادة برمجته، إذن لابد من الجمع بين الحقين، فسميت بالمدرسة التوفيقية.
تقول هذه المدرسة: لابد من عقوبة هذا المذنب أداءً لحق المجتمع، وفي نفس الوقت إذا كان هذا المذنب قابل للتأهيل ويوجد إمكانية لتأهيله فلا نحرمه حقه في التأهيل، إذن هو يذوق عقوبته لأنه أخل بالحق العام، وفي نفس الوقت يُعطى حقه من التأهيل ليعود إنساناً فاعلاً إذا كان قابلاً للتأهيل.
وقد تبنت هذه النظرية عدة دول متقدمة، وحتى بعض الدول العربية كدولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، تبنت هذه النظرية وقامت بإنشاء مراكز تأهيل ورعاية للمذنبين أو النزلاء في السجون، وتبتني هذه المراكز على مناهج تعليمية تستند إلى علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الإدارة، فيدخل هذا المذنب في مصحة نفسية، وفي أجواء ثقافية تعيد برمجته للحياة من جديد، وتعيد تفعيله كإنسان فاعل في بناء مجتمعه من جديد.
المحور الثاني: فلسفة نظام العقوبة في القانون الإسلامي.
أول من كتب في فلسفة نظام العقوبة في القانون الإسلامي هو ابن القيم، صاحب كتاب «إعلام الموقعين عن رب العالمين»، وتحدث عن هذه النقطة بشكل علمي، ثم جاءت الأقلام من بعده، فتناول المسألة المرحوم العلامة المطهري، والعلامة الطباطبائي.
هناك ثلاثة منطلقات لشرح نظام فلسفة العقوبة في النظام الإسلامي: منطلق فلسفي، منطلق كلامي، منطلق إنساني.
المنطلق الأول: المنطلق الفلسفي.
هناك هدف أولي وهدف ثانوي، فما هو الفرق بين الهدف الأولي والهدف الثانوي؟
الهدف الأولي لجميع الشرائع ولجميع الأديان هو استقرار الحياة الاجتماعية، واستقرار الحياة الاجتماعية إنما يحصل بحفظ النظام، وحفظ النظام يعني حماية الأنفس والأعراض والأموال عن التلف والضياع، إذن الهدف الأول للشريعة، والهدف الأول للدين، والهدف الأول للسماء هو استقرار الحياة الاجتماعية بحماية الأنفس والأعراض والأموال، لذلك قال تبارك وتعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: 25]
وهناك أهداف ثانوية تتفرع على هذا الهدف نذكر منها هدفين هما: العدالة، والتزاحم بين الحقوق.
- الهدف الأول: العدالة وهي شيء مطلوب، وقد ذكرها القرآن الكريم بقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى﴾ [النحل: 90]، ولكن هل العدالة مطلوبة في حد ذاتها كما يقول كانت؟ علماء الكلام عندنا أيضاً يقولون أن العدالة قيمة مطلوبة في حد ذاتها، وأما الفلاسفة فيقولون أن العدالة ليست مطلوبة في حد ذاتها، العدالة مطلوبة من أجل تحقيق استقرار الحياة الاجتماعية، فالمطلوب هو استقرار الحياة الاجتماعية، والعدالة مجرد طريق ووسيلة لاستقرارها وإلا فهي ليست مطلوبة في حد ذاتها.
- الهدف الثاني: التزاحم بين الحقوق، عندنا قاعدة عقلية تقول إذا تزاحم المهم والأهم يقدم الأهم؛ وذلك لأنه أكثر دخلاً وتأثيراً في استقرار الحياة الاجتماعية من غيره، فإنقاذ النفس قبل إنقاذ المال، لأن قيمة النفس أهم من قيمة المال؛ ولأن الحفاظ على قيمة النفس أكثر تأثيراً في استقرار الحياة الاجتماعية من الحفاظ على قيمة المال.
ومن هذا المنطلق جاءت فلسفة نظام العقوبة في الإسلام، فنظام العقوبة في الإسلام يقول أن هناك تزاحم بين الحق العام والحق الخاص، فالمجتمع له حق الأمن، الذي يحمي حقوقه ويحمي حرياته ويحمي أنفسه وأعراضه وأمواله، وهذا الذي ارتكب الجريمة له حق الحياة، فيقع عندنا تزاحم بين حق المجتمع في الأمن، وحق من ارتكب الجريمة في الحياة، فيقدم الحق العام لأنه أهم وأكثر تأثيراً في استقرار الحياة الاجتماعية من الحق الخاص.
ولذلك إقامة القصاص على القاتل ليست حماية للمجتمع فقط فحتى أسرته يحميها، لأنه لو تُرك فالأمر سيصبح فوضى، فقد تعتدي أسرة المجني عليه على أسرة الجاني، إذن في قتله حماية لأسرته كما هو حماية لمجتمعه، ولذلك جاءت الآية المباركة: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 179]، ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32]
المنطلق الثاني: المنطلق الكلامي.
يذكر علماء الكلام أن الرسالة الإسلامية جاءت اعتماداً على منطق الرحمة، يقول القرآن الكريم ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107]، فالدين رحمة، وبما أن القانون الجزائي وهو قانون العقوبات جزء من الدين إذن لابد أن يكون القانون الجزائي أيضاً رحمة ومصداق للرحمة.
هناك رؤيتان: رؤية رأسمالية غربية، ورؤية إسلامية.
- الرؤية الرأسمالية: وهي الرؤية المسيطرة اليوم على العالم، وهي ترى ضرورة إقامة حضارة تكنلوجية، وحضارة تسيطر على الفضاء، وحضارة تستثمر كنوز الطبيعة، وحضارة تأخذ بالإنسان إلى أن يسيطر على كل شيء سيطرة مادية، هذا ما تدعو إليه الرؤية الرأسمالية، تريد للإنسان أن يرتفع إلى أن يصبح هو المهيمن على هذه الطبيعة، وعلى هذا الكون بأسره.
- الرؤية الإسلامية: تدعو الرؤية الإسلامية أيضاً لإقامة حضارة، يقول القرآن ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: 61]، ويقول: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ [العنكبوت: 20] يدعو إلى اكتشاف الخلق واكتشاف الأسرار والكنوز والمنابع، ويدعو إلى إقامة حضارة لكن الفرق بين الرؤيتين وما يدعو إليه القرآن هو إقامة حضارة قائمة على مبدأين: الأمن النفسي، والأخوة.
المبدأ الأول: الأمن النفسي.
حتى لو وصل الإنسان إلى المريخ وسيطر على الطبيعة، إذا لم يكن هناك أمن نفسي فليست الحضارة هي حضارة إنسانية، ولو نظرنا إلى أمثلة من الواقع كما يحصل في الغرب الآن نرى أن أكثر العيادات رواجاً وانتشاراً في الولايات المتحدة وأوروبا هي العيادات النفسية، إذن المجتمع لا يعيش أمن نفسي، صحيح أنه يعيش حضارة مادية شامخة لكنه يعيش حالة من القلق، ويعيش ظاهرة من الكآبة وعقداً من الحزن، ويعيش أمراضاً نفسية قاتلة، إذن الحضارة المادية لم توفر له مبدأ أساسياً في الحياة ألا وهو مبدأ الأمن النفسي.
الدين يدعو إلى حضارة مادية ولكن حضارة مادية قائمة على مبدأ الأمن النفسي، لاحظ القرآن كيف يركز على مبدأ النفسي ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: 28]، فالعبادة ليست فقط تحصيل على الثواب وتسقيط للعقاب، العبادة تعالج القلق النفسي، وشيوع العبادة في المجتمع سبب أساسي لتوفير الأمن النفسي، لذلك القرآن الكريم يقول في وصف المجتمع الإسلامي الكامل ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 55]
المبدأ الثاني: مبدأ الأخوة.
عندما تقرأ بالمجهر الحياة الغربية ترى فيها الجمعيات الخيرية وفيها مساعدات للفقراء والمحتاجين لكنها مع ذلك تفتقد لمبدأ الأخوة، ومبدأ الأخوة يعني أن يتبانى المجتمع بأسره على قيم المحبة والتعاون والإحسان والتواضع، وأن يعيش المجتمع هذه القيم، وإذا لم يعش هذه القيم فَقَدْ فَقَدَ مبدأ الأخوة، وهو مبدأ أساس لأي حضارة تقوم على الأرض، قالت فاطمة الزهراء  وهي تخاطب القوم: «كُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ، مُذْقَةَ الشّارِبِ، وَنُهْزَةَ الطّامِعِ، وَقُبْسَةَ الْعَجْلانِ، وَمَوْطِئَ الأقْدامِ، تَشْرَبُونَ الطّرْقَ، وَتَقْتاتُونَ الْوَرَقَ، أذِلَّةً خاسِئِينَ، ﴿تَخافُونَ أنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِكُمْ﴾، فَأنْقَذَكُمُ اللهُ تَبارَكَ وَتَعالى بِمُحَمَّدٍ صَلى الله عليه وآله بَعْدَ اللّتَيّا وَالَّتِي»
وهي تخاطب القوم: «كُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ، مُذْقَةَ الشّارِبِ، وَنُهْزَةَ الطّامِعِ، وَقُبْسَةَ الْعَجْلانِ، وَمَوْطِئَ الأقْدامِ، تَشْرَبُونَ الطّرْقَ، وَتَقْتاتُونَ الْوَرَقَ، أذِلَّةً خاسِئِينَ، ﴿تَخافُونَ أنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِكُمْ﴾، فَأنْقَذَكُمُ اللهُ تَبارَكَ وَتَعالى بِمُحَمَّدٍ صَلى الله عليه وآله بَعْدَ اللّتَيّا وَالَّتِي»
وهذا ما ركز عليه القرآن الكريم ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ [آل عمران: 103]، تحولتم بفضله من مجتمع متقاتل إلى مجتمع متآخي، آخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بينه وبين علي بن أبي طالب  ، إذن الرؤية الإسلامية أيضاً تدعو إلى الحضارة ولكن حضارة قائمة على الأمن النفسي وعلى مبدأ الأخوة، فالإنسان ليس مجرد آلة ميكانيكية، في الغرب ترى الكثير منهم من يتعب ويكدح من الصبح إلى آخر الليل على ماذا؟ من أجل جمع الثروة فيصبح الإنسان آلة ميكانيكية لبناء الحضارة فقط، كل حضارة تفتقد لمبدأ الأخوة يصبح الإنسان فيها أداة ميكانيكية لا أكثر من ذلك، فيفقد طعم الإنسانية.
، إذن الرؤية الإسلامية أيضاً تدعو إلى الحضارة ولكن حضارة قائمة على الأمن النفسي وعلى مبدأ الأخوة، فالإنسان ليس مجرد آلة ميكانيكية، في الغرب ترى الكثير منهم من يتعب ويكدح من الصبح إلى آخر الليل على ماذا؟ من أجل جمع الثروة فيصبح الإنسان آلة ميكانيكية لبناء الحضارة فقط، كل حضارة تفتقد لمبدأ الأخوة يصبح الإنسان فيها أداة ميكانيكية لا أكثر من ذلك، فيفقد طعم الإنسانية.
إذن الدين يدعو إلى إقامة حضارة قائمة على مبدأين الأمن النفسي والأخوة، فإذا ارتكب إنسان جريمة فقد حصلت أخطار ثلاثة: الخطر الأول أنه أخل باستقرار الحضارة المادية، والخطر الثاني أخل بالأمن النفسي ففقد المجتمع الشعور بالأمن النفسي، والخطر الثالث أنه هدم مبدأ الأخوة، لأنه لو كان يعيش مبدأ الأخوة لم يرتكب جريمة في حق إخوانه من نفس المجتمع، إذن بالنتيجة من يرتكب الجريمة فقد أخل وأحدث أخطار ثلاثة لا خطر واحد، ومن هنا جاءت فلسفة العقوبة في النظام الإسلامي، إنما يعاقب المذنب من أجل إيقاع التوازن وإعادته، ومن أجل درء الأخطار الثلاثة التي حصلت نتيجة ارتكاب هذا الذنب.
قد يقول أحدهم أين الرحمة؟ صحيح أنه مرتكب للجريمة ولكن مقتضى الرحمة أن نرأف به ونجعله يبقى.
نقول له أن المسألة هكذا مثلما لو كان لأحدهم مرض خبيث في قطعة من جسمه، ويتمركز فيها المرض الخبيث، فهل يكون مقتضى الرحمة أن يبقى مع عضوة المريض من أجل الرحمة والرأفة حتى لا يشعر بالألم والإعاقة، أم يقال الرحمة هي اجتثاث المرض الخبيث باجتثاث الموضع الذي يعيش فيه هذا المرض! وفي هذا القول هو مقتضى الرحمة، نفس القضية من يرتكب جريمة عن إصرار وعمد فهو عضو من هذا الجسم الاجتماعي العام، ومقتضى الرحمة أن تحافظ على صحة الجسم الاجتماعي العام ولو باجتثاث العضو الذي يحمل هذا المرض المعدي.
المنطلق الثالث: المنطلق الإنساني.
التشريع الإسلامي عندما قنن العقوبة وشرع العقوبة لاحظ أمرين:
1» الأمر الأول: ليست عقوبة الإعدام التي هي عقوبة القتل عقوبة قسرية، أي ليست حتمية بل هي عقوبة مرنة في الشريعة فالخيار يكون بيد ولي الدم يعفو أو يقتص.
أراد الدين أن يحفظ قيمتين: قيمة العدالة، وقيمة العفو والتسامح، فولي الدم إن طالب بالقصاص فهو يريد قيمة العدالة، وإن عفا فقد حقق قيمة أخلاقية عظيمة ألا وهي قيمة العفو والتسامح، والنتيجة سوف يحصل على إحدى القيمتين، فعندما يقول الإسلام لولي الدم الخيار يعفو أم يقتص يريد من جهة أن يؤسس لقيمة العدالة فجعل لولي الدم حق القصاص، ومن جهة أخرى أن يؤسس لقيمة العفو والصفح، والقرآن يدعو للعفو والصفح ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التغابن: 14]؛ أي أن العفو والصفح مطلوب في حد ذاته وإن كان ليس طلباً إلزامياً، إذن جعل عقوبة القصاص عقوبة مرنة ليضمن هاتين القيمتين قيمة العفو وقيمة العدالة.
2» الأمر الثاني: ليس كل من قَتَل حده القتل، إذا قتل عن إصرار وعمد نعم، أما إذا افترضنا أنه قتل وهو ضعيف الإرادة إما لقصور عقلي أو لمرض نفسي فهذا لا يعتبر قتل عن عمد وقتل عن إصرار، ومثل هذا الإنسان جدير بأن يؤهل وبأن يبرمج من جديد، وبأن تعاد له صحته وسلامته وإنسانيته، وهذا يشمله الإطلاق القرآني ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70].
الرسول الأعظم  عندما عرض عليه بنو ضبة؛ الذين كما ذكرنا خرجوا إلى بيت المال، فسرقوا، ثم قتلوا العمال القائمين على بيت المال وهربوا، فبعث الرسول إليهم أمير المؤمنين فأسرهم وأحضرهم بين يدي رسول الله، والرسول اتخذ القرار الحاسم فيهم ألا وهو القتل، فقُتِلوا، أين المشكلة في الموضوع وأين الروح الدموية التي يذكرها بعض المستشرقين؟
عندما عرض عليه بنو ضبة؛ الذين كما ذكرنا خرجوا إلى بيت المال، فسرقوا، ثم قتلوا العمال القائمين على بيت المال وهربوا، فبعث الرسول إليهم أمير المؤمنين فأسرهم وأحضرهم بين يدي رسول الله، والرسول اتخذ القرار الحاسم فيهم ألا وهو القتل، فقُتِلوا، أين المشكلة في الموضوع وأين الروح الدموية التي يذكرها بعض المستشرقين؟
الرسول الأعظم  انطلاقاً من الآية المباركة التي افتتحنا بها ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: 33] اِرْجع إلى روايات أهل البيت كصحيحة محمد بن مسلم، ورواية جراح المدائني، ذكر فيها تفصيل للآية متى تكون العقوبة القتل، ومتى تكون العقوبة قطع الأيدي، ومتى تكون العقوبة نفي من الأرض، لأن نوع العقوبة ليس فيها تخيير، بل كل فرد من العقوبة يقابله نوع من الجريمة، والرسول الأعظم
انطلاقاً من الآية المباركة التي افتتحنا بها ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: 33] اِرْجع إلى روايات أهل البيت كصحيحة محمد بن مسلم، ورواية جراح المدائني، ذكر فيها تفصيل للآية متى تكون العقوبة القتل، ومتى تكون العقوبة قطع الأيدي، ومتى تكون العقوبة نفي من الأرض، لأن نوع العقوبة ليس فيها تخيير، بل كل فرد من العقوبة يقابله نوع من الجريمة، والرسول الأعظم  انطلاقا من الآية قرر قتل هؤلاء فقُتِلوا، ومنطلق النبي
انطلاقا من الآية قرر قتل هؤلاء فقُتِلوا، ومنطلق النبي  في قيامه بهذا القرار هو منطلق الإصلاح.
في قيامه بهذا القرار هو منطلق الإصلاح.
قالت الآية ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ﴾ لماذا ذُكِرت كلمة الأرض، فأي حدث سوف يحصل أو فساد فسوف يكون على الأرض بالطبع؟
هناك نكتة لذكر كلمة الأرض، ليست النسبة بين الأرض وبين الفساد نسبة الظرف للمظروف، بل نسبة المُتعَلَّق للمُتعَلِّق؛ الآية لا تقصد الفساد في الأرض بل تقصد إفساد الأرض نفسها أي تحويل الأرض إلى أرض فساد.
نلاحظ الآيات القرآنية الأخرى عندما يقول تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ [الأعراف: 85]، فالفساد في الأرض يقابله إصلاح الأرض، فهناك من يصلح الأرض يزرعها، يبني فيها، يستخرج كنوزها هذا يسمى إصلاح، وهناك من يفسد الأرض أي يقتل الحياة على الأرض.
أو عندما يقول تبارك وتعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ «204» وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ «205»﴾ [البقرة: 204 - 205]، الفساد في الأرض بمعنى قتل الحياة على الأرض، وليس معنى الفساد في الأرض هو ارتكاب المعصية، قتل الإنسان هو فساد في الأرض والإنسان طاقة أرضية، قتل المعادن، قتل الزراعة، هو إفساد في الأرض؛ لأنه قَتَلَ منابع الحياة في الأرض.
لذلك الآية لا تعم أي جريمة بل تتكلم عن جريمة معينة، وهي الجريمة التي تعد قتلاً للحياة على الأرض، وقتلاً لمرافق الحياة على الأرض، وهذا ما طبقه النبي الأعظم محمد  انطلاقاً من مسيرة الإصلاح؛ إصلاح الأرض، وانطلاقاً من مواجهة جريمة إفساد الأرض وقتل الحياة عليها رأى أن حفظ الحياة حياة الأرض وحياة من فيها يقتضي أن يمارس عقوبة القتل لمن أفسد الحياة، وقتل الحياة.
انطلاقاً من مسيرة الإصلاح؛ إصلاح الأرض، وانطلاقاً من مواجهة جريمة إفساد الأرض وقتل الحياة عليها رأى أن حفظ الحياة حياة الأرض وحياة من فيها يقتضي أن يمارس عقوبة القتل لمن أفسد الحياة، وقتل الحياة.
من هذا المنطق منطق الإصلاح اتجه رسول الله، ومن نفس المنطق منطق الإصلاح حارب الإمام علي  الخوارج، ومن منطق الإصلاح صالح الإمام الحسن
الخوارج، ومن منطق الإصلاح صالح الإمام الحسن  معاوية، وقال: إن الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية هو حق لي تركته لإصلاح أمر الأمة وحقن دمائها. المنطق واحد وإن اختلفت صوره وألوانه، الهدف واحد والادوار متعددة.
معاوية، وقال: إن الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية هو حق لي تركته لإصلاح أمر الأمة وحقن دمائها. المنطق واحد وإن اختلفت صوره وألوانه، الهدف واحد والادوار متعددة.
ومن نفس المنطق ومن نفس المبدأ سار الحسين بن علي  ، قال: «إِنّى لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَلا بَطَرًا، وَلا مُفْسِدًا وَلا ظالِمًا، وَإِنَّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ الإصْلاحِ في أُمَّةِ جَدّي، أُريدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَسيرَ بِسيرَةِ جَدّي وَأَبي عَلِيّ بْنِ أَبي طالِب، فمَن قَبلني بقبول الحقّ؛ فالله أوْلى بالحقّ»
، قال: «إِنّى لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَلا بَطَرًا، وَلا مُفْسِدًا وَلا ظالِمًا، وَإِنَّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ الإصْلاحِ في أُمَّةِ جَدّي، أُريدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَسيرَ بِسيرَةِ جَدّي وَأَبي عَلِيّ بْنِ أَبي طالِب، فمَن قَبلني بقبول الحقّ؛ فالله أوْلى بالحقّ»
لذلك أصبح الحسين رمزاً للإصلاح، وأصبح عبيد الله بن زياد رمزاً للإفساد، ومسلم بن عقيل ميز بين الرمزين عندما أدخلوه على عبيد الله بن زياد، وقالوا له: سلم على الأمير بالإمارة. قال: ما هو لي بأمير أميري حسين ونعم الأمير.