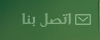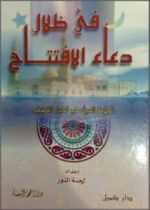الدرس 11 | حوار مع الفيلسوف هيوم حول مبدأ العلية
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
ذكرنا فيما سبق أن هناك اتجاهين:
- الاتجاه التجريبي: وهو الاتجاه الذي من رواده «جون لوك».
- الاتجاه الحسّي: وهو الاتجاه الذي من رواده «دڤيد هيوم».
ما سبق كان عبارة عن تسجيل ملاحظات على الاتجاه التجريبي، والملاحظة الأخيرة كانت هي أن جون لوك ذكرَ أن الجوهر مفهوم ضبابي، وأن الجوهر لا يُمْكن أن يَنْطَبِقَ على المفاهيم المتباينة نحو «الله» و«الجسم» و«الروح»، ولكن ما ذُكر غير تام وذلك:
أولا: أن مفهوم الجوهر واضح وهو عبارة عن «ما لا يحتاج في وجوده إلى الموضوع»، وهو كتعريف الجسم بأنه «ما يشغل حيزا من الفراغ»، وهو مفهوم واضح ولا ضبابية فيه.
ثانيا: أن الجوهر قسم من الماهية، بمعنى أن الماهية تنقسم إلى جوهر وعرض، فالتمثيل بالله «تبارك وتعالى» خطأ لأن الله ليس له ماهية، فالجوهر والعرض قسمان للماهية فلا يدخل فيه الوجود الإلهي، لأن الماهية هي المفهوم المنتزع من الوجود الإمكاني المحدود، وما ليس له وجود محدود فليس له ماهية، والله ليس له وجود محدود، إذن ليس له ماهية، وبما أنه ليس له ماهية فهو لا يدخل تحت التقسيم إلى جوهر وعرض.
وهذا ما تبقى مما مضى، الآن ندخل في الاتجاه الحسّي، وهذا الاتجاه يتزعمه الفيلسوف الاسكوتلندي دڤيد هيوم الذي كان يعيش في القرن الثامن عشر، وحديثنا حول مدخل ومحاور.
المدخل: تحليل نظرية هيوم.
هذا المدخل ملخص من كتاب «الفاهمة البشرية» لدڤيد هيوم نفسه بترجمة موسى وهبه، وقد تعرض في هذا الكتاب إلى عدّة نقاط:
النقطة الأولى: في تقسيم الادراك إلى أفكار وانطباعات.
هناك أفكار وهناك انطباعات، فكل صورة يُدركها الإنسان حين الاحساس بها فهي أفكار، فمثلا أنا أدرك الحرارة حين الإحساس بالحرارة، أو أدرك الضوء حين الإحساس بالضوء، فإدراك الذهن للأشياء حين الاتصال الحسي بها أفكار، وأما إذا أراد أن يستذكر صورتها - أي بعد رؤية صورة معينة - فإن استذكار الصورة يُعبر عنه بالانطباعات.
النقطة الثانية: في حدود الفكر.
يقول دڤيد هيوم: ”الفكر أكثر الأشياء حريّة، فهو المتحرر من أي سلطة مادية أو فكرية“ فالإنسان يُفكر كما يشاء، ”ومتحرر من حدود الطبيعة أيضا“ لأن الفكر يستطيع أن يتصور أبعد نقطة في عالم الطبيعة، بل يستطيع الفكر أن يتصور ما وراء الطبيعة أيضا، وما وراء المادة أيضا مما يشهد لحريته وعدم خضوعه للحدود المادية، ولكن مع أن الفكر متحرر من عالم المادة فإنه مع ذلك محدود، وهو يقول: ”الفكر محدود في التركيب والنقص والزيادة والنقل وكل ذلك في إطار ما يصل إلى الحس، فما يصل الذهنَ من الحس هو الذي يستطيع أن يتصرف فيه الفكر بنقص بزيادة بحذف بإضافة وبتركيب وبتجزئة“ فإن كل هذه العمليات إنما يقوم بها الفكر في خصوص ما يصله عن طريق الحس، أما شيء من غير الحس لا يستطيع أن يناله بمثل هذه التصرفات.
ما هو الدليل على أن الفكر محدود بعالم الحس والشعور؟ ذكر دليلين:
الدليل الأول: رجوع الأفكار المركبة إلى الأفكار البسيطة.
إن جميع الأفكار التي يتصورها الإنسان مهما بلغت من الوضوح يُمكن تحليلها وإعادتها إلى أفكار بسيطة، وتلك الأفكار البسيطة مصدرها إما الحس وإما الشعور، فهي إما أفكار يستوردها من حواسه كالضوء والصوت والصورة والرائحة، وإما يستوردها من مشاعره كالحب والبغض والفرح والحزن، فإن كل الأفكار سترجع إلى الأفكار البسيطة التي يستوردها الإنسان من الحس ومن الشعور حتى فكرة «الله»، ولربما يقول قائل كيف يقول أن الفكر يذهب لما وراء الطبيعة ومن جهة أخرى يقول أن الفكر محدود بما يستورده من الحس؟ نقول نعم، فإن فكرة الله هي عبارة عن أن الذهن يتصور العقل ويتصور الحكمة ويتصور الرحمة ثم يركب فيما بينهما فيجعل محلّا واحدا لها، فهو فيه عقل وفيه حكمة وفيه رحمة، ثم يتصور فكرة اللاحد، فإذا جمع بين العقل والرحمة والحكمة وأضاف إليها فكرة اللاحد - التي أخذها من الحد - فإنه من خلال الحس استورد فكرة الحد وانتزع منها فكرة اللاحد، فإذا جَمَعَ بين الصور الثلاث «العقل، والرحمة، والحكمة» واللاحد الذي انتزعه من الحد صور فكرة «الله»، فإذن بالنتيجة إنما نال الذهن ما وراء الطبيعة اعتمادا على صور بسيطة أخذها من عالم الحس أو عالم الشعور وهي فكرة العقل والرحمة والحكمة والحد.
الدليل الثاني: من فقد حسّا فقد الفكر الذي يأتيه من ذلك الحس.
الأعمى لن يستطيع أن يتصور الألوان، والأصم لن يستطيع أن يتصور الأنغام، والأناني لن يستطيع أن يشعر بلذة البذل والعطاء، واللطيف لن يشعر بحرارة القساوة والحدّة، إذن لدينا أفكار مختلفة وألوان مختلفة ولكن بالنتيجة مصدرها الحس، فإن من فقد حسّا فقد فكرا.
النقطة الثالثة: المناقشة للمدرسة الفطرية «مدرسة ديكارت».
ديكارت يقول أن هناك أفكاراً غُرزت في العقل من البداية بلا حاجة إلى الحس والمشاعر، وهو يناقش هذه المدرسة:
المناقشة الأولى: الضبابية والغموض تجعلها ليست من الأمور الوجدانية.
يقول: ”إن جميع الأفكار نُسخٌ من الانطباعات الحسيّة أو الوجدانية، وإذا كانت نُسخاً من الانطباعات الحسيّة أو الوجدانيّة فليس من السهل الوقوع في الخطأ في الأمور الوجدانية“ فالشيء الوجداني فإن الإنسان يشهده بالوجدان، وليس من السهل أن يقطع في الخطأ فيه، نعم يُمكن أن يُخطئ مما يستورده من الحس، أما أن يُخطئ فيما يشهده بالوجدان فإن هذا أمر صعب أن يُخطئ فيه وهو أمر يشهده بالوجدان، بناء على ذلك فإنه يقول: ”فإذا وُجد لفظ كثر استخدامه لدى الفلاسفة، ولكن هذه اللفظ لا يُمكن الركون إلى معنى له“ يعني له معاني متعددة، ومجمل بين معانية، وغامض بين معانية، فإن غموضه دليل على أنه ليس أمرا وجدانيا، ولو كان أمرا وجدانيا لما أخطأ الإنسان في شهوده وتصوره، فغموضه وتردد بين عدّة معاني يعني أنه ليس أمرا وجدانيا، ولذلك فهو معرّضٌ للخطأ، وهذا مثل الألفاظ التي يستعملها الميتافيزاقيون «ما وراء الطبيعة»، «الملك»، «الروح»، فإنه يقول أن هذه الكلمات لها ضبابية وهي غامضة المعاني، فلو كانت من الأمور الوجدانية لما تُصور فيها الغموض، ولما كانت معرضا للخطأ في تصورها، فهو يُريد أن يصل إلى كلمة الفطرة، حيث إن المدرسة العقلية ذهبت إلى أن هناك جملة من المفاهيم هي مفاهيم فطرية كالوجود والوحدة والكثرة، فهو يُريد أن يأخذ هذه الكلمة - كلمة الفطرة - فيقول أن مسألة الفطرية أمر غامض، فهل أن المراد من الفطرية هي الأمور الطبيعية - أي الأمور التي وُلدت مع الطبيعة - أم المراد من الأمور الفطرية التي وُلدت مع ولادة الإنسان، أم المراد من الأمور الفطرية هي التي يجزم الإنسان بها إذا تصورها؟! هذا كله دليل على أنها ليست فطرية، فإن نفس التردد في معنى الفطرية وغموضها دليل على أنها ليست أمورا وجدانية بحيث يؤمن بها الإنسان بمجرد أن يتصورها؛ لأن كلمة الفطرة ضبابية وغامضة.
المناقشة الثانية: عدم القدرة على الارجاع إلى انطباع معين.
كلما أردنا أن نُرجع كلمة «الله» إلى انطباع معين أو كلمة «الروح» إلى انطباع معين أو كلمة «الفطرة» إلى انطباع معين لا نستطيع أن نقف على معنى حاسم، وهذا يعني أنها لا تحمل معنى دقيقا يُركن إليه في البناء العلمي.
إذن بالنتيجة المناقشة للمدرسة الفطرية تتلخص في أن معنى الفطرية هو من جهة معنى غامض فلا يُمكن أن يُدعى أنه من الأمور الوجدانية، ومن جهة أخرى أننا كلما حاولنا أن نصل إلى معنى حاسم فيه لا نصل، وهذا دليل على أنه لا يحمل معنى دقيقا يتناسب مع كونه قاعدة علمية يُركن إليها.
النقطة الرابعة: تداعي المعاني.
تداعي المعاني موجود عند كل الفلاسفة وعلماء النفس، وهي ليست أمرا خاصا به، فيقول: ”إن تداعي الأفكار قائم بالوجدان حتى بين المنامات“ يعني - أحيانا - في النوم في الأحلام فكرة تستدعي فكرة وأنت في النوم فضلا عن عالم اليقظة، فحتى في النوم إذا رأيت صورة استدعت لها صورة أخرى، ”حتى بين المنامات التي يراها الإنسان، وأسباب تداعي الأفكار أربعة:“
- السبب الأول: ”التشابه كالتوأم“ أي إذا تصورت التوأم تصورت أخاه.
- السبب الثاني: ”التجاور في المكان والزمان“ تتصور كربلاء فتتصور الحسين، تتصور عاشوراء فتتصور تاسوعاء، للتجاور إما في الزمان وإما في المكان.
- السبب الثالث: ”التضاد“ فإذا تصورت النور تصورت الظلمة.
- السبب الرابع: ”التأثير“ فهناك أشياء تؤثر في أشياء، فمثلا إذا أحسست بالبرودة انتقل ذهني إلى حرارة الانفلونزا نتيجة أنني تصورت السبب فتصورت المسبب.
النقطة الخامسة [1] : إنكار السببية.
ليس هناك شيء اسمه سببية، فإنه يقول: ”إن البحث عن فكرة القدرة أو الاقتران الضروري بين شيئين عبث، فإننا مهما فحصنا في حالات الأجسام لم نجد سوى تتالي حادثتين من دون أن نكون قادرين على فهم أي قوة تجعل السبب «أ» قادرا على إيجاد مسبب وهو «ب»“، ونضرب مثالا لذلك وهو أننا عندما نلاحظ أن إنساناً ضربَ حجراً بحجر، فنتيجة ضربِ الحجر بحجر فإن الحجر الثاني ذهب إلى أعلى، يقول أننا لا نستطيع أن نحكم بسوى أنهما حادثتين متتالتين، فالأولى حادثة الحجر الضارب، والثانية حادثة الحجر المضروب، فلا نستطيع أن نحكم أن الحجر الأول سبب لإيجاد ارتفاع الحجر الثاني إلى الفضاء، فلا نستطيع أن نحكم بذلك أبدا، فلا نكون قادرين على فهم أي قوة تجعل السبب «أ» يعمل أو يقترن اقترانا ضروريا بالمسبب وهو «ب»، وهذا لا في الحس الخارجي ولا في الحس الداخلي، فمثلا في الأشياء الخارجية فعندنا نار وعندنا حرارة، فهو يقول لا نستطيع أن نقول أن النار سبب للحرارة الموجودة في الماء، فقط حادثتان الأولى اشتعال النار والثانية حرارة الماء، وهاتان حادثتان متعاقبتان، فلا نستطيع أن نحكم إلا بالتعاقب بين الحادثتين، أما أن الأولى سبب في الثانية فلا يُمكن، وكذلك بالنسبة للأمور الداخلية، فأنا في داخلي أجد أن عندي إرادة، وهذه الإرادة تبعث فيّ الحركة، فانا أريد أن أصلي، فإن إرادتي للصلاة بعثت فيَّ الحركة نحو الصلاة، فقد يقول قائل أن هناك سبب ومسبب، فالإرادة سبب والحركة مسبب، فنقول لا، إن هذا مجرد حادثتين داخليتين وهما إرادة وحركة، أما أن الإرادة سبب لتولد الحركة فإن هذا مما لا نستطيع أن نثبته، فإننا نعجز عن مشاهدة الرابط بينهما حتى نتصوره، بل كل الحوادث منفصلة وإن كان بيننا تتالي.
النقطة السادسة: عدم القدرة على التنبؤ.
وهذه النقطة متفرعة عن النقطة الخامسة، فقد قال: ”لا يُمكن التنبؤ“ يعني لو حصلت نار فإنه لا يمكن تنبأ وجود حرارة بعدها، ”لا يُمكن التنبؤ عند حصول الحادثة الأولى بحصول الحادثة الثانية، فلا يمكن التنبؤ عند حصول ما يُسمى ب «السبب» بحصول «المسبب»، بل لو حكمنا بالمسبب بشكل دائم - أي متى ما حصلت نار حصلت حرارة - فإن هذا تهور في الحكم، نعم قد يحصل اقتران بين حادثتين بشكل متكرر، كلما حصلت نار حصلت حرارة، كلما حصلت صورة الاصطدام بين كُرَتَي البليارد نرى دائما أنه إذا حصل ذلك فإنه يحصل هكذا أثر، فإن هذه حوادث تكررت، أي تعاقب الحادثتين قد تكرر في عدّة ظروف وأزمنة، حينئذ نعم متى ما تصورت الحادثة الأولى تصورت الحادثة الثانية، لكن الانتقال من الحادثة الأولى إلى الحادثة الثانية ليس على أساس مبدأ العلية بل على أساس تداعي المعاني، ففكرة العليّة في الواقع ترجع إلى فكرة تداعي المعاني، ولهذا قال:“ إلا أن ميل الذهن بفعل العادة لتوقع حادث عند حصول حادث آخر هو من الانتقال المعتاد عليه في المخيلة بحكم تداعي الأفكار، والنتيجة أنه مجرد الشعور لا أكثر من ذلك".
نكتفي بما ذكره في كتاب «الفاهمة البشرية» وننتقل إلى المناقشة التي ذكرها الأعلام لكلماته، وهنا عدّة محاور:
المحور الأول: ما هي حقيقة العليّة التي نناقش فيها «هيوم» وما هو سر الحاجة إلى العلة؟
في حقيقة العليّة يتعرض السيد الشهيد الصدر «قدس سره» [2] لشرح كلام الملا صدرا الشيرازي في حقيقة العليّة فيقول: ”هناك مجموعة من الارتباطات كارتباط الرسام باللوحة التي يرسم عليها، وارتباط الكاتب بالقلم الذي يكتب به، والقارئ بالكتاب الذي يقرأ فيه، ولكن كل هذه الارتباطات نراها تختلف عن ارتباط حركة اليد وحركة المفتاح“، إذا تحركت اليد تحرك المفتاح، فهذا الارتباط يختلف عن الارتباطات الأخرى، يختلف عن ارتباط الرسام باللوحة وارتباط الكاتب بالقلم والقارئ بالكتاب عن ارتباط حركة المفتاح بحركة اليد.
يقول في بيان ذلك ”إن لكل من الشيئين المرتبطين وجوداً سابقا على ارتباطه“ فمثلا بين اللوحة والرسام، فاللوحة له وجود، والرسام له وجود قبل أن يكون بينهما ارتباط، ”وجودا خاصا سابقا على ارتباطه، فاللوحة والرسام كلاهما موجود قبل أن توجد عملية الرسم، فالارتباط هنا علاقة تعرض للشيئين بصورة متأخرة عن وجودهما، ولذلك هما شيء والارتباط شيء زائد، بينما حركة اليد والمفتاح فإننا نجد أن حركة المفتاح ارتبطت بحركة اليد ارتباطا سببياً بمعنى أنه يوجد لدينا شيئان - حركة اليد وحركة المفتاح - فالأولى علّة والثانية معلول، وأما العلية التي بينهما فهي لون ارتباط أحدهما بالآخر، ولذا من المستحيل أن تمتلك حركة المفتاح وجوداً بصورة مستقلة عن ارتباطها بحركة اليد، فحركة المفتاح ليس لها وجود أسبق من ارتباطها بحركة اليد،“ ولا نحتاج إلى كثير من التأمل لنجيب بالنفي، فإن حركة المفتاح لو كان لها وجود حقيقي وراء الارتباط بسببها - وهو حركة اليد - لم تكن مسببة عنها؛ لأنه لو كانت موجودة بصورة مستقلة عن الارتباط لما احتاجت في الارتباط لحركة اليد؛ لأنها موجودة في رتبة سابقة، فالعليّة بطبيعتها تقتضي أن لا يكون للمعلول حقيقة وراء ارتباطه بعلته وإلا لم يكن معلولا ”، إذن معنى العليّة ليس هو تعاقب حادثتين، معنى العليّة أن المعلول عين الارتباط بالعلة كما يُعبر الفلاسفة أنه محض الارتباط لا شيء له الارتباط، فهو نفس الارتباط لا أنه شيء له الارتباط“ ومن هنا يتبين سر الحاجة إلى العلّة" فإنه يحتاج في أصل وجوده، فإن أصل وجود المعلول هو وجود منبثق مفاض من العلة، فوجود الحرارة عين الارتباط بوجود النار، وجود الضوء عين الارتباط بوجود الشمس وليس شيء وراء الارتباط، فحاجة المعلول إلى العلّة تكمن في صميم وجود المعلول لا يستغني عن العلّة.
المحور الثاني: في نقض نظرية هيوم الذي ادعى أن السببية مجرد توالي وتعاقب الحادثين.
تعرض له السيد الشهيد في كتاب فلسفتنا [3] وقال: "إن هيوم أرجع مبدأ العلية إلى تداعي المعاني فقال إن إحدى عمليات العقل إذا كانت تؤدي إلى عملية أخرى بدون تخلف فإنه ينمو بين العمليتين رابطة قوية تُسمى بتداعي المعاني، ويصبح هذا التداعي نوع من الإلزام العقلي، بحيث إذا تصور العقل الحادثة الأولى يُلزمه العقل بتصور الحادثة الثانية، ولكن مبدأ العلية لا يرجع إلى ذلك، وهنا ملاحظات ثلاث:
الملاحظة الأولى: لندع الظاهرتين المتعاقبتين في الخارج، فنغض النظر عن حركة اليد والمفتاح الموجودتين في الخارج ونذهب إلى عالم الذهن، فعندنا صورة لحركة اليد وعندنا صورة للنار، عندنا صورة للحرارة، فلو أننا جمدنا على الصور وجعلناها على الخارج، فهل العلاقة القائمة بين الصورتين علاقة ضرورية؟ كصورتين لا وجودين في الخارج، فهل بين صورة حركة اليد وصورة حركة المفتاح - كصورتين - بينهما علاقة ضرورية؟ أم أنهما فقط مقترنان كما يقترن تصورنا للحديد بتصور السوق التي يُباع فيها الحديد، فإن كانت بين الصورتين علاقة ضرورية بحيث صورة تُولد صورة فهذه هي العلية، فصارت أيضا عليّة ذهنية فكرية صورية، فقد ثبت مبدأ العلية الذي أنكره هو، فهو يُنكر مبدأ العلية ويقول أنه ليس هناك مبدأ علية، إلا أننا لو سألناه أن الصورتين اللتين هما من تداعي المعاني هل أن بينهما اقتران ضروري بحيث تولد صورةٌ صورةً؟ فإذا كان الجواب «نعم» فإن هذا إيمان بمبدأ العلية بين الصورتين مع أنه منكر له، وإذا كان الجواب «لا» لأن مبدأ العلية لا يمكن نيله بالحس ولا بالشعور، إذن بالنتيجة العلاقة بين الصورتين مجرد تقارن، وإذا كانت العلاقة بين الصورتين مجرد تقارن فقد الإلزام العقلي بينما نحن نرى أن بين صورة المعلول وصورة العلة يوجد إلزام عقلي لا مجرد تقارن، فهنا لابد من الاختيار، فإما القول بأن بين الصورتين توجد ضرورة تولد إحداهما الأخرى فإن هذا إيمان مبدأ العلية، وإما القول بأنه لا يوجد ضرورة ولا تولد - فقط مقارنة - فإن هذا خلاف ما يشهد به الوجدان بين صورة العلة والمعلول من الإلزام العقلي عند تصور الأولى بتصور الثانية.
الملاحظة الثانية: قال: ”إن العلة والمعلول قد يكونان مقترنين ومع ذلك نُدرك علية أحدهما للآخر كحركة اليد وحركة المفتاح“، فحركة اليد وحركة المفتاح مقترنان زمانا، فبما أنهما مقترنان زمانا فكيف نُدخلهما تحت تداعي المعاني، لأن تداعي المعاني هو عبارة عن تتالي حادثتين بحسب الزمان، بينما هاتان مقترنتان بحسب الزمان، فلا يُتصور انفكاك بحسب الزمان بين حركة اليد وحركة المفتاح، فإذا المفتاح لم يتحرك المفتاح لا تتحرك اليد، وبمجرد أن تتحرك اليد ففي نفس الآن لا يتأخر عنه ولا ثانية واحدة يتحرك المفتاح، فهما حركتان متعاصرتان زمانا، فلو كان مرد الضرورة والعلية إلى استتباع إحدى العمليتين للأخرى بالتداعي لما أمكن في هذا المثال أن نعتبر حركة اليد علّة وحركة المفتاح معلولا لأنهما في زمن واحد، فما هو المرجح لأن تكون هذه العلة وهذا معلول؟ ما هو المرجح لأن تكون هذه الفكرة استدعت هذه الفكرة؟ فلماذا لا يكون الأمر بالعكس ما داما في زمن واحد؟ فهذا دليل على أن هناك شيء وراء تداعي المعاني وهو الإيمان الوجداني بمبدأ العلية، وإلا لولا الإيمان الوجداني بمبدأ العلية فإن هنا حادثتان في آن واحد وليس بينهما تعاقب حتى يُقال أن الذي صار في الدقيقة الأولى هي العلة والدقيقة الثانية هي المعلول، بل حدثتنا في زمن واحد، فما هو المرجح لأن تعتبر الأولى استدعت الثانية؟ لماذا لا يكون العكس؟ وهذا لأنك تؤمن بوجدانك أن هناك مبدأ وهو مبدأ العلية، وقد رأيت هذا المبدأ متجسدا في الحداثة الأولى فاعتبرتها أنها هي التي استدعت الثانية مع أنهما حدثا في زمان واحد.
الملاحظة الثالثة: إن التداعي كثيرا ما يحصل بين شيئين دون الاعتقاد بعلية أحدهما للآخر، فلو كان دڤيد هيوم يفسر العلة والمعلول بأنهما حادثنا نُدرك تعاقبهما كثيرا وأن الرابط بينهما من باب تداعي المعاني لكان الليل والنهار أيضا من العلة والمعلول، فما هو الفرق بين الليل والنهار وحركة اليد حركة المفتاح؟ من المؤكد أن هيوم يرى فرقا بينهما بالوجدان، فما هو الفرق الوجداني؟ فإن كلاهما متعاقبان، وكلاهما مقترنان، وكلاهما لا ينفك أحدهما عن الآخر، فلماذا تعتبر الليل والنهار ليس بينهما سببية وبينما بين حركة اليد والمفتاح توجد سببية والتي عبر عنها «استدعاء» وإن لم يكن بينهما عليّة واقعية إلا أن بينهما استدعاء، فما هو الفرق؟ فلو كان مجرد التتالي والتعاقب هو مفسر لعنوان السببية والعليّة من دون أي ارتباط واقعي بينهما لصح أن نقول بأن بين الليل والنهار سببية وعليّة، والحال أنه ليس بينهما ذلك.
المحور الثالث: في تحديد منشأ تصور العليّة في النظرية الصدرائية.
تعرض في أصول الفلسفة [4] إلى مناقشة دڤيد هيوم في منشأ تصور العلية، فقال: " لا إشكال أن في ذهننا - ذهن أي شخص - صورة للعلية، إنما هيوم فسرها تفسيراً أقرب وإلا الصورة موجودة، فنحن فسرنا العلية بالارتباط الوجودي، وقلنا أن معنى العلية هو أن يكون ارتباط المعلول بالعلة هو أصل وجوده، وهو أيضا يقول أن عندي في ذهني شيء إلا أنني أفسره فقط وفقط بتوالي الحادثين الذي يندرج تحت تداعي المعاني، فهو يرى صورة أن العلية في ذهنه لكنه يختلف معنا في التفسير، فمن أين جاء تصور العلية؟ فما دام الحس لا يوصلنا إلى العلية، فغاية ما نرى بالحس مجرد تعاقب الحادثتين، حدثت نار فحدثت حرارة، حدثت حركة يد فحدثت حركة مفتاح، حدث أن كرتي البليارد ضربت إحداهما الأخرى فانطلقت الأخرى لمكان آخر، فلا يرى الحس إلا تعاقب بين الحادثتين، إذن من أين جاء تصور العلية؟ والحال بأن تصور العليّة موجود بالوجدان، وهذا ما ذكره الشيخ الرئيس ابن سينا في «إلهيات الشفاء»، وعلق عليه الملا صدرا الشيرازي بأن الحس فعلا لا يوصل إلى مبدأ العلية، لأن الحس لا يُدرك إلا تعاقب الحادثين، وكذلك الشعور فتقول «شعرت بالخوف فشعرت بالحرارة» فالشعور لا يُدرك إلا تعاقب الحادثين، الخوف والحرارة، أما مبدأ العلية فلا يُدرك لا بالحس ولا بالشعور، إذن هذا التصور المنغرس في أذهاننا أن هذا سبب لهذا، وهذا استدعى هذا، وألزم العقل بهذه الصورة عند تصور هذه الصورة، فمن أين جاء؟ لم يطرح الاتجاه التجريبي ولا الحسي تفسيرا علميا مقنعا لمنشأ تصور العليّة، لكن بحسب النظرية الصدرائية يوجد ذلك.
بيان منشأ تصور العليّة عن النظرية الصدرائية:
وبيان ذلك بمقدمتين ونتيجة:
المقدمة الأولى: أن كل علم حصولي مسبوق بعلم حضوري.
فلا يمكن للذهن أن ينتزع صورة لشيء لم يصل إلى حقيقية ذلك الشيء، فإذا وصل لشيء بعلم حضوري انتزع عنه صورة بالعلم الحصولي.
المقدمة الثانية: إذا أدرك الإنسان نفسه بالعلم الحضوري «نفسي حاضرة» وأدرك الإنسان أفعال نفسه بالعلم الحضوري «النفس تفرح وتحزن وتريد وتكره»، فكما أدرك النفس بالعلم الحضوري أدرك أفعال النفس بالعلم الحضوري، وأدرك بعلم حضوري حاجة أفعال النفس للنفس، وأنه لولا النفس لم يكن لهذه الأفعال وجودٌ، بالشعور الوجداني أُدرك أن أفعال نفسي لولا نفسي لم تكن، وأن علاقتها بنفسي عين الارتباط لا شيء له الارتباط، فبناء على ذلك قد أدركت بالعلم الحضوري حقيقة العليّة، ولأنني أدركت حقيقة العلية انتزع الذهن مفهوما لمبدأ العلية وأصبح يعممه لكل حادثتين بينهما ترابط في جميع الظروف وفي جميع الأزمنة، فرأى الذهن بين حركة اليد وحركة المفتاح ترابط في جميع الظروف وفي جميع الأزمنة فطبّق مفهوم العليّة عليهما، ورأى بين الحرارة والنار علاقة ترابط في جميع الظروف وفي جميع الأزمنة فطبّق عليهما مفهوم العليّة، فمفهوم العليّة معلومة حصولية انتزعها الذهن من معلوم حضوري وهو شعور النفس بأن أفعالها عين الربط بها، فهذا هو منشأ تصور المبدأ العلية لا مجرد الحس، فالحس لا يستطيع الحكم إلا بتوالي الحادثتين لا أكثر من ذلك.
المحور الخامس[5] : النتائج.
ذكر السيد الشهيد «طاب ثراه» [6] أن هنا مجموعة نتائج - وهو بحث طويل -:
النتيجة الأولى: ”أن مبدأ العليّة مبدأ عقلي وجداني لا يُمكن إثباته بالحس؛ لأن الحس لا يكتسب صفةً موضوعية إلا على ضوء هذا المبدأ، فكيف يكون المبدأ مستنداً إلى الحس؟!“، ونزيد هذه النقطة بيانا، فمثلا الآن لو ذهبت إلى الطبيب، والطبيب فحص جسمي ووجد أن فيه حرارة، فالطبيب حالا يبحث عن السبب، فهو الآن لا يعلم عن هيوم وما قاله هيوم يصبح ليس له خصوصية، فيبحث عن سبب الحرارة، فهو يذهب إلى أن للحرارة سبب، أو أن التحليل أظهر أن الكلى لا تؤدي وظائفها فإنه حالا يذهب إلى السبب وراء ذلك، فلو سأل سائل الطبيب وقال له: أنت الآن تبحث عن سبب الحرارة، فأنت ثبّت أن هناك حرارة ومن ثم اذهب إلى سبب الحرارة، ولا يمكننا أن نثبت وجود أي شيء محسوس إلا عن طريق مبدأ العلية، فما لم نؤمن بمبدأ العلية لا نستطيع أن نُثبت أصل وجود الحس، فأصل وجود الحس لا يُمكن إثباته إلا على ضوء مبدأ العليّة، لأن أكثر ما ستقول «أحسست بالحرارة» فلو لم تؤمن أن وراء الإحساس سبب أثاره لما استطعت أن للحرارة وجودا، فأصل وجود المحسوسات لا يستطيع الإنسان أن يُثبته إلا إذا آمن بمبدأ العلية، فكيف يُثبت مبدأ العلية بالحس؟ فأنت الحس لا تستطيع أن تُثبته إلا مبدأ العلية فكيف تُثبت مبدأ العليّة بالحس؟ فإن هذا يكون استدلالا دوريا كما يقولون، وعبارة السيد الصدر هكذا ”إن مبدأ العلية مبدأ عقلي وجداني لا يُمكن إثباته بالحس؛ لأن الحس لا يكتسب صفة موضوعية - أي لا تستطيع إثبات وجوده - إلا على ضوء مبدأ العلية، فنحن نُثبت الواقع الموضوعي لأحاسيسنا استنادا لمبدأ العلية فليس من المعقول أن يكون هذا المبدأ مدينا للحس في ثبوته ومرتكزا عليه“.
النتيجة الثانية: إن مبدأ العليّة ليس نظرية تجريبية، يعني لا نستطيع أن نثبت مبدأ العلية عن طريق التجربة، وإنما هو قانون فلسفي عقلي وراء التجربة، فإن جميع النظريات العلمية تتوقف على مبدأ العلية، فأنت تقول «كل ماء يغلي إذا بلغت درجة حرارته 100°» فمن أي عرفت «كل» لو لم تؤمن بمبدأ العلية؟ فلو لم تؤمن بمبدأ العلية فإنه لا يمكن لأي تجربة أن تنجح، ولا يمكن لأي تجربة أن يعمم مضمونها لعالم الحياة، إذن كل التجارب انتاجها يتوقف على مبدأ العلية، فمن المستحيل أن نثبت مبدأ العلية بالتجربة نفسها، بل هو قانون وراء التجربة.
النتيجة الثالثة: إن مبدأ العلية لا يمكن الاستدلال له وعليه إلا بالعليّة، يعني حتى هيوم الذي أنكر مبدأ العلية فإنه لا يستطيع أن يُنكره إلا على ضوء مبدأ العليّة، بل الاستدلال لا يُعقل لو لم يكن هناك عليّة، فإن استدلاله مبتني على مبدأ العلية، السيد الصدر يقول: ”مبدأ العلية هو الركيزة التي تتوقف عليها كل الاستدلالات في جميع المجالات، لأن الاستدلال بالدليل على شيء يعني أن الدليل سبب للعلم بذلك الشيء“ يعني هناك سببية بين العلم بالدليل والعلم بالمدلول، ”فهو سبب للعلم بالشيء المستدل عليه، فنحن نُبرهن على أي حقيقة - سواء كانت تجريبية مثل غليان الماء، أو فلسفية مثل حدوث العالم أو شيء - بالدليل إذا كان بين الدليل وبين النتيجة سببية، وحتى الاستدلال على إنكار مبدأ العلية هو إيمان ضمني بمبدأ العلية“.
والحمد لله رب العالمين