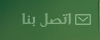القرآن بين الثابت والمتغير
1443-09-12
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين
ما زال الحديث حول الأدلة التي عُرضت لإثبات تاريخية القرآن الكريم، ووصل الكلام إلى:
الدليل الثالث:
وهو المعبر عنه بالتنجيم، حيث أن القرآن الكريم نزل نجوماً؛ أي نزل بشكل تدريجي حسب المناسبات والأحداث التي كانت تستجد في المجتمع المسلم آنذاك، وهنا ذكر حسن حنفي في كتابه «هموم الفكر والوطن» [1] أن نزول القرآن تنجيماً يعني تاريخية القرآن، لأنه يعني أن القرآن سياق مواكب للواقع الاجتماعي ومستند إليه ومستقى منه، فالقرآن تعليق على أحداث ومناسبات وقضايا مستجدة، وهذا مما يؤكد أن كل مضمون من مضامين القرآن مرتبط بحقبة زمنية معينة فلا شمولية في مضامينه لجميع الأزمنة والمجتمعات.
ويلاحظ على هذا الاستدلال أن القرآن وإن نزل نجوماً وبشكل تدريجي إلا أن هناك مبررات ودوافع منهجية وموضوعية اقتضت نزول القرآن بالنحو التدريجي:
المبرر الأول: تثبيت الفؤاد.
قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ [الفرقان: 32]، ومعنى تثبيت الفؤاد هو وصول النبي  في التعايش مع القرآن إلى أعلى درجات اليقين، من الواضح أن النبي
في التعايش مع القرآن إلى أعلى درجات اليقين، من الواضح أن النبي  كان يعلم بالقرآن وقد نزل عليه القرآن قبل نزوله بشكل تدريجي، نزل عليه دفعة واحدة كما هو ظاهر الآيات القرآنية، فظاهر قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: 1] أنه أنزل بكامله في ليلة القدر ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ [الشعراء: 193] أنه نزل بكامله على النبي
كان يعلم بالقرآن وقد نزل عليه القرآن قبل نزوله بشكل تدريجي، نزل عليه دفعة واحدة كما هو ظاهر الآيات القرآنية، فظاهر قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: 1] أنه أنزل بكامله في ليلة القدر ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ [الشعراء: 193] أنه نزل بكامله على النبي  ، وظاهر في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ [طه: 114] أن القرآن كان عنده وكان يؤمر بانتظار الأمر بإنزاله مرة أخرى، وقوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ «16» إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ «17» فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ «18» ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ «19»﴾ [القيامة: 16 - 19] أن النبي عالم بالقرآن ولكن من أجل وصول النبي
، وظاهر في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ [طه: 114] أن القرآن كان عنده وكان يؤمر بانتظار الأمر بإنزاله مرة أخرى، وقوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ «16» إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ «17» فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ «18» ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ «19»﴾ [القيامة: 16 - 19] أن النبي عالم بالقرآن ولكن من أجل وصول النبي  إلى أعلى درجات اليقين في التعايش مع القرآن وهو ما يُعبَّر عنه في كلمات الحكماء من درجة علم اليقين إلى درجة عين اليقين إلى درجة حق اليقين نزل القرآن عليه بشكل تدريجي فقال تبارك وتعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ [الفرقان: 32] أي لوصولك إلى درجة حق اليقين في التعايش مع القرآن الكريم.
إلى أعلى درجات اليقين في التعايش مع القرآن وهو ما يُعبَّر عنه في كلمات الحكماء من درجة علم اليقين إلى درجة عين اليقين إلى درجة حق اليقين نزل القرآن عليه بشكل تدريجي فقال تبارك وتعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ [الفرقان: 32] أي لوصولك إلى درجة حق اليقين في التعايش مع القرآن الكريم.
المبرر الثاني:
قوله تعالى: ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾ [الإسراء: 106] المجتمع الإسلامي حتى يستوعب القرآن ويكون مؤهلاً لتطبيقه في كل فقرة من فقراته لابد أن ينزل القرآن بشكل تدريجي، فإن نزوله دفعة واحدة ومن أول بداية الدعوة لا يكون مواكباً لمسيرة المسلمين اليومية والسنوية، وبالتالي يفقد المجتمع الإسلامي إلا من ندر القدرة على استيعاب مفاهيم القرآن وتطبيقه أولاً بأول بحسب ظروفه، وبحسب مناسبات نزوله، فنزوله التدريجي أبلغ أثراً في المسلمين من نزوله الدفعي في أول الدعوة المحمدية.
المبرر الثالث: الإعجاز.
أراد الله تبارك وتعالى أن يثبت أن من جملة وجوه الإعجاز في القرآن الكريم أنه ينزل لمدة 23 سنة ومع ذلك لا يختلف أسلوبه ولا تختلف نكاته، ولا يختلف أوله عن آخره وآخره عن وسطه، أراد أن يبين أنه نَفَسٌ واحد كماء واحد لا تختلف أبعاضه، فلأجل إثبات هذا الإعجاز اللغوي والأدبي في القرآن الكريم أنزله في مدة ثلاث وعشرين سنة ليبين أن هذا ليس كلام النبي، ولو كان كلام النبي لاختلف باختلاف الأزمنة واختلف باختلاف خبرة النبي وأتعابه وجهوده، ولكنه لأنه كلام الله عزوجل كان نَفَساً واحداً وأسلوباً واحداً، لذلك يقول تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 82] أي تفاوتاً بين مستوياته وبياناته لأنه لم ينزل في سنة واحدة وإنما نزل في ثلاث وعشرين سنة.
المبرر الرابع: الهدف التربوي.
تربية الأمة على مضامين القرآن تحتاج إلى أن يكون القرآن مواكباً للأمة في كل يوم وفي كل شهر وفي كل سنة لتشعر الأمة بعلاقتها مع الوحي، ومواكبة الوحي لها في كل خطوة وفي كل معركة وكل عمل، هذا مما يسهم بشكل أوضح في تحقيق الأهداف التربوية للقرآن ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا «45» وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا «46»﴾ [الأحزاب: 45 - 46] وقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107].
الدليل الرابع:
وهو أهم الأدلة كما ذكر حسن حنفي وغيره لإثبات تاريخية القرآن وعدم شموليته بحسب زعمه، قال: إن وجود النسخ في القرآن دليل على وجود الوحي في الزمان، وتغيره تبعاً لمدى الرقي الفردي والاجتماعي، فالوحي ليس ثابتاً بل الواقع يفرض نفسه على الوحي، والتطور ينسخ ثباته، ولا ثبات للتطور، ولا شمولية للقانون لأن الواقع يفرض نفسه على القانون، ثم يقول: ثم كيف نوفق بين النسخ وأزلية القرآن إذا كان القرآن الكريم يحكي عن نفسه ويقول: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ «21» فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ «22»﴾ [البروج: 21 - 22] أي كأنه أزلي، أو يقول: ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾ [الزخرف: 4] كيف نوفق بين أزلية الوحي التي تظهر في هذه الآيات المباركات وبين النسخ الذي ذكره القرآن نفسه في قوله تبارك وتعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106]
ومن أجل الإجابة المفصلة على هذا الاستدلال نرجع إلى ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في كتابه «البيان في تفسير القرآن» [2] في معالجة مسألة النسخ في القرآن، الإشكال أو الاستدلال الذي طرحه حسن حنفي لإثبات أن القرآن تاريخي وهو الاستناد إلى النسخ صاغه السيد الخوئي صياغة علميه متينة، قال: النسخ هو رفع الحكم الثابت عن موضوعه، الله تبارك وتعالى قال استقبلوا في صلواتكم بيت المقدس ثم رفع هذا الحكم وقال استقبلوا في صلواتكم الكعبة المشرفة، فالنسخ عبارة عن رفع الحكم الثابت لموضوعه وهو الصلاة، موضوعه هو الصلاة المستقبل بها القبلة، وهذا الموضوع كان حكمه الاتجاه لبيت المقدس وصار حكمه الاتجاه للبيت الحرام، يقول: رُفع الحكم الثابت لموضوعه إما مع بقاء الحال على ما هو عليه أي المصلحة التي اقتضت الحكم الأول ما زالت باقية وإما مع انتفاء المصلحة، فإن كانت المصلحة للاتجاه إلى بيت المقدس لا زالت موجودة فرفع الحكم ينافي الحكمة لأن المصلحة ما زالت تقتضي الاتجاه إلى بيت المقدس، وإما أن تكون المصلحة تزول لكن الله بدى له أي كان مشرعاً ولم يعلم أن المصلحة مؤقتة وتزول فشرَّع الحكم على سبيل الدوام والاستمرار ثم تبين له أن المصلحة مؤقتة وليست مصلحة دائمة فرفع الحكم، بدى له التوقيت وقد كان بانياً على الاستمرار، إذا كان كذلك كما هو في القوانين الوضعية والبشرية فهذا يستلزم الجهل عليه تبارك وتعالى.
وإذا قلتم لا هو من بادئ الأمر يعلم أن هذا الحكم مؤقت لأن المصلحة مؤقتة وليست دائمة إذن هذا يعني بطريقة واضحة أن الأحكام زمكانية، وأن مضامين القرآن تاريخية ولذلك خضع الحكم للتغيير والتبديل من قبله تبارك وتعالى، فالنسخ أدل وجه على تاريخية القرآن الكريم.
أولاً: لابد أن نعرف ما هو النسخ، النسخ هو بيان انتهاء أمد الحكم لانتهاء ملاكه أي انتهاء مصلحته، يقول السيد الخوئي[3] : الحكم على نوعين تارة حكم امتحاني كأمر إبراهيم بذبح ولده إسماعيل، وفي الواقع هو لم يكن يريده أن يذبحه بل أراد أن يختبر مقدار إرادته ومقدار مطواعيته للوحي، فالحكم كان حكماً امتحانياً ولم يكن حكماً حقيقياً، فإذا كان الحكم امتحانياً فهذا النسخ لا يلازم خلاف الحكمة إطلاقاً، لأن الامتحان يقتضي هدفاً معيناً في وقت معين، والهدف قد حصل عُرفت مقدار مطواعية إبراهيم فارتفع الأمر لأن الغرض منه الاختبار والامتحان وقد تحقق هذا الهدف.
وتارة يكون الحكم حقيقياً كاستقبال القبلة في البيت المقدس ثم نسخ وصار استقبال البيت الحرام حكم حقيقي ولم يكن حكماً امتحانياً.
يقول: معنى ذلك أن الحكم المجعول مقيد بزمن خاص من الأول، ومعلوم عند الله من الأول أنه مقيد بهذا الزمن الخاص، فلم يحصل لله بداء ولا تغير لعلمه من الأول بمقدار الحكم ومقدار أمده وأنه سيرفعه في الوقت المناسب لذلك، والنسخ بهذا المعنى ممكن، فلا محذور فيه وليس منافياً للحكمة أن يشرع الله حكماً لمصلحة مؤقتة، فبطبيعة الحال يكون الحكم مؤقتاً تم يبين للعباد انتهاء أمد الحكم لانتهاء مصلحته، فإن دخول خصوصيات الزمن في مناطات الأحكام مما لا يشك فيه عاقل، مثلاً يوم الجمعة في الإسلام يقتضي صلاة الجمعة وصلاة الجمعة لا تصح يوم السبت إذن معناه أن الزمان دخيل في مصلحة الحكم، صوم شهر رمضان لا يصح هذا الصوم في شهر آخر إلا لمن كان مريضاً أو مسافراً ومعناه أن الزمن دخيل في مصلحة الحكم ولذلك فُرض الصوم في هذا الشهر، يوم العيد له مستحبات معينة كصلاة العيد، وفيه وجبات كإخراج زكاة الفطرة فمعناه أن المصلحة مؤقتة ومرتبطة بزمن معين إذن الزمن لا إشكال في دخالته في بعض المصالح، الصلاة مؤقتة، الصيام مؤقت، الحج مؤقت، العيد مؤقت، الجمعة مؤقتة، كل ذلك يعني أن للزمن دخلاً في مصالح الأحكام وملاكاتها، فإذا شَرَّع الله حكماً لمصلحة زمنية مؤقتة ثم رفعه وهو من الأول يعلم بالمنسوخ والناسخ، وبالمصلحة المؤقتة والمصلحة الدائمة فلا منافاة في ذلك لحكمته، بل هو مطابق لحكمته أنه يسد كل المصالح، وهذا مقتضى حكمته تعالى وليس منافياً لحكمته، كما أنه لا يتنافى مع كون الأحكام أزلية لأن الله من الأزل يعلم بالمصالح المؤقتة والمصالح الدائمة وما تقتضيه الأولى وما تقتضيه الثانية.
ثانياً: دعوى أن القرآن أزلي فهل هو بأزلية الله؟ بالطبع لا، القرآن حادث، يقول القرآن الكريم: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأنبياء: 2] القرآن مجموعة قوانين أبدعها الله تبارك وتعالى، وإن كان أبدعها أولاً في اللوح المحفوظ ثم نزلت بألفاظ معينة على النبي  إلا أنه بالنتيجة ليس أزلياً بل هو مخلوق كسائر المخلوقات.
إلا أنه بالنتيجة ليس أزلياً بل هو مخلوق كسائر المخلوقات.
ثالثاً: وهي إجابة مفصلة من قبل السيد الخوئي قدس سره في كتاب البيان: ذكر السيد الخوئي أنه لا يوجد نسخ في القرآن، واستدلالهم بوقوع النسخ في القرآن على تاريخية القرآن هذا استدلال غير صحيح ومنتفٍ بانتفاء موضوعه، ويقول النسخ على ثلاثة أنواع: نسخ التلاوة دون الحكم، ونسخ التلاوة والحكم، ونسخ الحكم دون التلاوة.
- النوع الأول: نسخ التلاوة دون الحكم؛ ويعني أن الآية رُفعت لكن حكمها لا زال باقياً، وهذا ما تبناه بعض أهل السنة والجماعة، مثالٌ ذكره الإتقان للسيوطي قال: وآية الرجم كانت آية في القرآن ثم نُسخت وبقي حكمها «إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم».
- النوع الثاني: نسخ التلاوة والحكم؛ وهو ما روي عن عائشة أنها قالت كما ذكر في صحيح مسلم : «كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنه ثم نسخن بخمس معلومات ثم توفي الرسول» وهذه آية نُسخت تلاوة وحكماً.
السيد الخوئي قدس سره يقول: كل ذلك دعوى تحريف، وقول هذه آية نسخت تلاوة أي رفعت من القرآن، أو هذه آية نسخت تلاوة وحكماً فهذا مرجعه إلى القول بالتحريف الذي أجمع المسلمون على عدمه ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9].
- النوع الثالث: نسخ الحكم دون التلاوة؛ أي بقيت الآية في القرآن ولكن لا يعمل بها، لأن حكمها منسوخ، يقول السيد الخوئي هنا نتصور صورتين:
- الصورة الأولى: أن القرآن بنفسه يبين حكماً ونفس القرآن يبين أن ذاك الحكم الأول قد شرعته لمصلحة مؤقتة، والمصلحة المؤقتة حصلت أو شرعته لهدف والهدف تحقق فارتفع هذا الحكم.
- الصورة الثانية: يشرع حكماً في القرآن ثم يشرع حكماً آخر في القرآن من دون أن يبين أن الحكم الثاني ناسخ للحكم الأول، ولكن نحن في مقام الجمع نكتشف أن الثاني ناسخ للأول.
فإذا أتينا إلى الصورة الأولى أن القرآن بنفسه يبين أن الحكم السابق كان لهدف وتحقق الهدف نقول هذا قول صحيح ولكن ليس له إلا مثال واحد في القرآن كله، بين حكماً لهدف ثم بين أن الهدف من ذلك الحكم قد ارتفع، لاحظوا ما ذكره قدس سره للمثال الوحيد الذي ذُكر في القرآن وهو موضوع الصدقة عند نجوى الرسول ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المجادلة: 12] أراد الله أن ينظمهم ويهذب حوارهم مع النبي إلى أن تحقق الهدف، يقول كما في تفسير الطبري وغيره من المفسرين عن ابن جرير عن مجاهد قال: قال علي  : >آية من كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولم يعمل بها أحد بعدي، كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم فكنت إذا جئت إلى النبي تصدقت بدرهم وكلمته، ثم تصدقت وكلمته وهكذا، فنُسخت فلم يعمل بها أحد قبلي ولا بعدي< أي أن الآية نزلت لاختبار المسلمين من جهة وإظهار فضيلة للإمام علي
: >آية من كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولم يعمل بها أحد بعدي، كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم فكنت إذا جئت إلى النبي تصدقت بدرهم وكلمته، ثم تصدقت وكلمته وهكذا، فنُسخت فلم يعمل بها أحد قبلي ولا بعدي< أي أن الآية نزلت لاختبار المسلمين من جهة وإظهار فضيلة للإمام علي  من جهة، ولما تحقق الهدف قال تبارك وتعالى: ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المجادلة: 13] وفي الواقع هذا ليس نسخ وإنما هو حكم امتحاني لمعرفة من يطبق ومن لا يطبق، جاءت الآية الثانية وقالت أن الهدف قد تحقق من الأمر في الآية الأولى فانتفى الموضوع، وهذه هي الآية الوحيدة والحكم الوحيد في القرآن الذي شُرِّع لهدف ثم رفع.
من جهة، ولما تحقق الهدف قال تبارك وتعالى: ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المجادلة: 13] وفي الواقع هذا ليس نسخ وإنما هو حكم امتحاني لمعرفة من يطبق ومن لا يطبق، جاءت الآية الثانية وقالت أن الهدف قد تحقق من الأمر في الآية الأولى فانتفى الموضوع، وهذه هي الآية الوحيدة والحكم الوحيد في القرآن الذي شُرِّع لهدف ثم رفع.
وأما الصورة الثانية أنه يوجد حكمان في القرآن أحدهما ينسخ الآخر من دون بيان من نفس القرآن يقول السيد الخوئي هذا غير موجود وهو ما ذكره في كتابه[4] في ما يقارب مئة صفحة استوعب فيها السيد الخوئي قدس سره كل الآيات التي يُدَّعى أن فيها نسخ وأثبت أنها ليست من باب النسخ في شيء إطلاقاً.
المثال الأول: الذي ذكره ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: 109] قالوا أن هذه الآية منسوخة بآية أخرى وهي ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: 29] فالآية الثانية ناسخة للأولى مع أنه لم يبين ذلك ولكن ما دامت هذه نزلت أولاً ثم نزلت هذه ثانياً وهي منافية لها فهي ناسخة لها، وهذا يعني تاريخية القرآن.
الجواب: يقول السيد الخوئي أن الموضوع مختلف لأنه قال في نفس الآية الأولى ﴿حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ أي أعطى غاية؛ اعفوا واصفحوا إلى أن يأتي الله بأمره، وإذا جاء أمر الله سيختلف الدور، قال: ذكر غاية حتى يأتي الله بأمره، ثم لما جاء الأمر تغير الموضوع وحاصل معنى الآية الأمر بالعفو والصفح عن أهل الكتاب حتى يفعل الله ما يشاء في خلقه من عز الإسلام وتقوية شوكته ودخول كثير من الكفار في الإسلام وإهلاك كثير منهم، حتى ينتصر الإسلام وتقوى شوكته وتكون له عزة حينئذ سيختلف الدور وستؤمرون بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فالاختلاف بين الآيتين لأجل اختلاف الموضوع وليس من باب النسخ في شيء.
المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 115] ثم نسخت هذه الآية فقال: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 144]
الجواب: يقول السيد الخوئي هذا غير صحيح، الصحيح أن الآية الكريمة كانت تدل على أن الله لا يحيط به مكان وليس لها علاقة بالصلاة والقبلة في الصلاة، فأينما توجه المكلف فقد توجه إلى الله عزوجل في دعائه وعباداته وجميع أموره، ولذلك استدل أهل البيت الأئمة بهذه الآية المباركة على الرخصة للمسافر في النافلة كما استدل بها على صحة سجود التلاوة... إلى آخر موارد الاستدلال بهذه الآية المباركة.
فتبين بذلك أن الاستدلال بالنسخ على تاريخية القرآن استدلال عقيم وليس استدلالاً تاماً.
الدليل الخامس:
ما ذكره نصر حامد أبو زيد في كتابه «مفهوم النص» أن الآيات المكية تختلف في الأسلوب عن الآيات المدينة، الآيات المكية قصار والآيات المدنية طوال، الآيات المكية ليس فيها شدة بل فيها لين بينما الآيات المدنية فيها حدة وعنف، الآيات المكية الملاحظ أنها تداري الطرف الآخر والآيات المدنية لا تداري الطرف الآخر، وهذا يعني أن القرآن تاريخي ولذلك تغير أسلوبه بتغير البيئة وتغير الزمن، ويتغير مضمونه بتغير الموضوع وبتغير الزمن مما يكشف عن أن القرآن تاريخي وليس ثابتاً ولا شمولياً، بل عبَّر نصر حامد أبو زيد بقوله: القرآن منتج ثقافي، والمنتج الثقافي يختلف باختلاف البيئة ويختلف باختلاف الزمن.
أولاً: هناك فرق بين أمرين بين أن تفرض البيئة نفسها على الوحي وبين أن تفرض الأهداف نفسها على الوحي، هل البيئة المكية فرضت نفسها على الوحي فأصبح الوحي مكي ثم فرضت البيئة المدنية نفسها على الوحي فأصبح الوحي مدنياً، أم أن أهداف القرآن هي التي فرضت أن يتغير أسلوب القرآن باختلاف البيئة، بعبارة أخرى أهداف القرآن فرضت أن يستثمر القرآن كل بيئة يكون فيها من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، ففرق بين أن تفرض البيئة نفسها على الوحي وبين أن تفرض أهداف الوحي نفسها على البيئة بحيث يستثمر القرآن كل بيئة بأسلوب معين وبمضمون معين.
ثانياً: اختلاف الموضوعات يقتضي اختلاف الأسلوب، تارة القرآن يتحدث عن قصة تاريخية فلابد أن يختار أسلوباً قصصي، وتارة يتحدث القرآن عن الآخرة فيختار أسلوب الوعد والوعيد، وتارة يتحدث عن إثارات فكرية التأمل في السماوات والأرضين إذن سيختار أسلوب مشوق للإثارة الفكرية، فاختلاف الموضوعات يقتضي اختلاف الأساليب كان في مكة أو في المدينة، تتغير السورة الواحدة لعدة أساليب نتيجة اختلاف الموضوعات، وهذا هو فن المخاطبة وفن التأثير، وهذا هو أحد أدلة الإعجاز في القرآن الكريم، لا أن المسألة تختلف باختلاف البيئة بل كل موضوع يحتاج إلى أسلوب ينسجم معه، ولذلك يقول بعض الباحثين بأنه لو فرضنا معلم هو مدرس فيزياء وهو مدرس تاريخ وله مهارة في كلا الفنين، هل سيختار نفس الأسلوب الذي يُدرِّس به الفيزياء في تدريس التاريخ؟ بالطبع لا، المدرس واحد والقدرة واحدة والمخاطبين هم نفسهم ولكن لأن المدرِّس ذو حكمة وخبرة وفن فهو يغير أسلوبه باختلاف المخاطبين بهذا الأسلوب، وهذا لا يعني أن ذاك متقوقع في بيئة وهذا متقوقع في بيئة، الهدف وهو تربية الطلاب فرض نفسه واقتضى أن يستغل المدرس كل موضوع لإثارة أسلوب معين.
ولذلك لمّا كان الهدف في الآيات المكية ترسيخ التوحيد وترسيخ الأخلاق وترسيخ الإيمان بالآخرة وهذه كانت الأهداف في فترة الوحي المكي لذلك جاءت الآيات قصار وكان الأسلوب المكي هو أسلوب تنبيه على الوحدانية وعلى الأخلاق واليوم الموعود، ولكن لما انتقل إلى المدينة وتحول إلى دولة والدولة تحتاج إلى قوانين هنا تغير الأسلوب وصار أسلوب التقنين والتشريع واقتضى آيات طوال تستوعب القانون بتمام جهاته وحذافيره، فاختلف الأسلوب لاختلاف الهدف الذي يراد معالجته.
ثالثاً: دعوى أن المكي لين والمدني شديد فهذه الدعوى مما لا صحة لها، بعض الآيات المدنية أيضاً فيها لين وشدة وبعض الآيات المكية فيها لين وشدة، لاحظ قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: 53] هذه آية مدنية وكلها لين، ثم يعقبها بآية أخرى ويقول: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾ [الزمر: 54].
ويقول في الآية المكية: ﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ «49» وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ «50»﴾ [الحجر: 49 - 50]
إذن فبالنتيجة الاستدلال على تاريخية القرآن باختلاف المكي والمدني أسلوباً أو مضموناً استدلال ضعيف.
فتبين لنا بعد عرض الأدلة المختلفة للقائلين بتاريخية القرآن عدم تماميتها وإذا رجعنا إلى ما ذكرناه في أول المحاضرات من حاجة المجتمع البشري إلى النظام الذي يوفق بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع وأن يكون نظاماً ثابتاً فلابد أن يكون القرآن المعبر عن الوحي نظاماً ثابتاً صالحاً لجميع المجتمعات والأزمنة حتى يحقق علاج وتلبية حاجة المجتمع البشري إلى النظام الثابت وبالتالي لا مجال لدعوى تاريخية القرآن الكريم.