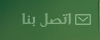قداسة النص القرآني

عندما ظهرت مدرسة الحداثة وتمكنت من كسب مجموعة من الأتباع والمؤيدين أخذت تترك بصماتها علي العديد من جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية والدينية، وعندما وصلت رياح هذا الفكر الجديد الوافد من وراء البحار إلى بلداننا تلقفته فئة من المثقفين وانبهرت به وحاولت تطبيقه علي مختلف مجالات الفكر الإسلامي باعتباره آخر وأفضل ما توصلت إليه جهود البشرية الرامية إلى تحديث الفكر الإنساني، ونقله إلى مرحلة جديدة من تاريخه تختلف تماما عن المراحل السابقة المتسمة بالجزمية والقطعية وإقصاء الآخر، ومن أهم التطبيقات التي اهتم بعض الحداثيين بتفعيلها في الساحة الإسلامية، بعض الرؤى التي تمس القرآن الكريم، فقد تم التأكيد على فكرتين:
الأولى: إنكار أي مصدر سماوي وغيبي للنص القرآني.
والأخرى: التأكيد علي تاريخية هذا النص.
ونحاول في هذه الدراسة تسليط الضوء على الفكرة الأولي لنري مدى صحتها وسلامتها من النقد، ونرجئ البحث عن الفكرة الثانية إلى فرصة أخرى.
فالكلام إذن حول: «إنكار المصدر الغيبي للقرآن».
تركز هذه الفكرة علي رفض أي مصدر ما ورائي وغيبي للقرآن الكريم، وبهذا سيفقد النص القرآني سمة القداسة التي كان يتمتع بها وما يزال بين جميع فئات المسلمين، ولن يعد المخالف لظاهره كافراً، فإن القداسة للغيب المطلق أو الشيء السماوي الخالص، الأمر الذي لا يتمتع به القرآن الكريم، ويرتكز هذا الرأي علي احد الأساسين التاليين:
1 ما يسميه علماء الأصول بعدم المقتضي.
2 ما يسمونه أيضا بوجود المانع.
الأساس الأول: عدم المقتضي.
يرمي هذا الأساس إلى نفي وجود أي ضرورة بنظر العقل تقتضي إنزال قانون سماوي دائم ينظم حياة المجتمع البشري في كل جيل، ويمكن توضيح ذلك من خلال احد البيانات التالية:
البيان الأول: تكامل الإنسان والقانون الإلهي.
إن الهدف من خلق المجتمع البشري وصوله إلى الكمال عن طريق التكامل التدريجي، والتكامل متوقف على حركة ذاتية تستدعي تفعيل الطاقات المودعة في الكائن البشري، والتي منها طاقة العقل، فإن القانون الجاهز والمعد سلفا يكون عائقا أمام التكامل، لأنه يؤدي إلى تجميد طاقة العقل وعدم حركته في سبر الظروف الخاصة وقراءة التجارب المختلفة التي يختلف فيها زمن عن زمن ومجتمع عن آخر، مما يستدعي تعيين المصلحة والمفسدة الملائمة لكل زمن ومجتمع ووضع القانون المناسب لها، والنتيجة أن مطالبة العقل بالتقيد بقانون شمولي دائم يتنافى والهدف من خلق المجتمع البشري، وهو منافٍ للحكمة، فكما شاءت حكمة الله أن يعطي العقل مجاله في اكتشاف العلوم المختلفة كعلوم الطب والكيمياء والفيزياء والفلك ليعيش تكامله عبر حركة ذاتية له فليكن مقتضى الحكمة الإلهية ذلك في مجال التشريع والقانون.
إن هذا البيان يواجه عدة مشاكل:
أولاً: إن الاعتراف بوجود كامل مطلق ابتدع الوجود وأفاضه، يستلزم أن يكون الهدف من الوجود كله وصوله وتعرفه على الكامل المطلق عن طريق الاتصال به لا التكامل عبر حركة ذاتية ولو لم تكن متصلة بالكامل الحقيقي الحق باعتبار أن تكامل كل موجود قادرٍ علي التكامل إنما يتحقق بواسطة اتصاله بمصدر كماله، ولعل ذلك هو المقصود في قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾[1] .
ثانياً: إن تكامل كل موجود مرتبط بنمو طاقاته وخروجها عن القوة إلى الفعلية، وتحققها علي هذا الوجه منوط بمعرفة النظام الكوني وحدود العلاقات بين الموجودات؛ لأن الكون كله مجموعة واحدة متفاعلة فيما بينها بالتأثير والتأثر - قال تعالي: ﴿سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ﴾[2] - ومعرفة النظام الكوني لا تتيسر إلا لصانع هذا النظام، فهو القادر علي تحديد حجم كل مخلوق ومقدار قدرته علي التحرك في الطريق الصحيح، ولو كان الاتكال على الحركة الذاتية في الوصول للكمال من دون قانون ينظم مسارها لكانت الطريقة المثلي لتربية الأسرة تركها وما وهب لها من العقل للوصول إلى هدفها المنشود، وأيضا لكانت أفضل طريقة لاستقرار الحياة الاجتماعية ترك المجتمع وشأنه من دون حاجة لدولة وقانون ينظم العلاقات الخاصة والعامة، وهو أمر مرفوض من قبل الجميع.
ثالثاً: إن المشكلة التي تترتب علي رفض ربط التكامل بحركة العقل - كما ذكر في البيان - هي مشكلة العبثية واللغوية؛ فقد يدعى، أن عدم استثمار العقل واستغلاله في تحديد طريق التكامل موجب لعبثية خلقه ولغويته.
ولكن يمكن تجاوز هذه المشكلة، وذلك عن طريق إعطاء دور للعقل في مجال تطبيق القانون وتعيين موارده ومصاديقه ومواطن التزاحم بين القوانين وكيفية علاج هذا التزاحم، وإن لم يكن له أي دور
البيان الثاني: القانون الإلهي وإمكانية تطبيقه.
ينطوي توضيح هذا البيان علي مقدمتين:
أ إن صحة تشريع القانون تعتمد على ركنين، هما الملاك والفاعلية، والمقصود بالملاك المصلحة والمفسدة الموجودة في الأفعال، فلأجل تشريع أي قانون لابد من ملاحظته فان كانت فيه مصلحة تم تشريعه وان كانت فيه مفسدة فلا يشرع بل يتم النهي عنه، وأما المقصود بالفاعلية فهو أن القانون عند صدوره ينبغي أن يمتلك الضمانة لتنفيذه علي ارض الواقع لأجل الوصول إلى الأهداف المبتغاة من ورائه.
وحينئذ إذا لم يكن في فعل مصلحة أو مفسدة فسيكون الأمر به أو النهي عنه لغوا لا مبرر له، كما إذا لم يكن صدور القانون وسيلة للوصول إلى الهدف وهو تحقيق المصلحة سواء كانت نوعية أو شخصية، أو دفع المفسدة فإن تشريعه يغدو لغوا أيضاً.
ب إن التشريع السماوي فاقد للركن الثاني وهو كونه وسيلة لتحقيق المصالح المتوخاة منه، وذلك لأنه متى وصل إلى الناس اختلفوا في تفسيره وتعيين حدود موضوعه وتشخيص موارده واستثناءاته، ومن الواضح أن مفسدة الاختلاف فيه لا تقل عن المفسدة المترتبة على ترك تشريعه، بل قد تكون مفسدة الاختلاف أشد من مفسدة عدم التشريع؛ إذ قد يكون الاختلاف في الدين ذريعة لاستحلال الدماء والأموال بحجة الدفاع عن دين الله تعالى.
ولكن يمكن أن نتصور إشكالين يواجهان هذا البيان:
الأول: إن المناط في تشريع القانون أن يكون وسيلة لتحقيق الغرض ولو في بعض الأحيان، ولا يعتبر فيه أن يكون وسيلة لذلك دائماً، وبعبارة أصولية إن المناط كونه محققاً للغرض على نحو الاقتضاء لا على نحو العلية التامة التي لا يتخلف أثرها، ومن الواضح أن المصالح تختلف من حيث درجة الأهمية، فبعض المصالح لها درجة من الأهمية تتطلب تشريع القانون الحافظ لها بعدة صياغات وبأساليب متعددة، وبعض المصالح لا تقتضي أكثر من المطالبة بتنفيذها، وبعضها لا تقتضي المطالبة بتنفيذها إلا في حالة العلم بها تفصيلاً.
ثانياً: إن هذا البيان يتعارض مع العديد من القوانين الرائجة قديماً كشريعة حمورابي أو حديثاً كالقانون الفرنسي، فان كثيرا ما يحصل الاختلاف في تفسيرها وتحديد مواردها، مع انه لا يوجد احد يشكك في أهميتها وضرورتها ووجود ما يبررها.
وأيضا إن المدار في فهم القانون ومقاصد أي متكلم لدي جميع المجتمعات هو التمسك بظاهر الكلام وما يتبادر لدى أكثر أبناء كل اللغة من اللغات علي اختلافها، المعبر عنه في علم الأصول «بحجية الظهور»، إضافة إلى التمسك بما يتوافق عليه أهل كل لغة عادة من مصاديق الظهور وموارده بحيث يعد المعارض لظاهر كلام صادر عن الدولة أو الأب أو المعلم محلاً للملامة والتقبيح ألعقلائي، والقانون السماوي لا يقصر عن سائر القوانين في أن المدار في تطبيقه وتنفيذه على ما هو الظاهر منه.
وأما الاختلاف في القانون فلا يمكن ضبطه مهما بلغ من الوضوح، لتوفر بواعث الاختلاف من البغي والنزوع نحو تقديم المصالح الشخصية على المصلحة العامة، وهذا لا يخلو منه المجتمع البشري على كل حال فلا يصلح مانعاً من التقنين المطلوب.
3 - القانون الثابت والحياة المتغيرة: يتكون هذا البيان من مقدمتين:
أ إن التغير من مقومات الوجود ألإمكاني، وهذا يعني أن كل ما في العالم في حالة تغير وتبدل مستمر، ومنه الإنسان بمجمل حياته الخاصة والعامة.
ب إن القانون يهدف إلى تنظيم الحياة الإنسانية، والتغير المستمر في الحياة الحاصل بسبب تطور المجتمعات وحدوث ظواهر اجتماعية جديدة واختلاف الثقافات والحضارات يتطلب أن يكون القانون متغيراً ليتوائم مع متطلبات العصر، وإلا فان ثباته وشموليته يؤديان إلى عدم تحقق الهدف منه وهو تنظيم الحياة الإنسانية، وهو أمر مناف للحكمة، إذن فلابد إما القيام بتجديد النبوة والوحي في كل مرحلة من مراحل الحياة الاجتماعية الإنسانية، وإما عدم تشريع النظام الديني من الأساس وترك المجال للعقل البشري وخبرته ودقته.
يمكن أن نستعرض إشكالين علي هذا البيان:
أولاً: إن اعتبار كل ما في العالم متغيرا خطأ وخلط بين الظواهر والنظام الحاكم عليها، فعلي سبيل المثال جسم الإنسان متغير من النطفة إلى العلقة إلى المضغة، ومن الحياة النباتية إلى الحياة الحيوانية إلى الحياة الإنسانية وهذا تغير في الظواهر، وأما القانون والنظام البيولوجي الذي يتكفل ضبط هذه الظواهر وتطورها فهو نظام ثابت لا يتغير، وإلا أدى إلى وقوع الفوضى في كل أرجاء العالم، الأمر الذي يعني بطلان الهدف من إيجاد العالم، إذن من الأمور التي لابد منها وجود قانون ونظام ثابت ينظم حركة العالم وظواهره، قال تعالي: ﴿لا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾[3] ، ولو كان كل ما في الكون متغيرا، لتغير نفس قانون التغير وتحول إلى قانون الثبات.
ثانياً: إن متطلبات الحياة صنفان: متطلبات ثابتة كحاجة الإنسان إلى الغذاء والهواء والعبادة - باعتبار أن من المتطلبات الروحية المهمة للإنسان هي العبادة -، ومتطلبات متغيرة كحاجته للملك والزواج والقراءة، ومقتضى التناسب بين القانون وهدفه - وهو تنظيم حياة الإنسان الخاصة والعامة - أن يكون قانون المتطلبات الثابتة قانوناً ثابتاً كالقانون في مجال الغذاء والعبادات، وأما المتطلبات المتغيرة فتارة تكون متغيرة في المصاديق والأفراد دون تغير في النظام العام، والقانون المناسب لذلك قانون يتكفل ضبط المتغيرات في إطار نظامها الثابت، وتارة تكون متغيرة في موضوع الحاجة، ومقتضى ذلك وضع قانون مرن مواكب لهذه المتغيرات وهو ما يسمي في علم الأصول بقانون التوارد بين الأحكام كما في باب التزاحم، وحكومة العناوين الثانوية على الأولية.
4 الخبرة البشرية والقانون الإلهي:
اختلاف الشرائع والأديان في طريقة العبادة وحدودها شاهد على أن المطلوب من الإنسان إظهار العبودية والتذلل والمملوكية لربه بالنحو المؤثر في نفسه، كما أن اختلافها في أحكام المعاملات والأنظمة كالاختلاف في حرمة الربا ونكاح المحارم وغيرها شاهد على أن المهم عند الشريعة حفظ المصالح الاجتماعية المختلفة باختلاف الأزمنة والحضارات، وهذا مما يمكن لعلماء القانون في كل زمان تحديده من دون حاجة لتشريع سماوي شمولي، بل لا يعقل تحقيق المصالح المتغيرة بقانون ثابت، وإلا لم يكن القانون ظلاً حامياً لهذه المصالح.
هذا البيان مرفوض لعدة أسباب:
إن القانون لا يكون مرشدا للإنسان نحو تحقيق المصالح الواقعية إلا باجتماع عناصر مختلفة، منها:
ا أن يوفق بين المصالح الفردية والاجتماعية.
ب أن يكون سهلا ومرنا.
ج أن يكون ملائما لسائر التشريعات؛ باعتبار أن وعاء التشريع منظومة واحدة يكمل بعضها بعضاً.
د أن تكون طريقة تقنينه مطابقة لنوع المصلحة التي يؤمنها سواء كانت ثابتة أو متغيرة.
ه أن تكون صياغته بنحو يؤدي إلى التأثير في إرادة المخاطب في حالة وصوله إليه.
ومراعاة سائر هذه العناصر في القانون لا تتأتى إلا لخالق البشر العارف الخبير بكيان الإنسان النفسي والاجتماعي، سواء في مجال العبادات أو المعاملات ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾[4] .
الأساس الثاني: وجود المانع:
يدور البحث في هذا الأساس حول نقطتين، إحداهما قصور المستقبِل، والأخرى قصور أداة الاستقبال:
النقطة الأولى: قصور العقل البشري «المستقبِل»:
تتلخص هذه النقطة في قصور العقل البشري مهما بلغ من الكمال عن استقبال الوحي والحقائق الغيبية، ولذلك ثلاثة بيانات:
1 إن المضامين الإلهية من عالم الغيب، وعالم الغيب من نوع الوجود المطلق اللا محدود، بينما العقل البشري - ولو كان عقل نبي أو رسول - محدود باعتبار أنه وجود إمكاني وهو وجود محدود، ولا يعقل إحاطة المحدود باللا محدود.
2 إن الحقائق المطلقة ذات نسب مختلفة بالنسبة إلى جميع العوالم، فنسبتها إلى عالم الملائكة تختلف عن نسبتها إلى عالم الجن والإنسان، ومعني هذا عدم قدرة الإنسان علي نيلها بكلها والتعرف علي واقعها المطلق، وإنما ينالها ويتعرف عليها من زاوية نسبته إليها لا من جميع الزوايا، وإلا لكان عقل البشر عالما بكل ما يعلمه الملك والجان، وهو خلاف كونه بشراً.
3 إن طبيعة الذهن البشري جبلت على أن تتصور المعاني المختلفة وتستقبلها عبر القالب اللغوي، بحيث لا يمكنها فهم المعنى بدون واسطة اللفظ والإشارة أو أي أداة أخرى، وحيث إن الأداة محدودة بطبعها ولو من خلال خضوعها لحدود الزمن والمكان، فلا تكون لها قدرة علي حمل المعاني المطلقة، وإلا لفقد المطلق صفة إطلاقه.
هناك عدة إشكالات تواجه هذه البيانات:
أولاً: علي الرغم من أن العقل البشري موجود إمكاني ومخلوق، إلا إن ذلك لا يستدعي أن يكون محدوداً من حيث قدرته علي الفهم والمعرفة، فان للعقل البشري قدرة هائلة علي استيعاب المعارف العميقة والغيبية.
ثانياً: إذا كانت هناك ملازمة بين أن يكون الشيء مجعولاً وان يكون محدوداً، فمقتضى ذلك أن يكون القانون السماوي محدوداً أيضاً؛ لأنه من نمط المجعولات الإنشائية التي تنالها يد الجعل والإيجاد.
ثالثاً: إن القانون وإن كان سماوياً باعتبار مصدره إلا أنه إنساني باعتبار موضوعه، فمن جهة انه نابع من مصالح إنسانية محدودة - ولو بظهور القائم أو قيام الساعة - فهو محدود بحدودها، ومن جهة انه قانون لتنظيم الحياة المادية الفردية والاجتماعية للإنسان فهو محدود بحدود موضعه ووعاء تطبيقه.
رابعاً: إن هناك فرقاً في المضامين الإلهية بين ما يرتبط بعالم الأسماء والصفات، وما يرتبط بالنظام الأصلح لمسيرة الكون، فما يرتبط بالأسماء والصفات حقائق مطلقة لا يحيط بها المخلوق، ولكن ينال كل مخلوق من حقيقتها بقدر استعداده الروحي وقدرته الاستيعابية، سواء كان بشراً أو ملكاً أو غيرهما، وربما يفوق الإنسان فيها غيره من الموجودات، قال تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ﴾[5] ، وقال أمير المؤمنين  : من عرف نفسه فقد عرف ربه[6] ، ولكن البحث حاليا لا علاقة له بهذا العالم؛ إذ لا فائدة عملية وتطبيقية تترتب على كون معرفة الإنسان بهذا العالم محدودة أو مطلقة.
: من عرف نفسه فقد عرف ربه[6] ، ولكن البحث حاليا لا علاقة له بهذا العالم؛ إذ لا فائدة عملية وتطبيقية تترتب على كون معرفة الإنسان بهذا العالم محدودة أو مطلقة.
وأما بالنسبة إلى النظام الأصلح، فمقتضى صدور هذا النظام عن الكامل المطلق كما هو مقتضى كونه وجوداً واجبياً مطلقاً أن يكون نظاماً هادفاً خاضعاً لدقة متناهية، تجعله مظهراً للكمال، وفقاً لقانون السنخية والتناسب بين العلة والمعلول والصانع وصنعته ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً﴾[7] ، ومن آثار ذلك أن يكون لكل عالم من عوالم الوجود قانون مناسب لتوجيهه نحو كماله اللائق به، سواء كان قانوناً تكوينياً كما في عالم الملائكة أو اعتبارياً كما في عالم الإنسان، فمن غير الصحيح الخلط بين هذين الصنفين من الحقائق الإلهية، وادعاء أن الجميع غيب مطلق، له نسب مختلفة باختلاف العوالم، وإنما لكل عالم نظامه الموضوع لأجله.
خامساً: بما أن الهدف من القانون تنظيم الحياة الإنسانية وتوجيهها نحو كمالها، وحيث لا يمكن ذلك إلاّ إذا كان بأدوات إنسانية ومنها اللغة، كان مقتضى الحكمة أن يكون القانون مقدرا بقدر أدواته التي توصله إلى الإنسان، بحيث يجمع بين حفظ هذه الأدوات للمصالح المنشودة، وفاعليتها في التأثير على إرادة الإنسان وكيانه، فإن إفراغ حقائق مطلقة لا حد لها ضمن قوالب لفظية محدودة مناف للحكمة، فيما إذا كان الهدف منه إيصال هذه الحقائق الدقيقة بكاملها وبكل ما تتضمنه من عمق وغموض إلى الإنسان، بينما إبراز مضامين قانونية محدودة بقوالب لفظية محدودة أيضا فهو عين الحكمة.
النقطة الثانية: قصور اللغة «أداة الاستقبال»:
وتتلخص هذه النقطة في قصور اللغة البشرية عن أن تكون قالباً للمضامين السماوية، فالنقص - كما يقول الفلاسفة - في القابل لا في الفاعل، ولذلك عدة بيانات:
1 اللغة والمعاني المجردة: اللغة نتاج للعقل البشري، حيث قام المجتمع ألعقلائي باختراعها لتلبية حاجته في مجال الفهم والإفهام، وباعتبار إن المعاني المتبادلة خلال معظم المحاورات الدائرة بين أبناء البشر لا تتجاوز نطاق المعاني المادية المحدودة، ادي ذلك إلى اقتصار قدرة اللغة البشرية علي التعبير عن هذا النمط من المعاني، وقصورها عن التعبير عن المعاني السماوية المجردة، بسبب استغناء البشر في مجال الفهم والإفهام - الذي هو سبب اختراع اللغة - عن ذلك،، ولازم ذلك عدم قدرة اللغة علي أن تصبح قالباً للمادة القانونية السماوية.
يواجه هذا البيان المشاكل التالية:
أولاً: إن النزوع الفطري للإنسان نحو التعلق بما وراء عالم المادة قد بدأ ببداية الإنسان على الأرض، ولذلك اتصلت الشرائع السماوية بمسيرة الإنسان منذ أول أيامه، وكانت ظاهرة العبادة أقدم ظاهرة إنسانية اكتشفها علماء الإنسان أو الانثروبولوجيا «Anthropology»، وطبيعي أن يحاول الإنسان وضع المفردات والمركبات اللغوية الكفيلة بالتعبير عن المعاني الغيبية التي يحاول التعبير عنها من خلال الأدعية والطقوس المختلفة، وهذا يعني أن حاجة الإنسان للتعبير عن المعاني الغيبية المطلقة حاجة رائجة وقديمة ونصيبها من الثروة اللغوية نصيب وافر.
ثانياً: عدم إدراك المعاني الغيبية على واقعها أمر غير مضر، وذلك لأن ما وضعت الألفاظ بإزائه هو الكلي الطبيعي الجامع المنطبق على المصداق المادي والغيبي معا، فعلي سبيل المثال عنوان «العرش» يحكي عن معني عام وهو مركز السلطة، وله مصداقان مادي ومجرد، وعدم إدراك الذهن المصداق الغيبي لهذا المعني على واقعه لا يضر بقدرة اللغة علي إبراز المعني الجامع المشترك الذي هو المقصود غالباً عند استعمال اللغة، وتعيين المصداق يكون بتعدد الدال، ولو بمعونة قرائن أخرى متضافرة، والنتيجة أن تصور كون اللغة قالباً للمعاني المادية فقط ناشئ من الخلط بين المعني والمصداق، كما أن عدم قدرة الذهن على تصور المصاديق الغيبية المجردة لا يسقط اللغة عن قدرتها علي إبراز تلك المصاديق - ولو على نحو الإشارة - من خلال معانيها الكلية.
ثالثاً: ذكرنا فيما سبق أن المعاني السماوية على قسمين حقائق مطلقة ومضامين قانونية، وما يحتاج إليه الإنسان من القسم الأول هو تصوره على نحو الإشارة والإجمال، من دون حاجة إلى الإحاطة بكنهه، لكفاية ذلك في تهذيب سلوك الإنسان وإصلاحه وتطوير مسيرته، وأما المضامين القانونية فهي مضامين محدودة بحدود قدرة أدوات الإنسان علي استيعاب المعاني المختلفة كما سبق بيانه، فان كونها قوانين لتنظيم حياة الإنسان يقتضي أن تكون مصاغة بحقيقتها وواقعها بلغة الإنسان، إذ لا يوجد طريق آخر لإيصالها إليه، إذن اللغة البشرية قادرة علي التعبير عن المضامين القانونية السماوية.
2 تغير اللغة وثبات القانون: اللغة كائن بشري حي، لخضوعه لقانون التغير والتطور، فباعتبار أن الهدف من وراء اختراعها هو تلبية حاجة الإنسان في مجال الفهم والإفهام فإنها تتغير وتتطور بتغير حاجات الإنسان وتطور حضاراته واختلاف مجتمعاته، وهذا يعني عدم قدرتها علي أن تكون قالباً لمادة قانونية شاملة لكافة الأمم والمجتمعات، فالألفاظ تتبدل وتتغير، والمعاني تتسع وتضيق وتختلف من زمن لآخر، وذلك مانع من أن تكون أداة لإيصال القانون لجميع الأجيال علي اختلافها.
ويمكن مناقشة هذا الكلام بمناقشتين:
أولا: النقض بما تم اكتشافه من الحضارة المصرية والبابلية والآشورية والفارسية والصينية وغيرها، فإن الإنسان تمكن من التعرف علي هذه الحضارات الضاربة في القدم عن طريق أدوات متعددة، من أهمها الكتابات المنحوتة على الصخور التي يرجع عهدها إلى ألاف السنين، وقد تمكن الإنسان من فك رموز هذه الكتابات علي الرغم من أنها تنتمي إلى لغات قديمة، فان مقتضى قانون التغير والتطور في اللغة عدم قدرة إنسان اليوم على اكتشاف حضارة الأمس بهذه الطريقة، لكنه تمكن، وهذا يدل علي أن التغير والتطور في اللغة لا يمنعان من الفهم وانتقال المعاني إلى الآخرين.
ثانيا: يوجد بين أبناء المجتمع الإنساني ألعقلائي عقد اجتماعي هدفه الاتفاق علي طريقة تكتشف بها معاني الألفاظ عند التلفظ بها، وهو مؤلف من عنصرين:
ا قيام أصحاب الاختصاص في أي لغة بتحديد معاني الألفاظ على طبق ما ينصرف ويتبادر لأذهانهم من هذه الألفاظ عند إطلاقها.
ب إثبات أن ما يفهمونه من معاني الألفاظ حالياً هو نفس ما كان يفهمه أبناء اللغة المعاصرون لتاريخ إصدار القانون، وذلك عن طريق ما يسمي في علم الأصول بأصالة عدم النقل أو أصالة الثبات، باعتبار أن تغير المعاني يتم عبر حركة بطيئة لا يعتني بها العقلاء إلا بنسبة ضئيلة جدا، والنتيجة إن اللغة صالحة لتحمل المادة القانونية الشاملة والعامة مهما تغيرت الأزمنة والمجتمعات، اعتماداً على الفهم ألعقلائي المذكور آنفا.
3 أسلوب اللغة العربية وطبيعة القانون: اللغة العربية لغة خطابية لا قانونية؛ وذلك لأنها مليئة بالمجازات المرسلة والاستعارات والكنايات، مما يجعلها مناسبة لعالم الخطابة والشعر الذي يؤثر في العواطف والمشاعر، ويؤدي إلى إيجاد عقل جمعي مشترك يرمي إلى تحقيق أهداف وغايات معينة، فهي إذن غير ملائمة لطبيعة المادة القانونية التي تحتاج إلى ألفاظ واضحة لا تحتمل معاني متعددة احتمالاً عرفياً، فكيف يدعى نزول قانون السماء بها مع أن صياغة القانون بلغة خطابية يتناقض والهدف من تقنينه؟ إن هذا أمر لا يصدر من الحكيم.
يرد عليه:
أولاً: إن من طالع اللغة العربية بدقة وخبرها يشاهد أن نسبة المجاز فيها لا تشكل عائقاً أمام قدرتها علي صياغة المعاني الدقيقة، كما يمكن ملاحظة ذلك من خلال مراجعة كتب اللغة والكتب العلمية المكتوبة باللغة العربية والمترجمة إليها كالكتب الطبية والفلكية، وكتب المنطق الأرسطي والفلسفة اليونانية والعلوم الغريبة.
ثانياً: إيصال المعاني القانونية لا يرتكز على الألفاظ المستعملة في العربية وحدها، بل يستند إلى القرائن اللفظية والحالية والارتكازية المختلفة مما يزيل عدم الوضوح في المادة القانونية عند صياغتها باللغة العربية.
ثالثاً: الهدف من القانون توجيه إرادة المكلف، ويستلزم ذلك أن تكون صياغته مؤثرة في نفس المخاطب بحيث تؤدي إلى توجيه إرادته، وهذا النوع من الصياغة يعتمد على أسلوب الكناية والاستعارة ونحوها من الأساليب البلاغية، كقوله  التراب طهور المؤمن عشر سنين[8] ، وقوله: ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر[9] ، والطواف في البيت صلاة[10] ، إذن دعوى حصر صياغة القانون في الألفاظ الحقيقية الصريحة أو الواضحة، مجانبة للصواب.
التراب طهور المؤمن عشر سنين[8] ، وقوله: ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر[9] ، والطواف في البيت صلاة[10] ، إذن دعوى حصر صياغة القانون في الألفاظ الحقيقية الصريحة أو الواضحة، مجانبة للصواب.
رابعاً: من الخصائص المذكورة في فلسفة القانون أي قانون هو التعويض والتبديل بين القوانين، يعني إذا علم المشرع أن أكثر المكلفين يقصرون عادة في تطبيق قسم من القوانين - بسبب بعض الدوافع النفسية - كأداء صلاة الفجر في وقتها، أو حرمة الأسباب الباطلة في المعاملة كالغش والتدليس التي يتورط بها معظم الناس، فإنه - بمقتضى رأفته بالمكلف وعطفه عليه في إيصاله لكماله اللائق به - يقوم بتعويض الملاك والمصلحة الفائتة على المكلف التي قام بتفويتها تقصيراً أو غفلة بقوانين أخرى يتدارك بها ما فاته من الملاكات والمصالح، كما ورد في بعض النصوص: >إنما شرعت النافلة ليتدارك بها ما نقص من الفريضة<[11] ، ويمكن تطبيق ذلك علي بحثنا بأن المقنن عندما يعلم أن بعض قوانينه لا يصل للمكلف بواقعه المطلوب بسبب قصور اللغة ووجود المجازات والكنايات التي لا تخلو منها لغة بشرية، مما يؤدي إلى فوات بعض الملاكات والمصالح عليه، فإنه يقوم بتعويض المكلف بقوانين أخرى يتدارك بها ما فاته.
ثم إن المصالح تختلف من حيث الأهمية، فرب مصلحة تبلغ من الأهمية درجة تقتضي بيان القانون الحافظ لها بمختلف الأساليب التي توجب وضوح ذلك القانون إلى حد يرتفع عنه كل شك، حتى يغدو كالضروريات والمسلمات في الدين، ورب مصلحة تقتضي بيان قانونها بالنحو المتداول بين البشر في بيان القوانين، ورب مصلحة لا تقتضي إلاّ بيان قانونها بصورة إجمالية ولو بلغة خطابية ومجازية.
إذن ليست هناك ملازمة بين استخدام اللغة الخطابية في بيان القانون ومسألة تناقض ذلك مع الهدف من تقنين القانون.