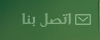الدرس 43
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
الكبرى الرابعة التي تترتب عليها النتيجة حيث إن السيد الإمام «قدس سره» أفاد بأنه عند تعارض حديث لا تعاد مع موثقة أبي بصير فالنبوي وهو حديث الرفع مرجح لحدهما على الآخر مع أن النسبة بين النبوي وموثق أبي بصير عموم من وجه مع ذلك اعتبر النبوي مرجحا لصحيح لا تعاد على موثق أبي بصير مع أن نسبة هذا المرجح إلى كل من الطرفين نسبة العموم من وجه وليس اعم منهما مطلقا بل بينه وبينهما تعارض على نحو العموم من وجه، فهل يتم جعل الكتاب والسنة مرجحا لأحد المتعارضين على الآخر ولو كانت النسبة بين الكتاب أو السنة وبين المتعارضين عموم من وجه أم لا؟
ولأجل تحقيق هذا المطلب نذكر أموراً ثلاثة:
الأمر الأول: إنما دل على طرح المخالف للكتاب والسنة كما في صحيح أيوب بن الحر: كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة، هل يشمل ما خالف الكتاب والسنة بنحو العموم من الوجه، لا أنه مخالف لهما بنحو التباين، فإنه إذا كان الحديث منافيا للكتاب والسنة بنحو التباين فواضح أن هذا هو المقدار المتيقن مما يطرح، وأما إذا كان الحديث مخالفا للكتاب والسنة بنحو العموم من وجه فهل هذا موجب لطرحه وهو مشمول لقوله: كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة، أم لا؟
فقد ذهب المحقق العراقي والمحقق النائيني قدس سرهما إلى عدم الشمول وان هذه الأخبار تختص بما كانت المخالفة على نحو التباين؛ والسر في ذلك أنه في معتبرة جميل بن دراج وموثقة السكوني عن أبي عبد الله  أن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه، فيقال بأن ظاهر سياق هذه الرواية أن الموافق هو ذو نور وذو حقيقة، بينما المخالف لا نور له ولا حقيقة، حيث قال: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فمقتضاه أن المخالف يطرح لأنه ليس له حقيقة ولا نور، وهذا إنما يصدق على ما كان مخالفا بنحو التباين، وأما إذا كان مخالفا بنحو العموم من وجه فهذا الحديث في مورد الافتراق له حقيقة وله نور، بينما هذه الرواية ظاهرها أن المخالف لا نصيب له من النور والحقيقة، وهذا لا ينطبق على ما كانت نسبته مع الكتاب والسنة نسبة العموم من وجه.
أن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه، فيقال بأن ظاهر سياق هذه الرواية أن الموافق هو ذو نور وذو حقيقة، بينما المخالف لا نور له ولا حقيقة، حيث قال: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فمقتضاه أن المخالف يطرح لأنه ليس له حقيقة ولا نور، وهذا إنما يصدق على ما كان مخالفا بنحو التباين، وأما إذا كان مخالفا بنحو العموم من وجه فهذا الحديث في مورد الافتراق له حقيقة وله نور، بينما هذه الرواية ظاهرها أن المخالف لا نصيب له من النور والحقيقة، وهذا لا ينطبق على ما كانت نسبته مع الكتاب والسنة نسبة العموم من وجه.
ولكن يلاحظ على ذلك:
أولاً: بأن هذا التعبير مجرد كناية وليس المقصود به معناه الحقيقي، فهو كناية عن عدم الحجية، أي ما كان مخالفا للكتاب والسنة فليس بحجة، فكما عبر في بعض الروايات الأخرى بأنه زخرف أو أنه باطل أو أنه لا تأخذ به، أيضاً عبر في هذه الرواية بأنه أن على كل حق حقيقة وان على كل صواب نورا، فهذا التعبير كناية عرفا عن عدم الحجية لا أكثر، وبالتالي كما ينطبق المكني عنه على ما كان مخالفا على نحو التباين، ينطبق على ما كان مخالفا بنحو العموم من وجه في مورد الاجتماع.
وثانياً: لو فرضنا أن هذه الرواية وهي معتبرة جميل لا تشمل ما كان مخالفا بنحو العموم من وجه، فهناك روايات أخرى يمكن التمسك بإطلاقها لبيان طرح ما كان مخالفا للكتاب على نحو العموم من وجه، ومن تلك الروايات نفس صحيحة أيوب بن الحر حيث قال: كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة، فلم يؤخذ فيه حيثية النور والحقيقة كي يدور القبول مدارهما.
هذا من ناحية الأمر الأول.
إن على كل حق حقيقة، الحقيقة بمعنى العلامة، كل حق له علامة، لكل صواب نور يكتشف منه، فما وافق كتاب الله يعني ما خالف كتاب الله ليس هناك علامة على صدقه حتى يكون مقبولا وحجة، فليست هذه العبارة في مقام بيان التعليل وإنما هذه العبارة في مقام بيان الكاشف الإثباتي عن كونه حجة أم ليس بحجة.
المطلب الثاني أو الأمر الثاني: إن هناك طائفتين من الروايات:
طائفة دلت على طرح المخالف للكتاب وان لم يكن له معارض كمعتبرة جميل بن دراج التي قرانها وصحيحة أيوب بن الحر.
والطائفة الثانية: ما دلت على طرح المخالف للكتاب في فرض أن له معارضا، كمصحح عبد الرحمن بن أبي عبد الله لأنه فيه خلاف قال: قال الصادق  : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه. وقد وقع الكلام في التوفيق بين الطائفتين، فهل أن المراد بالمخالفة في الطائفتين معنى واحد فالمراد بما خالف الكتاب في الطائفة الأولى هو ما خالف الكتاب في الطائفة الثاني أم يختلفان في ذلك.
: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه. وقد وقع الكلام في التوفيق بين الطائفتين، فهل أن المراد بالمخالفة في الطائفتين معنى واحد فالمراد بما خالف الكتاب في الطائفة الأولى هو ما خالف الكتاب في الطائفة الثاني أم يختلفان في ذلك.
فهنا أفاد المحقق النائيني «قدس سره» والسيد الإمام «قدس سره» أن المراد بالمخالفة في الطائفة الأولى التي أمرت بطرح المخالف وان لم يكن له معارض غير المراد في المخالفة في الطائفة الثانية التي دلت على أن الحديثين إذا تعارضا رجح احدهما بموافقة الكتاب، وان اختلف العلمان في تحديد هذه المخالفة.
فهنا نأتي أولا إلى ما أفاده المحقق النائيني «قدس سره» حيث قال: بما أن أخبار الترجيح كمصحح عبد الرحمن: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما، بما أن أخبار الترجيح بصدد العلاج علاج المتعارضين، وحل مشكلة التعارض فمقتضى هذا السياق أن الحديث فرغ عن حجيتهما في نفسهما، فهو في مقام علاج التعارض بين حجتين لا في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة لان ظاهر السياق أنه في مقام العلاج وحل مشكلة التعارض، فمقتضى هذا السياق حمل المخالفة للكتاب في روايات الترجيح على معنى يلائم الحجية، بأن يكون المخالف للكتاب أيضا حجة في نفسه فلا بد من تفسير المخالفة بنحو ملائم لحجيته بأنه مخالف ومع ذلك حجة في نفسه، وهذا إنما ينسجم إذا فسرنا المخالفة في هذه الطائفة بالمخالفة بالعموم والخصوص المطلق، فنقول: إذا تعارض حديثان سواء كان بينهما تباين أو عموم من وجه، لكن احدهما اخص من الكتاب والآخر متطابق مع عموم الكتاب، قدم المتطابق مع عموم الكتاب على ما كان اخص، فالمراد بالمخالفة في هذه الطائفة مخالفة تتلاءم مع الحجية، والمخالفة الملائمة مع الحجية هي المخالفة بنحو الأخصية حيث إن الخاص حجة في نفسه لولا المعارضة.
هذا ما ذكره المحقق النائيني «قدس سره» وتبعه سيدنا الخوئي وشيخنا الأستاذ وجمع...
هذا الخبر بلحاظ مورد الاجتماع يكونان متباينين، وهو بلحاظ مدلوله موافق لعموم الكتاب، لا أن مدلوله نفس مدلول الكتاب، هذا الكلام إنما يتم لو كان مدلول الثاني نفس مدلول الكتاب حرفاً، نحن نقول: متطابق مع عموم الكتاب، وإن كان النسبة بينهما هي نسبة التباين، كأن يقول أحد الخبرين: يحرم الربا بين الوالد وولده، ويقول الآخر: لا ربى بين الوالد وولده، والأول متطابق مع عموم الكتاب لا أنه نفس مدلول الكتاب فحينئذ يقدم الأول على الثاني لتطابقه مع عموم الكتاب وكون الثاني أخص.
هذا ما ذكره النائيني.
وأما ما ذكره السيد الإمام «قدس سره» في رسائله قال بأن مصحح عبد الرحمن وهو قوله: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه، لاحظوا كلمة المخالفة وردت مرتين في هذا الحديث.
وردت المخالفة في صدر الحديث حيث قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، ووردت المخالفة في ذيل الحديث، حيث قال: ما خالف كتاب الله فردوه، وبين المخالفة في الصدر والمخالفة في الذيل اختلاف يعني المراد منهما.
فالمراد من المخالفة في صدر الرواية المخالفة على نحو التباين أو العموم من وجه إذ لا يسمى الخبران المختلفين إلا إذا كانا متباينين أو بينهما عموم من وجه وإلا لو كان احدهما اخص من الآخر لا يقال بأنهما مختلفان لان الخاص بالنظر العرفي قرينة على العام وليس مخالفا له فلا يصدق عليهما حديثان مختلفان إلا إذا كان بينهما تباين أو عموم من وجه.
بينما إذا جئنا إلى كلمة «ما خالف» في الذيل «فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه» نقول: المقصود بقوله: ما خالف كتاب الله، جميع الأنواع بمعنى خالف كتاب الله بنحو التباين، أو خالف كتاب الله بنحو العموم من وجه، أو خالف كتاب الله بنحو الأخصية، فعنوان المخالفة في الذي يشمل الثلاثة أي أن ما خالف كتاب الله بنحو من أنحاء المخالفة فهو مردود أو يقدم غيره عليه.
والوجه في ذلك: أن ظاهر سياق روايات الترجيح أن موطنها سؤالا وجوابا رفع الحيرة بمعنى أن السائل متحير نتيجة اختلاف الحديثين، فموطن السؤال رفع الحيرة، والجواب رفع الحيرة، فمقتضى ذلك بما أن المنظور إليه رفع الحيرة كان ذلك موجبا لشمول عنوان المخالفة للذيل لما كان مخالفا حتى بنحو الأخصية.
فعلى مطلبه هو لم يقل بل أنا أقول فعلى بنائه «قدس سره» يكون مفاد مصحح عبد الرحمن بن أبي عبد الله الأعم من تمييز الحجة عن اللاحجة وترجيح الحجة على الحجة الأخرى؛ لأنه إذا كان المخالف للكتاب بنحو التباين أو العموم من وجه كان تقديم غيره عليه من باب تمييز الحجة عن اللاحجة لان ما كان مخالفا بنحو التباين ليس بحجة قطعا، وأما إذا كان المخالف للكتاب مخالفا على نحو الأخصية فتقديم غيره عليه من باب ترجيح الحجة على حجة أخرى، فهل يمكن استفادة هذين المدلولين من قوله: فردوه، بمعنى أن المستفاد من قوله: فردوه، عدم حجيته وترجيح غيره عليه.
هذا ما ذكره السيد الإمام «قدس سره» وذكرنا أيضاً ما ذكره المحقق النائيني.
ولكن عندنا مواطن للتأمل:
الموطن الأول: أن يقال بأن حتى القسم الثاني من الروايات وهو مصحح عبد الرحمن الوارد في الحديثين المتعارضين المختلفين يكون المراد بالمخالفة فيه وهو قوله ما خالف كتاب الله فردوه، نفس المراد بالمخالفة بالقسم الأول وهو المخالفة بنحو التباين أو العموم من وجه ولا يشمل ما كان اخص من الكتاب؛ وذلك لقرائن ثلاث:
القرينة الأولى: أن العرف لا يرى الأخص مخالف ولا يطلق عليه عنوان المخالف، فإنه لو كان الخاص واردا وحده إلا يعد قرينة على الكتاب والسنة فكيف بمجرد أن وجد له معارض صار مخالفا للكتاب؟ فهل يتبدل صدق المخالف عليه بمجرد أن له معارضا والحال أنه لو لم يكن له معارض لم يكن مخالفا للكتاب.
القرينة الثانية: أنه في صحيحة عبد الرحمن ظاهر السياق وحدة المراد من المخالفة في الصدر والذيل فإذا كان المراد بالمخالفة في الصدر إذا ورد عليكم حديثان مختلفان خصوص المخالفة بالتباين والعموم من وجه، فكيف يكون المراد بالمخالفة في الذيل ما يشمل المخالفة بنحو الأخصية فإن مقتضى ظاهر السياق وحدة المراد منهما، وهنا هو أجاب عن هذا الإشكال هذا الإشكال الثاني أو القرينة الثانية تعرض له، فقال: لا يقال: إن القرينة صدر الرواية فإنه ورد فيها الحديثان المختلفان والمفروض أن المخالفة بين الحديثين محمول على المخالفة بغير ما يكون بينهما جمع عرفي يعني بغير الأخصية، فوحدة السياق تقتضي أن تكون المخالفة في الذيل كذلك، وبالجملة لا يجوز التفكيك بين الصدر والذيل في رواية واحدة بجعل الصدر على نوع والذيل على مطلقها، فإنه يقال هذا لا يقال فإنه يقال عدم جواز التفكيك بينهما إنما هو إذا عرض لموضوع واحد كما لو عرض لاختلاف الخبرين يعني كان الموضوع في الذي هو اختلاف الخبرين، وأما إذا كان الاختلاف في الذيل هو اختلاف الخبرين والاختلاف في الذيل هو اختلاف الخبر والكتاب فلا وجه لرفع اليد عن إطلاق الثاني بقرينة الأول فإن هذا ليس من التفكيك الممنوع.
ويلاحظ عليه: أنه لم يختلف الصدر والذي موضوعا إنما اختلف الطرف، هنا قال: حديثان مختلفان، وهنا قال: كتاب وخبر مختلفان فإن مجرد تغيير الطرف لا يوجب تعدد الموضوع حتى يقال إن التفكيك بينهما ليس من التفكيك الممنوع، إذن بالنتيجة أن المرجع هو ظاهر السياق وظاهر السياق يقتضي وحدة المراد منهما.
القرينة الثالثة: ما ذكره صاحب الكفاية «قدس سره»: أن هناك ظهوراً مجموعياً لا ظهوراً افرادياً وهو أن هذه الروايات كلها التي تعرضت لما خالف الكتاب سلة واحدة عندما تلاحظ هذه الروايات بمجموعها يتشكل منها ظهور مجموعي وهو أن المراد بمخالفة الكتاب فيها معنى واحد، حيث إن التعبير واحد في جميعها غاية ما في الأمر هناك قال: فما خالف كتاب الله فدعوه، وهنا قال: وما خالف كتاب الله فردوه، فبما أن التعبير الوارد فيها جميعا واحد فمقتضى ذلك أن المراد بالمخالفة فيها معنى واحد ومجرد أن هذه وردت فيما ليس له معارض وهذه وردت في الحديثين المتعارضين لا يوجب ذلك رفع اليد عن ظهور المخالفة في المخالفة بنحو المباينة أو العموم من وجه؛ لان الإمام قد يطبق قواعد التمييز بحسب تعبير السيد الأستاذ بين الحجة واللاحجة في الخبرين المتعارضين فلو فرضنا أن الإمام قال هكذا: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاخذ بخبر الثقة بينهما فهل في هذا التعبير حزازة أن قوله: خبرين مختلفين، إذن كيف يكون احدهما ثقة والآخر غير ثقة؟ فلا مانع من أن يطبق الإمام قواعد التمييز بين الحجة واللاحجة في الخبرين المتعارضين.
والنتيجة أن جميع روايات هذا الباب في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة لا أنها في مقام ترجيح حجة على أخرى بعد المفروغية عن أصل حجيتهما.
الأمر الثالث أو المطلب الثالث: أفاد السيد الإمام «قدس سره» أنه أن حديث الرفع مرجح لصحيح لا تعاد على موثق أبي بصير وإن كانت النسبة بين حديث الرفع وموثق أبي بصير العموم من وجه لم؟ لأنه بنظره كما الآن تعرضنا له أن المستفاد من أخبار الترجيح هو تقديم احد المختلفين على الآخر بمجرد أن يكون احدهما موافقا للسنة وإن كانت النسبة بين السنة وبين ذاك الآخر العموم من وجه.
فيلاحظ على هذا المطلب الذي أفاده هنا أنه حتى لو بنينا معه على أن الكتاب والسنة مرجح لا فقط مميز للحجة عن اللاحجة بل أنه مرجح ولكن لا تشمل المرجحية ما إذا كانت النسبة بين السنة وبين الحديث الآخر نسبة العموم من وجه؛ والسر في ذلك أن السنة إما قطعية أو ظنية، فحديث الرفع مثلا إما قطعي أو ظني، فإن كانت السنة قطعية فالخبر الآخر المخالف لها بنحو العموم من وجه أصلاً ليس بحجة لمخالفته للسنة القطعية لا أنه رجح غيره عليه في مقام التعارض بل ليس حجة في نفسه لأنه مخالف للسنة وهو قد ذكر أن ما كان مخالفا للسنة بنحو التباين أو العموم من وجه فهو ليس بحجة في نفسه مطروح أصلاً.
وأما إذا افترضنا أن السنة ظنية مثل حديث الرفع حيث إنه ظني إذن بمجرد المعارضة بين موثق أبي بصير وبين حديث الرفع لا يصدق على حديث الرفع أنه سنة؛ لأنه بالتعارض بينهما دخلا تحت عنوان إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، فأصبحا في رتبة واحدة، لا أن الآخر لمجرد كونه نبويا صار سنة ومرجح لأحدهما على الآخر مع العلم أن الآخر وهو في رتبة واحدة، فإنما يصدق على الخبر أنه مخالف للسنة لو كان المخالف سنة في رتبة سابقة، أما إذا كان المخالف لم يصدق عليه سنة بعد نتيجة المعارضة فكيف يرجح معارضه عليه من باب أن معارضه موافق للسنة وهو مخالف للسنة، ولا يحتمل منه «قدس سره» أن يطرح كل خبر معصومي لمجرد أنه معارض لخبر نبوي مع أن كليهما ظني خصوصا إذا كان الخبر المعصومي قطعي الدلالة والجهة.
والحمد لله رب العالمين