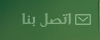فصل الخطاب - الحلقة 11
بسم الله الرحمن الرحيم
من جملة البيانات الحسينية التي صدرت من فم الحسين  عند لقائه مع الحر بن يزيد الرياحي: قال الحسين
عند لقائه مع الحر بن يزيد الرياحي: قال الحسين  للحر: ما تريد؟ قال: أريد أن أنطلق بك إلى الأمير عبيد الله بن زياد، قال الحسين: إذن والله لا أتبعك، فقال الحر: إذن والله لا أدعك. فترادّا القول ثلاث مرات، فلما كثر الكلام بينهما، قال له الحر: ”إني لم أؤمر بقتالك، إنما أمرت ألا أفارقك حتى أقدمك الكوفة، فإن أبيت فخذ طريقًا لا يدخلك الكوفة ولا يردك إلى المدينة، تكون بيني وبينك نصفًا، حتى أكتب إلى الأمير، وتكتب إلى يزيد أو إلى عبيد الله، فلعلّ الله إلى ذلك أن يأتي بأمر يرزقني فيه العافية من أن أُبْتَلى بشيء من أمرك، فخذ هاهنا، فتياسر عن طريق العُذَيب والقادسية“، فسار الحسين، وسار الحر في أصحابه يسايره.
للحر: ما تريد؟ قال: أريد أن أنطلق بك إلى الأمير عبيد الله بن زياد، قال الحسين: إذن والله لا أتبعك، فقال الحر: إذن والله لا أدعك. فترادّا القول ثلاث مرات، فلما كثر الكلام بينهما، قال له الحر: ”إني لم أؤمر بقتالك، إنما أمرت ألا أفارقك حتى أقدمك الكوفة، فإن أبيت فخذ طريقًا لا يدخلك الكوفة ولا يردك إلى المدينة، تكون بيني وبينك نصفًا، حتى أكتب إلى الأمير، وتكتب إلى يزيد أو إلى عبيد الله، فلعلّ الله إلى ذلك أن يأتي بأمر يرزقني فيه العافية من أن أُبْتَلى بشيء من أمرك، فخذ هاهنا، فتياسر عن طريق العُذَيب والقادسية“، فسار الحسين، وسار الحر في أصحابه يسايره.
هنا قد يتساءل الإنسان: هل من المعقول أن يتحوّل الإنسان في لحظةٍ واحدةٍ من شرير إلى خيّر؟ هل من المعقول أن الإنسان الذي خرج لارتباك أكبر جريمة - وهي أسر ابن بنت رسول الله، وتسليمه أسيرًا ذليلًا لعبيد الله بن زياد - أن يتحول إلى شهيد بين يدي الحسين، وينال السعادة العظمى، وهي أن يكون من أصحابه الذين قال فيهم الحسين: ”ما عرفتُ أصحابًا أوفى وأبرّ من أصحابي“؟! هل يتصوّر الانقلاب في الشخصية من عالم مظلم إلى جوهر مشرق مضيء، أم لا؟ الجواب عن هذا التساؤل:
أولًا: محو الحسنات للسيئات.
إنَّ الانقلاب ممكنٌ إذا كان ما صنعه من الحسنة أكبر بكثير مما صدر منه من السيئة، من الممكن أن الإنسان يعيش فترة منحرفًا، من الممكن أن الإنسان يعيش فترة ناكبًا عن الصراط المستقيم، ولكن رغم الذنوب ورغم المعاصي ربما يرتكب عملًا عظيمًا يمحو كل سيئاته السابقة، ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ كما ذكر القرآن الكريم، والقرآن عندما يقول بأن الحسنة بعشر والسيئة بمثلها لأن الحسنة لها تأثير من جهتين: فالحسنة لها تأثير في استجلاب الثواب، ولها تأثير في محو أثر السيئات، الحسنات لها تأثير من كلا الطريقين، فهي من جهة موضوعٌ لاستدرار الرحمة ولاستمطار المثوبة، ومن جهة أخرى فهي تقوم بعمل غربلة وتطهير لذات الإنسان من درن السيئات، ومن الآثار الملوّثة للسيئات.
إذن، الانقلاب ماذا يعني؟ يعني أن هذه النفس الإنسانية تتحول من قطعة مظلمة إلى قطعة مشرقة، هذا أمر ممكن، وجدًا ممكن، إبليس - لعنه الله - تحوّل في لحظة واحدة من عابد في حظيرة القدس إلى أن يكون مصدر الشر للإنسانية كلها، لأنه في لحظة واحدة استحال من مخلوق عابد إلى مخلوق أناني متكبر لا يفكّر إلا في غطرسة نفسه، فكما تصوّرنا الانقلاب في إبليس في لحظة واحدة من عالم الخير إلى عالم الشر، فيمكن أن يتصوّر الانقلاب في الإنسان من عالم الشر إلى عالم الخير إذا كان ما بدأ به عالمَ الخير يعدُّ حسنةً في حجمها وتأثيرها أعظم بكثير من السيئات التي ارتكبها.
وهذا ما صدر من الحر، فإن نصرة الحسين حسنةٌ لا تضاهيها حسنةٌ، وإن نصرة الحسين  في ذلك الوقت الذي قلَّ فيه الناصر، وخذل فيه الصديق، وشمت فيه العدو، وأحيط أهل البيت من جميع الجهات في أرض ضيقة، وهي أرض كربلاء، حوصروا بلا ماء ولا سلاح ولا أنصار، كانت تلبية الحسين في ذلك اليوم من أعظم القربات، ومن أعظم الطاعات، لذلك كانت هذه التلبية كفيلةً بتغيير تلك الذات من عالم مظلم إلى أفق مشرق مضيء.
في ذلك الوقت الذي قلَّ فيه الناصر، وخذل فيه الصديق، وشمت فيه العدو، وأحيط أهل البيت من جميع الجهات في أرض ضيقة، وهي أرض كربلاء، حوصروا بلا ماء ولا سلاح ولا أنصار، كانت تلبية الحسين في ذلك اليوم من أعظم القربات، ومن أعظم الطاعات، لذلك كانت هذه التلبية كفيلةً بتغيير تلك الذات من عالم مظلم إلى أفق مشرق مضيء.
ثانيًا: تأثير الجذور الطيبة.
تغيّر الإنسان من حالٍ إلى حالٍ قد يستند إلى جذورٍ طيّبةٍ في شخصيته. ربما نجد كثيرًا من المنحرفين لهم أعمال حسنة، هم منحرفون، هم مصرّون على المنكرات والمعاصي، لكنهم مثلًا يتمتّعون بصلة الرحم، يتمتّعون مثلًا بالصدقة على الفقراء، يتمتّعون مثلًا بالشفقة على الآخرين، قد تجد إنسانًا منحرفًا لكنه يعيش في طياته جذورَ الصلاح، وجذور الطيب، كصلة الرحم، كالصدقة على الفقراء، كبر الوالدين، وإن كان إنسانًا منحرفًا. هذه الجذور الطيّبة تؤهّله لأن يختم حياته خاتمة حسنة، الجذور الطيبة في شخصية الإنسان قد تتطوّر في لحظة من اللحظات، وتتسامى في لحظة من اللحظات لتؤهّل هذا الإنسان لأن يكون سعيدًا في خاتمته، لأن يختم حياته بخاتمة مباركة يحسده عليها الآخرون.
وهذا ما كان في الحر بن يزيد الرياحي، نحن نلاحظ في هذا اللقاء - لقاء الحسين مع الحر بن يزيد - أن هناك جذورًا مباركة في شخصيته، صلى مع الحسين صلاة الظهر والعصر، وهذا يعني أنّه كان يرى الحسين قدوةً صالحةً، مع أنه جاء لأسر الحسين. عندما قال له الحسين: ثكلتك أمّك يا حر! ردَّ بذلك الكلام المؤدّب، وقال: ما لي لذكر أمك من سبيل إلا بأحسن ما يُقْدَر عليه. وعندما قال له الحسين: والله لا أتبعك، قال: خذ طريقًا لا يدخلك الكوفة ولا يرجعك المدينة ليكون نصفًا بيني وبينك وعذرًا لي، ثم قال: لعلّ الله يأتي من ذلك بأمر يرزقني فيه العافية من أن أبتلى بشيء من أمرك.
أي أنه كان شديد الحذر من أن يقع في مظلمة أهل البيت، حتى لا يتورط بظلامة لآل بيت رسول الله  ، فهذه الجذور الطيبة التي توفرت في شخصية الحر بن يزيد الرياحي تكشف عن استعداد داخلي لأن يختم حياته بهذه الخاتمة الحسنة، وفعلًا كان له ما أراد، فإنه في يوم يوم عاشوراء لما استعر القتال، وقامت المعركة على قدم وساق، التفت إلى عمر بن سعد وقال: أمصر أنت على قتال هؤلاء؟ قال: نعم قتالًا أهونه أن تقطع الرؤوس وتطير الأيدي، فإذا بالحر يقبل على الحسين ويقول: إني أخيّر نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئًا أبدًا. إذن، تلك الجذور الصالحة في شخصيته هي التي أهّلته وجعلته صاحبَ استعدادٍ، وجعلته صاحبَ تأهّلٍ لأن ينال هذه الخاتمة السعيدة والشهادة العظمى.
، فهذه الجذور الطيبة التي توفرت في شخصية الحر بن يزيد الرياحي تكشف عن استعداد داخلي لأن يختم حياته بهذه الخاتمة الحسنة، وفعلًا كان له ما أراد، فإنه في يوم يوم عاشوراء لما استعر القتال، وقامت المعركة على قدم وساق، التفت إلى عمر بن سعد وقال: أمصر أنت على قتال هؤلاء؟ قال: نعم قتالًا أهونه أن تقطع الرؤوس وتطير الأيدي، فإذا بالحر يقبل على الحسين ويقول: إني أخيّر نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئًا أبدًا. إذن، تلك الجذور الصالحة في شخصيته هي التي أهّلته وجعلته صاحبَ استعدادٍ، وجعلته صاحبَ تأهّلٍ لأن ينال هذه الخاتمة السعيدة والشهادة العظمى.
فسار الحسين  وسار في أصحابه، وقال له الحر: يا حسين، إني أذكّرك الله في نفسك؛ فإني أشهد لأن قاتلتَ لتقتلن. ولم يكن هذا عنفًا مع الحسين، وإنما كان شفقةً من الحر على الحسين
وسار في أصحابه، وقال له الحر: يا حسين، إني أذكّرك الله في نفسك؛ فإني أشهد لأن قاتلتَ لتقتلن. ولم يكن هذا عنفًا مع الحسين، وإنما كان شفقةً من الحر على الحسين  ، فقال له الحسين: أبالموت تخوّفني؟! وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني؟! سأقول كما قال أخو الأوس لابن عمه وهو يريد نصرة رسول الله، فخوّفه ابن عمه وقال: أين تذهب فإنك مقتول؟! فقال:
، فقال له الحسين: أبالموت تخوّفني؟! وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني؟! سأقول كما قال أخو الأوس لابن عمه وهو يريد نصرة رسول الله، فخوّفه ابن عمه وقال: أين تذهب فإنك مقتول؟! فقال:
| سأمضي وما بالموت عارٌ على الفتى وواسى الرجال الصالحين بنفسه فإن عشت لم أسلم وإن متُّ لم ألم |
إذا ما نوى حقًّا وجاهد مسلمًا وفارق مثبورًا وباعد مجرمًا كفى بك ذلًا أن تعيش وترغما |
هنا تحدث الحسين  عن أنه لا يخاف الموت، وأنه يعشق الشهادة، وتمثّل بأبيات أخي الأوس التي تضمنت ثلاثة مضامين عظيمة استشهد الحسين بها حتى يبيّن للتاريخ وللأجيال هذه المضامين العظيمة في شخصيته.
عن أنه لا يخاف الموت، وأنه يعشق الشهادة، وتمثّل بأبيات أخي الأوس التي تضمنت ثلاثة مضامين عظيمة استشهد الحسين بها حتى يبيّن للتاريخ وللأجيال هذه المضامين العظيمة في شخصيته.
المضمون الأول: الفخر بالشهادة.
الموت ليس عيبًا وليس عارًا، وإنما هو فخرٌ واعتزازٌ، إذا كان هذا الموت في طريق الجهاد، سأمضي وما بالموت عار على الفتى، ليس عارًا أن يقال: قُتِل الحسينُ وهزمه الأعداء، هذا ليس عارًا، إنما العار أن يقال: إن الحسين بايع يزيد بن معاوية، واستسلم لقسر يزيد ولسلطة يزيد، فالموت في طريق إباء الظلم والضلال مفخرةٌ، وليس عارًا.
وهذا تطبيقٌ من الحسين  للآية المباركة: ﴿إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾، القرآن يعبّر عنه بأنه الفوز، فكيف يعتبر خسارة؟! القرآن يعبّر عنه بأنه بشارة، فكيف يعتبر خسارة؟! الحسين
للآية المباركة: ﴿إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾، القرآن يعبّر عنه بأنه الفوز، فكيف يعتبر خسارة؟! القرآن يعبّر عنه بأنه بشارة، فكيف يعتبر خسارة؟! الحسين  يقول بأنَّ الموت في طريق الحق بشرى بشّرنا بها الله، وفوزٌ وعدنا به الله، فكيف يعتبر عارًا؟! الهزيمة العسكرية في طريق الحق انتصارٌ إنسانيٌ ومعنويٌ للحق وللفضيلة.
يقول بأنَّ الموت في طريق الحق بشرى بشّرنا بها الله، وفوزٌ وعدنا به الله، فكيف يعتبر عارًا؟! الهزيمة العسكرية في طريق الحق انتصارٌ إنسانيٌ ومعنويٌ للحق وللفضيلة.
المضمون الثاني: مواساة المصلحين.
| وواسى الرجال الصالحين بنفسه | وفارق مثبورًا وباعد مجرمًا |
وهذا منطلق قرآني آخر، وهو الانطلاق لنصرة الرجال المصلحين، القرآن نصَّ على هذا الانتصار وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾، وقال: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾، فالحسين  يقول: إنَّ من المضامين السامية أن يدخل الإنسان في سلك الرجال المصلحين، ليكون دخوله في هذا السلك مواساةً لهم على طريقهم، لأن الإنسان إذا لم يجد أحدًا ينصره في طريق الصلاح قد يصيبه الإحباط واليأس، الحسين يقول: أنا ناصرٌ لكل الرجال المصلحين، حجر بن عدي قتله معاوية وهو في طريق الإصلاح، كميل بن زياد قتله عبيد الله بن زياد وهو في طريق الإصلاح، صحابة أمير المؤمنين قتلهم الأمويون وهم في سبيل الإصلاح، فخروجي هذا مواساةٌ لهم في طريق الإصلاح.
يقول: إنَّ من المضامين السامية أن يدخل الإنسان في سلك الرجال المصلحين، ليكون دخوله في هذا السلك مواساةً لهم على طريقهم، لأن الإنسان إذا لم يجد أحدًا ينصره في طريق الصلاح قد يصيبه الإحباط واليأس، الحسين يقول: أنا ناصرٌ لكل الرجال المصلحين، حجر بن عدي قتله معاوية وهو في طريق الإصلاح، كميل بن زياد قتله عبيد الله بن زياد وهو في طريق الإصلاح، صحابة أمير المؤمنين قتلهم الأمويون وهم في سبيل الإصلاح، فخروجي هذا مواساةٌ لهم في طريق الإصلاح.
المضمون الثالث: عزة الدين.
فإن عشت لم أسلم «سأقتل على كل حال» وإن لم مت لم ألم «لن أكون ملومًا، لم؟» كفى بك ذلًا أن تعيش وترغما «أن تعيش مرغومًا مكرهًا». الحسين يصرّ هنا على أن العيش تحت حكومة يزيد ذل، ليس إذلالًا للحمه ولجسمه، وإنما هو إذلالٌ للدين؛ لأن الدين يتمثّل في شخصيته، فقتله عزّةٌ للدين، وعيشه إذلالٌ للدين، وقد قال تبارك وتعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾، فمن منطلق الحفاظ على عزة الدين جاهد الحسين وأصر على الشهادة.