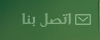بسم الله الرحمن الرحيم
﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾
صدق الله العلي العظيم
الآية المباركة تتحدث عن مبدأ التقية، وحديثنا حول مبدأ التقية في نقطتين:
- المنظور الخلقي لمبدأ التقية.
- الحديث حول ظاهرة الازدواجية.
النقطة الأولى: المنظور الخلقي لمبدأ التقية.
هناك اعتراضٌ واضحٌ على المذهب الإمامي، وهو أن من القواعد الفقهية المسلَّمة في الفقه الإمامي قاعدة التقية، كما عن الإمام الصادق  : ”التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له“، ويقول: ”تسعة أعشار الدين في التقية“، ولكن التقية تربّي أبناء التشيع على تلون الشخصية وظاهرة الازدواجية، فالشيعي يتربى على أن يكون ذا شكلين وذا لونين، وذلك لأن مبدأ التقية يربي الفرد الشيعي منذ البداية على أن يتمتع بشخصية مزدوجة ذات لونين: لون في داخل بيته، ولون في خارج بيته، فيكون تعامله داخل البيت مختلفًا عن تعامله خارج البيت.
: ”التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له“، ويقول: ”تسعة أعشار الدين في التقية“، ولكن التقية تربّي أبناء التشيع على تلون الشخصية وظاهرة الازدواجية، فالشيعي يتربى على أن يكون ذا شكلين وذا لونين، وذلك لأن مبدأ التقية يربي الفرد الشيعي منذ البداية على أن يتمتع بشخصية مزدوجة ذات لونين: لون في داخل بيته، ولون في خارج بيته، فيكون تعامله داخل البيت مختلفًا عن تعامله خارج البيت.
إذن فالتقية تربي الفرد الشيعي على مرض خلقي مقيت جدًا، ألا وهو مرض الازدواجية، بحيث تصبح شخصيته شخصية متلونة متعددة، فالطفل يتربى منذ بداية صغر سنه على قول: «اللهم صل على محمد وآل محمد» داخل البيت، وعلى قول: «اللهم صل عليه وسلم» خارج البيت مثلاً، وكذلك يتربى منذ البداية على أنه إذا توضأ داخل البيت فعليه أن يمسح رأسه ورجليه، ولكن إذا توضأ للصلاة خارج البيت فإنه يمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه.
هذا التعدد في الأسلوب ينمي الطفل منذ البداية على شخصية مزدوجة تتعامل بلونين وبأسلوبين وبمظهرين، وهذا يعني بالتالي أن مبدأ التقية يقود إلى مرض خلقي لا أنه يقود إلى هدف نبيل.
نحن عندما نريد أن ندافع عن مبدأ التقية كمبدأ أساسي عندنا في المذهب الإمامي فلا بد من تسليط الضوء على هذا الاعتراض، وهنا أمران لا بد من الالتفات إليهما حتى نعرف الجواب عن هذا الاعتراض:
الأمر الأول: لا شك في أن التقية مبدأ من مبادئنا الأساسية، ولكن التقية عندنا ليست مطلقة، بل لها حدود واستثناءات، ولا بد من الالتفات إلى هذه الحدود، إذ أن المذهب الإمامي لم يلزمنا بالتقية في تمام الموارد والحقول، بل وضع حدودًا واستثناءاتٍ للعمل بمبدأ التقية، وهي:
الاستثناء الأول: موارد الدم.
يقول علماؤنا: لا تقية في الدماء، فلو أن إنسانًا أكرهك على أن تقتل شخصًا، وقال لك: إما أن تقتل فلانًا وإما أن تُقْتَل، فحينئذٍ لا يجوز لك العمل بالتقية، ولا يصح أن تقول: ما دمتُ متعرضًا للقتل فلأقتل فلانًا حتى أحافظ على نفسي! ليس هذا من موارد التقية؛ لأنه لا ترجيح لنفسك على نفس الشخص الآخر، فإنك نفس محترمة، والشخص الآخر أيضًا نفس محترمة، فلا يصح للإنسان أن يرتكب هذه الجريمة من باب التقية، فقد ورد عن الإمام الباقر  : ”إنما شرّعت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية“، أي أن الهدف من التقية حقن الدم، وأما إذا كانت التقية سببًا لإراقة الدم فلا تشرع التقية ولا تجوز.
: ”إنما شرّعت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية“، أي أن الهدف من التقية حقن الدم، وأما إذا كانت التقية سببًا لإراقة الدم فلا تشرع التقية ولا تجوز.
الاستثناء الثاني: موارد الأمور الواضحة التي لا لبس ولا غموض فيها.
ورد عن الإمام الصادق  : ”ثلاثة لا أتقي فيهن أحدًا: شرب المسكر، والمسح على الخفين، ومتعة الحج“، فالإمام لا يشرب شرابًا مسكرًا بداعي التقية أبدًا، ولا يمسح على الخفين بهدف التقية، ولا يترك متعة الحج بناءً على مبدأ التقية. بعض علمائنا يقولون: هذه أمثلة فقط، وإلا فليست لها خصوصية، وإنما يريد الإمام الصادق أن يقول: الأمور الواضحة بين المسلمين لا تقية فيها، فإن حرمة شرب المسكر أمر واضح لا تقية فيه، والمسح على الخفين ليس واجبًا، فلا مجال للتقية فيه، ومتعة الحج واضحة بين المسلمين فلا تقية فيها أيضًا، وعلى ذلك فالأمور الواضحة التي أدلتها وبراهينها واضحة لا معنى للتقية فيها.
: ”ثلاثة لا أتقي فيهن أحدًا: شرب المسكر، والمسح على الخفين، ومتعة الحج“، فالإمام لا يشرب شرابًا مسكرًا بداعي التقية أبدًا، ولا يمسح على الخفين بهدف التقية، ولا يترك متعة الحج بناءً على مبدأ التقية. بعض علمائنا يقولون: هذه أمثلة فقط، وإلا فليست لها خصوصية، وإنما يريد الإمام الصادق أن يقول: الأمور الواضحة بين المسلمين لا تقية فيها، فإن حرمة شرب المسكر أمر واضح لا تقية فيه، والمسح على الخفين ليس واجبًا، فلا مجال للتقية فيه، ومتعة الحج واضحة بين المسلمين فلا تقية فيها أيضًا، وعلى ذلك فالأمور الواضحة التي أدلتها وبراهينها واضحة لا معنى للتقية فيها.
كذلك نحن الآن في العصر الحديث، حيث أصبح الشيعة واضحين؛ لأنهم يملكون قنوات فضائية وإذاعات وصحفًا ووسائل إعلامية، فأصبحت شعائر المذهب ومراسمه أمورًا واضحة كالشمس يعرفها الكل، فلا لبس ولا غموض فيها، فالتشيع بقواعده الأساسية أصبح أمرًا واضحًا أمام الشاشة العالمية لا لبس ولا غموض فيه، حيث أصبحت أدلتنا وبراهيننا أمورًا واضحة ومنتشرة ومعروفة إعلاميًا.
ولذلك لا معنى للتقية في الإمامة مثلاً، بحيث يقول شخصٌ: أنا لا أقول بأن إمامي علي بن أبي طالب لأنني في تقية! التشيع يعني القول بإمامة علي بن أبي طالب بالنص، وسواء قال الإنسان أو لم يقل يبقى هذا الأمر واضحًا، فهذه الأمور التي أقيمت عليها الأدلة والبراهين، وانتشرت على مختلف بقاع العالم، أصبح لا معنى للتقية فيها، فعلى الشيعي أن يقول بأن إمامه علي بن أبي طالب بالنص، فإن عندنا أدلة كثيرة، كحديث الغدير وحديث المنزلة وحديث الدار، وغيرها من الأدلة الواردة في إمامته والنص عليه بالخلافة.
الاستثناء الثالث: الشعارات المذهبية.
ورد أن الإمام عليًا  قال: ”إنكم ستدعون إلى سبي والبراءة مني، أما السب: فسبوني؛ فإنه لي زكاة ولكم نجاة، وأما البراءة مني: فلا تتبرؤوا مني؛ فإني وُلِدت على الفطرة وسبقت إلى الإسلام والهجرة“، وهي معارَضة برواية أخرى يرويها مسعدة بن صدقة: سألت الإمام الصادق
قال: ”إنكم ستدعون إلى سبي والبراءة مني، أما السب: فسبوني؛ فإنه لي زكاة ولكم نجاة، وأما البراءة مني: فلا تتبرؤوا مني؛ فإني وُلِدت على الفطرة وسبقت إلى الإسلام والهجرة“، وهي معارَضة برواية أخرى يرويها مسعدة بن صدقة: سألت الإمام الصادق  : يروون عن جدك أمير المؤمنين أنه قال على منبر الكوفة: ستدعون إلى سبي والبراءة مني فلا تتبرؤوا مني، فقال الإمام: ”ما أكثر ما يكذب الناس على علي
: يروون عن جدك أمير المؤمنين أنه قال على منبر الكوفة: ستدعون إلى سبي والبراءة مني فلا تتبرؤوا مني، فقال الإمام: ”ما أكثر ما يكذب الناس على علي  ! إنما قال: إنكم ستدعون إلى سبي والبراءة مني، وإني لعلى دين محمد“، قال مسعدة: أرأيت إن اختار القتل دون البراءة؟ قال: ”والله ماذا عليه، وما له إلا ما مضى عليه عمار بن يسار حيث أكرهت على كلمة الكفر فقالها، فنزل فيه ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾، وقال له الرسول
! إنما قال: إنكم ستدعون إلى سبي والبراءة مني، وإني لعلى دين محمد“، قال مسعدة: أرأيت إن اختار القتل دون البراءة؟ قال: ”والله ماذا عليه، وما له إلا ما مضى عليه عمار بن يسار حيث أكرهت على كلمة الكفر فقالها، فنزل فيه ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾، وقال له الرسول  : يا عمار، إن عادوا فعد“.
: يا عمار، إن عادوا فعد“.
نحن لسنا الآن بصدد البحث الفقهي وترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، وإنما نريد أن نقول: هناك شعارات تأصّل بها المذهب، فالمذهب الإمامي تجذّر وتأصّل بهذه الشعائر، وتأصّل بهذه الطقوس، كالشهادة الثالثة في الأذان مثلاً، فإنها وإن لم تكن جزءًا في الأذان، إلا أنها مستحبة، فقد ورد عن الإمام الصادق  : ”من قال: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فليقل: علي أمير المؤمنين“، لكن الشهادة الثالثة أصبحت شعارًا للتشيع، وأصبحت شعارًا لخط علي وأبناء علي
: ”من قال: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فليقل: علي أمير المؤمنين“، لكن الشهادة الثالثة أصبحت شعارًا للتشيع، وأصبحت شعارًا لخط علي وأبناء علي  ، ولذلك السيد الحكيم «قدس سره» في كتاب المستمسك يقول: قد تكون الشهادة الثالثة واجبة بالعنوان الثانوي إذا كانت شعارًا يتوقف عليه استمرار المذهب وثباته.
، ولذلك السيد الحكيم «قدس سره» في كتاب المستمسك يقول: قد تكون الشهادة الثالثة واجبة بالعنوان الثانوي إذا كانت شعارًا يتوقف عليه استمرار المذهب وثباته.
هذه الشعائر - كالشهادة الثالثة، والمآتم، والاحتفال بذكرى الحسين  - لا مجال للتقية فيها، فلا يصح لشخص أن يقول: أنا أتقي فأترك ممارسة هذه الشعارات! هذه شعائر المذهب، فإذا انتفت اضمحلت شوكة المذهب، وإذا انتفت ذابت شعلة المذهب، وإذا انتفت تبخر كيان المذهب، فإن هذه الشعائر تأصّل بها المذهب وتجذّر، وبها يبرز خط علي وأهل بيته، وبه يبرز كيان المذهب، فهذه الشعائر التي عُرِف بها المذهب الإمامي، واتضح بها المذهب الإمامي، لا معنى لتطبيق التقية عليها، إذ أن المذهب قد يندرس من النفوس نتيجة هذا التطبيق الحرفي لمبدأ التقية.
- لا مجال للتقية فيها، فلا يصح لشخص أن يقول: أنا أتقي فأترك ممارسة هذه الشعارات! هذه شعائر المذهب، فإذا انتفت اضمحلت شوكة المذهب، وإذا انتفت ذابت شعلة المذهب، وإذا انتفت تبخر كيان المذهب، فإن هذه الشعائر تأصّل بها المذهب وتجذّر، وبها يبرز خط علي وأهل بيته، وبه يبرز كيان المذهب، فهذه الشعائر التي عُرِف بها المذهب الإمامي، واتضح بها المذهب الإمامي، لا معنى لتطبيق التقية عليها، إذ أن المذهب قد يندرس من النفوس نتيجة هذا التطبيق الحرفي لمبدأ التقية.
ولذلك نقول بأن الشعار العلوي والشعار الفاطمي والشعار الحسيني لا بد من المحافظة عليه، فنحن - أبناء مذهب أهل البيت - لا بد أن نحافظ على هذه الشعارات التي تظهر أننا علويون فاطميون حسينيون، ونستطيع المحافظة على هذه الشعارات من خلال الذوبان في شخصيات أهل البيت  .
.
مثال: في الفترات المتأخرة أصبح الشيعة يبتعدون عن أسماء أهل البيت، مع أن تسمية الأولاد بأسماء أهل البيت يركّز الشعار العلوي والشعار الفاطمي، فعلى الإنسان المؤمن أن يسمي أبناءه بأسماء أهل البيت، وأن يسمي سوقه بأسماء أهل البيت، حتى يبرز أنه علوي فاطمي حسيني، فلتكن أسواقنا بأسماء أهل البيت، فليكن اسم ولدك باقرًا مثلاً، وليكن اسم ابنتك فاطمة أو زينب مثلاً، وليكن اسم سوقك سوق الكاظم، أو سوبرماركت الرضا أو الجواد مثلاً، حتى تعيش في هذه الهالة وفي هذه الموجة الإعلامية، وهي إبقاء شعار أهل البيت  .
.
نحن هنا لا ندعو إلى وضع حواجز طائفية أو إثارة نعرات طائفية، بل بالعكس، نحن مذهبنا هو الذي يدعو إلى تأليف القلوب، وهو الذي يدعو إلى المعاملة الحسنة مع الآخرين، فإن الإمام الصادق  في صحيحة عبد الله بن سنان يقول: ”يا أيها الناس اتقوا الله، ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلوا، عودوا مرضاهم، واحضروا جنائزهم، واشهدوا لهم وعليهم“، فالإمام يأمرنا بالالتقاء بأبناء المذاهب الأخرى. كما ورد عنه
في صحيحة عبد الله بن سنان يقول: ”يا أيها الناس اتقوا الله، ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلوا، عودوا مرضاهم، واحضروا جنائزهم، واشهدوا لهم وعليهم“، فالإمام يأمرنا بالالتقاء بأبناء المذاهب الأخرى. كما ورد عنه  : ”إن الرجل منكم ليكون في القبيلة فيكون زينها: أدّاهم للأمانة، أصدقهم في الحديث، أقضاهم للحقوق، إن الرجل إذا صدق في حديثه، وورع في دينه، وأدى الأمانة، وحسن خلقه مع الناس، قيل: هذا جعفري، وقيل: هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك“، فنحن مأمورون بالمعاملة الحسنة مع الآخرين، لكننا نتعامل مع الآخرين من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى بالصدق والأمانة وأداء الحقوق، وبأخلاق واقعية، وفي نفس الوقت نعتز بارتباطنا بأهل البيت، ونفتخر افتخارًا كبيرًا بأننا علويون فاطميون.
: ”إن الرجل منكم ليكون في القبيلة فيكون زينها: أدّاهم للأمانة، أصدقهم في الحديث، أقضاهم للحقوق، إن الرجل إذا صدق في حديثه، وورع في دينه، وأدى الأمانة، وحسن خلقه مع الناس، قيل: هذا جعفري، وقيل: هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك“، فنحن مأمورون بالمعاملة الحسنة مع الآخرين، لكننا نتعامل مع الآخرين من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى بالصدق والأمانة وأداء الحقوق، وبأخلاق واقعية، وفي نفس الوقت نعتز بارتباطنا بأهل البيت، ونفتخر افتخارًا كبيرًا بأننا علويون فاطميون.
نحن عندما نحافظ على هذه الشعارات، بحيث تكون أسماء أهل البيت في أسرنا، وفي أسواقنا، وفي مشاريعنا، وفي مآتمنا، وتكون الشهادة الثالثة في أذاننا، وتكون مآتم الحسين في مجالسنا ومحافلنا، فإننا لا نركز على كل ذلك بداعي النعرات الطائفية، ولا الحواجز المذهبية، وإنما بداعي الافتخار بانتسابنا لأهل البيت، وبداعي الاعتزاز بارتباطنا بأهل البيت، وأننا نطبق الآية المباركة بأجلى مصاديقها: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾، فمحبة أهل البيت ليست محبة قلبية خامدة لا معنى لها، بل على من يقول بأنه يحب أهل البيت أن يظهر هذا الحب على سلوكه وعلى تصرفاته. أنا إذا سميتُ أبنائي بأسماء أهل البيت وأقمتُ محافل أهل البيت فقد أظهرتُ الحبَّ بأروع مصاديقه وأجلى صوره، وكنت ممن امتثل نداء القرآن الكريم حيث أمر بمودة القربى.
إذن نريد أن نقول بعبارة واضحة: التقية من مبادئنا، لكن لها حدودًا واستثناءاتٍ، فعلى الإنسان ألا يعمل بالتقية إلى حد يميّع المذهب، ولا إلى حد تتبخر فيه جذوة المذهب، ويضمحل فيه كيان المذهب الإمامي.
الأمر الثاني: فلسفة التقية.
المذهب الإمامي أسّس مبدأ التقية، وأصر عليه تطبيقًا للآية المباركة: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾، لا من باب التربية على ظاهرة الازدواجية، بل من باب ترجيح المصالح العامة للمجتمع الإسلامي على الخلافات الفرعية، إذ أن علماءنا يقسمون التقية إلى قسمين: تقية خوفية وتقية مداراتية، فإذا تعرض الإنسان لخطر على النفس أو على العرض أو على المال المعتد به جاز له أن يعمل بالتقية الخوفية، وأما التقية المداراتية فهي أمر مختلف.
مثال: إذا ذهب حجّاج بيت الله الحرام إذا ذهبوا إلى المدينة المنورة وإلى مكة المكرمة فلعل الشيعة يشكّلون ثلث الحجّاج، فلو قاطع الشيعة الصلاة في المسجد الحرام، وقالوا بأنهم لا يصلون مع إمام المسجد الحرام ولا مع إمام المسجد النبوي، وصاروا يخرجون في أوقات الصلوات ويأتون في غير أوقات الصلوات إلى زيارة المساجد، حينئذٍ يترتب على هذا العمل إثارة الشحناء والأحقاد بين المسلمين، فإن المسلمين إذا رأوا أن الشيعة - الذين يأمرهم أئمتهم بالمعاملة الحسنة مع الآخرين من أبناء المذاهب الإسلامية - يحتقرون المذاهب الإسلامية الأخرى، ولا يصلون خلف أئمتهم، ولا يحضرون أوقات الصلاة معهم، فإن الأحقاد والنعرات المذهبية تثار، وتثار الأسئلة والاستفهامات التي تجعل الشيعي في موضع النبذ والاتهام.
ومن هنا خطّط أهل البيت لذلك، من أجل ترجيح المصلحة العامة على الخلافات الفرعية، فنحن لا نريد أن نعمل بالتقية في مسألة الإمامة؛ لأن الإمامة أصلٌ من أصول المذهب، فلا نعمل بالتقية فيها، وإنما نعمل بالتقية في الخلافات الفرعية، وذلك لأن الأئمة  رجّحوا المصلحة العامة للمجتمع الإسلامي على هذه الخلافات الفراعية.
رجّحوا المصلحة العامة للمجتمع الإسلامي على هذه الخلافات الفراعية.
مثلاً: الشخص الآخر يتكتف أثناء الصلاة بينما أنت تسبل يديك في الصلاة، وهو يسجد على الزل بينما أنت تسجد على التراب أو ما كان من أجزاء الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس، فهذا خلاف بينك وبين المذاهب الإسلامي في أمور فرعية، وهنا يقول الأئمة: كون المسلمين صفًا واحدًا وقلبًا واحدًا، وكونهم ناظرين للأهداف المشتركة العليا للأمة الإسلامية، وكونهم يعيشون جوًا من التآلف والتعاطف والتراحم، مصلحةٌ إسلامية عليا، وهذه المصلحة الإسلامية مقدّمة على هذه الخلافات الفرعية.
إذن فنحن نصلي خلف أئمة الحرمين، ولكن غاية ما في الأمر أننا نقرأ الفاتحة والسورة بنفسنا، ويجوز لنا إذا إذا صلينا مع إمام الحرمين أن نسجد على الزل، كما يجوز التكتف إذا اقتضى الأمر ذلك، وإنما نعمل بالتقية في هذا المورد من أجل المداراة، أي: من أجل ترجيح المصالح العامة على الخلافات الفرعية، ففلسفة التقية تكمن في هذه النقطة. والخلاصة أن هدف التقية هو ترجيح المصالح العامة للمجتمع الإسلامي على الخلافات الفرعية بيننا وبين المذاهب الإسلامية الأخرى.
من هنا يتضح لنا الجواب عن الاعتراض الذي ذكرناه في أول المحاضرة، فإن ذلك الاعتراض يقول بأن التقية تربي الفرد الشيعي على ظاهرة ازدواجية، بحيث يكون شخصية لها شكلان ونوعان، ولكننا نقول بأن التقية تربي الفرد الشيعي على أن يراعي المصالح العامة للمجتمع الإسلامي، وأن يقدّمها على الخلافات الفرعية، فالتقية تربّي الفرد الشيعي على أن يهتم بالأهداف العليا للمجتمع الإسلامي، وعلى ألا يفرّط بالأهداف المشتركة للمجتمع الإسلامي، وأن يكون قلبًا وضميرًا للإسلام، ومشاعر وعواطف تعيش هموم المسلمين وأوضاعهم.
ورد عن الإمام علي  : ”لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين“، وهذا ما عبّرنا عنه بمراعاة الأهداف العامة على الخلافات المذهبية الفرعية. ولذلك نرى أن الشيعة في كل زمان من أكثر الطوائف إخلاصًا للإسلام، والشيعة في كل زمان وفي كل جيل يمر على الأمة الإسلامية هم من أكثر المذاهب الإسلامية إخلاصًا للإسلام وتضحيةً وعطاء في سبيله وخدمةً له، فنراهم في كل جيل هم الذين يتقدمون الركب، وهم الذين يبذلون ويضحون ويعطون في سبيل خدمة الإسلام؛ لأن أئمتهم ربوهم على أن الأهداف الإسلامية العليا مقدمة على كل خلاف فرعي. ومن هذا المنطلق - منطلق تقديم المصلحة العامة للمجتمع الإسلامي على الخلافات الفرعية المذهبية - تأسّس مبدأ التقية، فليس مبدأ التقية سببًا لظاهرة الازدواجية، بل هو سبب لتربية الفرد على مراعاة الأهداف الإسلامية العليا.
: ”لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين“، وهذا ما عبّرنا عنه بمراعاة الأهداف العامة على الخلافات المذهبية الفرعية. ولذلك نرى أن الشيعة في كل زمان من أكثر الطوائف إخلاصًا للإسلام، والشيعة في كل زمان وفي كل جيل يمر على الأمة الإسلامية هم من أكثر المذاهب الإسلامية إخلاصًا للإسلام وتضحيةً وعطاء في سبيله وخدمةً له، فنراهم في كل جيل هم الذين يتقدمون الركب، وهم الذين يبذلون ويضحون ويعطون في سبيل خدمة الإسلام؛ لأن أئمتهم ربوهم على أن الأهداف الإسلامية العليا مقدمة على كل خلاف فرعي. ومن هذا المنطلق - منطلق تقديم المصلحة العامة للمجتمع الإسلامي على الخلافات الفرعية المذهبية - تأسّس مبدأ التقية، فليس مبدأ التقية سببًا لظاهرة الازدواجية، بل هو سبب لتربية الفرد على مراعاة الأهداف الإسلامية العليا.
النقطة الثانية: ظاهرة الازدواجية.
ظاهرة الازدواجية موجودة في مجتمعاتنا الإسلامية، ولا فرق بين الشيعة والسنة في انتشار هذه الظاهرة وشيوعها، فإن البعض منا يحافظ على الصلاة والصوم ويحافظ على المسجد، لكنه لا يمتنع عن حضور الحفلات الفندقية المشتملة على الغناء والموسيقى المطربة وبعض ألوان المجون، بل يقول: أنا أحافظ على الصلاة والصوم، ولكنني في نفس الوقت أجامل أبناء المجتمع، فأحضر أعراسهم وحفلاتِهم ولو تضمنت ألوانًا من الغناء وألوانًا من الموسيقى المطربة وألوانًا من مظاهر المجون والفسق! هؤلاء خلطوا عملاً صالحًا وآخر سيئ.
البعض منا لا يمتنع أبدًا من أن يعيش هكذا، بل يقول: أنا إنسانٌ متدينٌ ملتحٍ أحضر المسجد، ولكنني لا أمتنع أن أقيم علاقة غير مشروعة من خلال الوظيفة، أو من خلال السوق، أو من خلال الشارع، مع الجنس الآخر، ويمكنني الجمع بين الأمرين! هذه تسمّى ظاهرة الازدواجية، فالشخصية المزدوجة تتدين من جهة - حيث تصلي وتصوم - وتنحرف من جهة أخرى، فلا تمتنع عن إقامة العلاقات غير المشروعة، ولا عن استماع الغناء، ولا عن حضور الحفلات الغنائية، بل إن الإنسان صاحب الشخصية الازدواجية قد لا يبالي حتى بأبنائه، فلا يمانع أن يستمعوا للأغاني، ولا يمانع أن يقيموا علاقات غير مشروعة. وكذلك حال الفتاة، فقد تكون فتاة متدينة، بمعنى أنها تصلي وتصوم، لكنها في نفس الوقت لا تلتزم بالحجاب حدوده الشرعية، ولا تلتزم بألا تقيم بعض العلاقات غير المشروعة مع الطرف الآخر، وهذه هي ظاهرة الازدواجية.
أكبر مرض يفتك بالمجتمع الإسلامي هو مرض الازدواجية، وأشد خطر يخيّم على المجتمع الإسلامي هو خطر الازدواجية، فإن الإنسان عندما تكون شخصيته شخصية مزدوجة يشعر بصراع حاد في داخل نفسه: كيف يجمع بين الأفقين؟ وكيف يجمع بين اللونين والشكلين؟ كيف يقف أمام ربه ويقول: رب اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني وتب عليَّ، وفي نفس الوقت ينتظر الموعد مع الفتاة، أو ينتظر الموعد مع المعصية، أو ينتظر الموعد مع الفيلم الخلاعي، فأنى للإنسان أن يعيش هذا الصراع الحاد في داخل نفسه؟! هو من جهة يريد أن يصلي حتى يكون متدينًا، فهو يحب الصلاة والصوم والمسجد والأمور الخيرية والقربات، ولكنه في نفس الوقت يلتذ بالمعصية، ويلتذ بالعلاقة غير المشروعة، ويلتذ باستماع الأغنية، ويلتذ باستماع الأغنية، ويلتذ بمشاهدة الفيلم الخلاعي، ويلتذ بالنوع الآخر من العمل والسلوك.
هذه الشخصية المزدوجة إن أفلحت في الدنيا فهي مفلسةٌ في الآخرة، وإنما هي أيام معدودة، فإذا انتقل الإنسان إلى ربه لم يعرف للازدواجية معنى، فإن كل ما عمله من عمل صالح تبخر وذهب كأدراج الرياح؛ لأنه لوّث أعماله الصالحة ولطّخها بأعماله السيئة، فأي عمل صالح بقي له وقد لوّثه بالمعاصي والذنوب؟! أي صلاة وأي صوم وأي حج وأي مسجد يبقى صفحةً بيضاء وقد سوّدها بالذنوب والمعاصي التي ارتكبها واحتطبها وأصر على الاستمرار فيها؟! كيف يجتمع الأمران؟!
يقول القرآن الكريم: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾، أي أن العمل ذهب سدى، فبينما هو يعيش متمتعًا بصحته وعافيته، ومغرورًا بالدنيا ومفاتنها وزبرجها، ويعيش مرض الازدواجية، وإذا به في لحظة واحدة لسكتة أو لحادث ينتقل إلى ربه، فيفاجَأ بعالم مظلم، ويفاجَأ بأجواء سواد، ويفاجَأ بقبر موحش مظلم، فأين هي أعماله الصالحة؟! أين صلاته وأين صومه وأين وأين؟! كلها ذهبت ولم تبق إلا تلك الأوساخ وتلك الأوحال وتلك الرواسب التي ملأ بها عينه ويده وأذنه وجميع جوارحه، حيث عمر جوانحه وجوارحه بالمعصية لأنه يحب اللونين والشكلين. وأهم أسباب مرض الازدواجية سببان، وإذا عرفنا الأسباب عرفنا طرق العلاج:
السبب الأول: الاستهانة بالذنب.
ورد عن النبي  : ”أشد الذنوب ما استهان به صاحبه“، فهذه الاستهانة أشد من الذنب الكبير. الإنسان عندما يستمع أغنية ويقول: أنا لم أرتكب عملية زنا، وإنما استمعت أغنية، فهذا مجرد ذنب عادي! وإذا حضر جلسة غنائية قال: لم أحضر مائدة خمر وإنما حضرت حفلة غنائية ليس إلا! وإذا حضر مائدة خمر قال: ما المشكلة في ذلك؟! أنا لم أشرب خمرًا وإنما حضرت على المائدة ليس إلا! وإذا صار في علاقة غير مشروعة مع فتاة قال: هذه أيام معدودة وستنتهي وبعد ذلك أتوب إلى ربي وأرجع عن هذه الذنوب والمعاصي! وإذا ارتكب عملية الزنا قال: أنا لست أول واحد، بل إن كثيرين قد ارتكبوا هذه العملية، والكثير من أبناء المجتمع ينقاد وراء شهوته وغريزته حتى يرتكب عملية الزنا!
: ”أشد الذنوب ما استهان به صاحبه“، فهذه الاستهانة أشد من الذنب الكبير. الإنسان عندما يستمع أغنية ويقول: أنا لم أرتكب عملية زنا، وإنما استمعت أغنية، فهذا مجرد ذنب عادي! وإذا حضر جلسة غنائية قال: لم أحضر مائدة خمر وإنما حضرت حفلة غنائية ليس إلا! وإذا حضر مائدة خمر قال: ما المشكلة في ذلك؟! أنا لم أشرب خمرًا وإنما حضرت على المائدة ليس إلا! وإذا صار في علاقة غير مشروعة مع فتاة قال: هذه أيام معدودة وستنتهي وبعد ذلك أتوب إلى ربي وأرجع عن هذه الذنوب والمعاصي! وإذا ارتكب عملية الزنا قال: أنا لست أول واحد، بل إن كثيرين قد ارتكبوا هذه العملية، والكثير من أبناء المجتمع ينقاد وراء شهوته وغريزته حتى يرتكب عملية الزنا!
وهكذا يعوّد على استصغار الذنب واستحقاره، ويعوّد نفسه على أن الذنوب مجرد أشياء عابرة لا تضر ولا تلوّث نفسه، والحال أن الرسول  يقول: ”أشد الذنوب ما استهان به صاحبه“؛ لأن هذا الذنب يرّبي عند الإنسان الجرأة على الذنب، فإن الإنسان إذا أذنب ووبّخ نفسه، بحيث بمجرد أن يلتفت إلى أنه أذنب يبكي ويتحسر، ويوبّخ نفسه ويعنفها، ويلقي على نفسه الويلات، ويذكّر نفسه بعذاب القبر وبعذاب الآخرة وبعذاب النار، فإن هذا الإنسان يمكن أن يرجع إلى حظيرة الطاعة.
يقول: ”أشد الذنوب ما استهان به صاحبه“؛ لأن هذا الذنب يرّبي عند الإنسان الجرأة على الذنب، فإن الإنسان إذا أذنب ووبّخ نفسه، بحيث بمجرد أن يلتفت إلى أنه أذنب يبكي ويتحسر، ويوبّخ نفسه ويعنفها، ويلقي على نفسه الويلات، ويذكّر نفسه بعذاب القبر وبعذاب الآخرة وبعذاب النار، فإن هذا الإنسان يمكن أن يرجع إلى حظيرة الطاعة.
وأما الإنسان الذي إذا أذنب استصغر ذنبه فإنه يتعوّد على الجرأة على الذنب، ويتعوّد على التجاسر على المعاصي، إلى أن يصبح الذنب أمرًا عاديًا مقبولاً، فيكون منافقًا من حيث لا يشعر، فقد ورد عن الإمام علي  : ”المؤمن إذا أذنب كان ذنبه على قلبه أشد من جبل أبي قبيس، والمنافق إذا أذنب كان ذنبه كذبابة مرت على وجهه فأبعدها“، أي أن الإنسان المؤمن يشعر بثقل الذنب بحيث يريد أن يزيحه بالتوبة والإنابة بمختلف الوسائل، كما قال تعالى: ﴿تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾، وأما الإنسان المستهتر بالذنوب فإنه يصبح منافقًا، ويصبح شخصية مزدوجة لها لونان وشكلان، وكل ذلك نتيجة الاستهانة بالذنوب.
: ”المؤمن إذا أذنب كان ذنبه على قلبه أشد من جبل أبي قبيس، والمنافق إذا أذنب كان ذنبه كذبابة مرت على وجهه فأبعدها“، أي أن الإنسان المؤمن يشعر بثقل الذنب بحيث يريد أن يزيحه بالتوبة والإنابة بمختلف الوسائل، كما قال تعالى: ﴿تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾، وأما الإنسان المستهتر بالذنوب فإنه يصبح منافقًا، ويصبح شخصية مزدوجة لها لونان وشكلان، وكل ذلك نتيجة الاستهانة بالذنوب.
ورد عن علي  : ”يا بني، اجتنبوا الكذب الصغير منه والكبير، في كل جد وزهل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير“، وورد عنه
: ”يا بني، اجتنبوا الكذب الصغير منه والكبير، في كل جد وزهل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير“، وورد عنه  : ”من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه“، فكيف يفطم من هذا الذنب؟! وكيف يتراجع عنه مرة أخرى؟! وكيف تؤمل منه التوبة والإنابة؟!
: ”من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه“، فكيف يفطم من هذا الذنب؟! وكيف يتراجع عنه مرة أخرى؟! وكيف تؤمل منه التوبة والإنابة؟!
السبب الآخر: النظر إلى الدين نظرًا شكليًا صوريًا.
الكثير منا يرى الدين شكلاً وصورة، فيتصور أن الدين هو أن يصلي الإنسان ويصوم ويحج ويخمّس ويطيل لحيته ويحمل مسباحًا! هذا ليس هو الدين، بل هذه مجرد مظاهر وأشكال وصور وطقوس للدين، وأما الدين فهو مضمون يعشعش في القلب ويتجذر في الروح ويتأصّل في النفس، ولذلك ورد عن الإمام زين العابدين  : ”لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم؛ فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركهما استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة“. هل الدين يعيش في قلبه؟! هل الدين يعيش داخل نفسه؟! إذا كان الدين يعيش في قلبه فسوف يكون صادقًا أمينًا، وسوف يكون إنسانًا يراقب الله ويخافه، وأما إذا كان الدين يعيش على لسانه فقط، ولا يمتد إلى قلبه، ويعيش على يديه ورجليه ولا يمتد إلى روحه، فإنه صاحب شخصية مزدوجة.
: ”لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم؛ فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركهما استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة“. هل الدين يعيش في قلبه؟! هل الدين يعيش داخل نفسه؟! إذا كان الدين يعيش في قلبه فسوف يكون صادقًا أمينًا، وسوف يكون إنسانًا يراقب الله ويخافه، وأما إذا كان الدين يعيش على لسانه فقط، ولا يمتد إلى قلبه، ويعيش على يديه ورجليه ولا يمتد إلى روحه، فإنه صاحب شخصية مزدوجة.
إذن فالدين مضمون وليست صورة، ولذلك من الخطأ أن تظن الفتاة المتدينة أن الحجاب شكل، بحيث تتصور أن الحجاب هو أن تلبس العباءة وتستر شعرها! هذا ليس هو الحجاب، بل هو مظهر الحجاب وشكله، وأما الحجاب فهو ملكة العفاف التي تخيّم على القلب، فهذا حجاب ظاهري، ووراءه حجاب معنوي وباطني، وهو حجاب العفاف، فليس الحجاب عباءة ولا سترة، ولا أن تستر شعرها، وإن كان ذلك واجبًا شرعًا، لكنه طقس ومظهر، وأما الحجاب الأساسي فهو أن تكون عفيفة وقورة بعيدة عن العلاقات مع الرجل الأجنبي، وأن تكون بعيدة عن أجواء الفتنة والإثارة وتهييج الغرائز والمشاعر، وهذا هو الحجاب الحقيقي.
والخلاصة: أننا إذا نظرنا إلى الدين نظرة صورية فيمكن الجمع بين الدين وبين المعصية، ولكن إذا نظرنا إلى الدين نظرة واقعية روحية فليس من صلى وصام وحج وخمّس والتحى وثابر على المسجد لكنه يمارس علاقة غير مشروعة بإصرار متدينًا، وإنما هو في صورة المتدين.
من هنا لا بد أن نركز على فهم الدين حتى نبتعد عن ظاهرة الازدواجية، فلا بد أن نعرف الدين شكلاً ومضمونًا، مظهرًا وجوهرًا، ولا بد من أن نعرف أن الدين عطاء وبذل وطاقة وجهد، كما عرف الدين أبطال الدين، كالحسين بن علي وأنصار الحسين الذين عرفوا الدين معرفة تامة، هؤلاء الذين يروي عنهم المؤرخون أنهم ليلة عاشوراء باتوا قائمين قاعدين راكعين ساجدين، ولهم دويٌ كدوي النحل، يتزودون من العباد، وهذا شكل ومظهر، وكما كان لهم مظهر الدين كان لهم واقع الدين، وكان لهم مضمون الدين، فبمجرد أن قال الحسين لهم: ”أصحابي، هذه رسل القوم إليكم، فقوموا باركوا الله فيكم“، تسابقوا إلى القتال، فكل يريد أن يسبق الآخر للبذل والعطاء والتضحية، فهؤلاء عاشوا الدين شكلاً ومضمونًا، صورةً وواقعًا، وهم المثل الأعلى لنا في النظر إلى الدين نظرة واقعية.