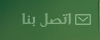بسم الله الرحمن الرحيم
﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾
صدق الله العلي العظيم
هناك بعض الأسئلة التي وردت حول المحاضرة السابقة:
لدليل العقل ولدليل النقل. أما دليل العقل: فهو ما ذكرناه في الليلة السابقة، قلنا: لو لم يوجد الإنسان أجل الكمال الروحي لكان وجوده ظلمًا؛ لأن الإنسان إذا وُجِد في هذه الدنيا يلقى من الألم أكثر مما يلقى من الراحة، الإنسان يلقى من الآلام في هذه الدنيا أضعاف ما يلقى من الراحة، فلو كان قد وُجِد لهدف قصير، وهو هدف دنيوي، لكان إيجاده ظلمًا؛ لأن الله «تبارك وتعالى» عرّضه لآلام أضعاف ما حصل عليه من الراحة، وتعريضه للألم ظلمٌ له، ولذلك العقل يحكم بأنَّه لا بد من وجود هدف آخر غير هذا الهدف القصير، هدف يصاحب الإنسان في وجوده الطويل، وجوده الدنيوي ووجوده الأخروي، والهدف الذي يصاحب الإنسان في مسيرته الطويلة هو الكمال الروحي الذي عبّرنا عنه بالعصمة في الليلة السابقة.
وأما دليل النقل: القرآن الكريم ظاهر في أنَّ الهدف من وجود الإنسان هو الكمال الروحي، في قوله تبارك وتعالى: ﴿خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾، وقال تبارك وتعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ باعتبار أن العبادة طريقٌ لتحصيل الكمال الروحي. إذن فبالنتيجة: العقل والقرآن يدلان على أنَّ الهدف من وجود الإنسان هو الحصول على العصمة، أي: الحصول على الكمال الروحي.
 والإمام
والإمام  ، ولكنَّ الكلام في فهم المقدّس، حتى لو اعترفنا بأنَّ هناك مقدّسًا، ألا وهو القرآن الكريم، فهذا لا يجدي في حل المشكلة؛ لأنَّ المشكلة في فهم المقدّس، المذاهب الإسلامية مختلفة في فهم القرآن، المذاهب الإسلامية مختلفة في فهم كلمات النبي وسيرة النبي، حتى أبناء المذهب الواحد يختلفون في فهم القرآن، يختلفون في فهم كلمات النبي وأهل بيته الطاهرين «صلوات الله عليهم أجمعين»، فإذن المشكلة تعود مرة أخرى: ما هو المقدّس؟ هل هو فهم المذهب الإمامي؟ هل هو فهم المذهب الآخر؟ هل هو فهم الفرقة الفلانية؟ ما هو المقدس؟ مجرد أن عندنا مقدسًا لا يحل المشكلة؛ لاختلاف الأفهام والقراءات.
، ولكنَّ الكلام في فهم المقدّس، حتى لو اعترفنا بأنَّ هناك مقدّسًا، ألا وهو القرآن الكريم، فهذا لا يجدي في حل المشكلة؛ لأنَّ المشكلة في فهم المقدّس، المذاهب الإسلامية مختلفة في فهم القرآن، المذاهب الإسلامية مختلفة في فهم كلمات النبي وسيرة النبي، حتى أبناء المذهب الواحد يختلفون في فهم القرآن، يختلفون في فهم كلمات النبي وأهل بيته الطاهرين «صلوات الله عليهم أجمعين»، فإذن المشكلة تعود مرة أخرى: ما هو المقدّس؟ هل هو فهم المذهب الإمامي؟ هل هو فهم المذهب الآخر؟ هل هو فهم الفرقة الفلانية؟ ما هو المقدس؟ مجرد أن عندنا مقدسًا لا يحل المشكلة؛ لاختلاف الأفهام والقراءات.أما ما اختلف فيه الفقهاء، الفقهاء اختلفوا في الحكم الفلاني، بعض الفقهاء يقول: الكتابي طاهر، بعض الفقهاء يقول: الكتابي نجس، أو اختلفوا في بعض العقائد، بعض الفقهاء يقول: الرجعة ثابتة، بعض العلماء يقول: الرجعة غير ثابتة، ما اختلف فيه العلماء ليس مقدّسًا، وإنما المقدّس ما اتفقوا عليه، وأما ما اختلفوا فيه فهذا ليس مقدّسًا؛ لأن هذا يرجع إلى اختلاف القراءات والتحليلات، التي ترجع إلى الموازين، بمعنى إعمال وتطبيق الموازين العلمية الصحيحة.
أنت فرّقت بين المتدينين والليبراليين، ونحن نلاحظ أن الليبراليين أكثر فعّالية، وأكثر إنتاجًا من المتدينين، المتدينون مشغولون بساحة التنظير، وساحة التفكير والتحليل، بينما الليبراليون عمليون، مشغولون بعالم الإنتاج، وبعالم العمل والعطاء، فحتى لو كان عندنا فكران: فكر ليبرالي وفكر ديني، إلا أن الليبرالين أكثر فعّاليةً وعملًا من المتدينين.
انطلاقًا من الآية المباركة، نتحدث عن نقاط ثلاث، نتكلم هذه الليلة عن النقطة الأولى، وهي الحديث عن أصالة الأخلاق وعدم أصالتها، وهنا أمامنا نظريتان: النظرية الأولى هي أنَّ القيم الخلقية ليست نزعةً أصيلةً لدى الإنسان، وإنَّما القيم الخلقية تختلف باختلاف الجذور الحضارية، وباختلاف الجذور المعرفية. وأما النظرية الثانية فهي أنَّ القيم الأخلاقية نزعات أصيلة لدى النفس الإنسانية.
النظرية الأولى: القيم ليست نزعة أصيلة.
الدكتور محمد عابد الجابري - وهو دكتور معروف - يذكر في كتابه «العقل الأخلاقي العربي» أنَّ الأخلاق والقيم ليست نزعاتٍ أصيلةً، وإنما هي تختلف باختلاف الجذور الحضارية، ويقسّم القيم الأخلاقية إلى خمسة أقسام: الأخلاق اليونانية، والأخلاق الفارسية، والأخلاق الصوفية، والأخلاق العربية، والأخلاق الإسلامية.
القسم الأول: القيم اليونانية.
الحضارة اليونانية ترى أنَّ ركيزة الأخلاق وأساس القيم في السعادة الروحية، السعادة الروحية هي الأساس، فما معنى السعادة الروحية؟ السعادة الروحية معناها السيطرة على النفس بألا تنجرف نحو الإفراط أو نحو التفريط، بل تقع في حالةٍ وسطٍ، كيف؟ هذا ليس موجودًا في الكتب اليونانية فقط، بل هذه النظرة موجودة حتى في كتبنا الإسلامية، كما في جامع السعادات للشيخ النراقي، وفي الميزان للسيد الطباطبائي، النظرية اليونانية مذكورة كنظرية إسلامية.
قوى النفس ثلاث: القوة الشهوية، والقوة الغضبية، والقوة العقلية. القوة الشهوية هي الشهوة التي تلح على الإنسان أن يشبعها، تارة يستخدم الإنسان هذه القوة بإفراط، فيفكر دائمًا بشهوته، وهذه رذيلة تسمى رذيلة الشره، وتارة يستخدمها بتفريط، فلا يستخدم شهوته إلا نادرًا، وهذه أيضًا رذيلة تسمى رذيلة الخمود، وحتى يحرز الإنسان الفضيلة لا بد أن يعيش في حال وسط: لا شره في إشباع الشهوة، ولا خمود في إشباع الشهوة، بل يعيش حالة وسط، وهي ما يسمّى بالعفة، فالعفة هي أن تشبع الشهوة ولكن باعتدال، بحيث لا تؤثر على أعمالك ومسيرة حياتك وبرنامجك.
القوة الثانية هي القوة السبعية، وهي قوة الانفعال عند الإنسان، إذا تعثر ينفعل. القوة السبعية أيضًا هناك من يستخدمها بإفراط، فينفعل ويغضب لأدنى سبب، كما ورد عن النبي محمد  : ”الغضب ضربٌ من الجنون لأن صاحبه يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكمٌ“. وهناك من يستخدم القوة السبعية بتفريط، فلا يغضب إلا نادرًا، وهذا أيضًا يعيش رذيلة، ذاك يعيش رذيلة التهوّر، وهذا يعيش رذيلة الجبن؛ لأن من طبيعة الإنسان أن يغضب، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين
: ”الغضب ضربٌ من الجنون لأن صاحبه يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكمٌ“. وهناك من يستخدم القوة السبعية بتفريط، فلا يغضب إلا نادرًا، وهذا أيضًا يعيش رذيلة، ذاك يعيش رذيلة التهوّر، وهذا يعيش رذيلة الجبن؛ لأن من طبيعة الإنسان أن يغضب، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين  : ”من أُغْضِب ولم يغضب فهو حمارٌ“. إذن، الإنسان المعتدل هو الذي يعيش حالة وسط: لا تهور ولا جبن، فيستخدم غريزة الانفعال وقوة الانفعال باعتدال، وهو ما يسمّى بالحلم، ”إن لم تكن حليمًا فتحلَّم“ كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين
: ”من أُغْضِب ولم يغضب فهو حمارٌ“. إذن، الإنسان المعتدل هو الذي يعيش حالة وسط: لا تهور ولا جبن، فيستخدم غريزة الانفعال وقوة الانفعال باعتدال، وهو ما يسمّى بالحلم، ”إن لم تكن حليمًا فتحلَّم“ كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين  .
.
القوة الثالثة هي القوة العقلية، وهناك من يستخدم هذه القوة بإفراط، يستخدم عقله حتى في السحر والشعوذة، وفي إيجاد النميمة والفتنة بين الناس، استخدام العقل بإفراط يسمى جربزة، وهذه رذيلة، واستخدام العقل بتفريط، شخص لا يشغّل عقله إلا يومًا في السنة! دائمًا يعتبر نفسه شريط كاسيت، يسمع المعلومات من دون أن يفكر، ومن دون أن يحلّل، هذا أيضًا يعيش رذيلة، وهي رذيلة البلادة، فالإنسان المعتدل هو الذي يستخدم عقله بنحو وسط، وهو ما يسمّى بالحكمة.
إذن، الفكر اليوناني يقول: ركيزة الأخلاق في السعادة الروحية، والسعادة الروحية هي أن يسيطر عقلُك على القوة الشهوية فيضبطها بلا إفراط ولا تفريط، وأن يسيطر عقلك على القوة السبعية فيضبطها بلا إفراط ولا تفريط، سيطرة العقل على القوتين الشهوية والسبعية وجعلها في حالة وسط بعد أن يسيطر على نفسه، ويجعل نفسه في حالة وسط، هذه السيطرة هي السعادة الروحية، وهي ركيزة الأخلاق في الفكر اليوناني.
القسم الثاني: القيم الفارسية.
يقول الدكتور الجابري: الحضارة الفارسية عندها قيم أخلاقية تختلف عن الحضارة اليونانية، حيث ترى أنَّ ركيزة القيم هي إطاعة الزعيم القائد، الفرس أكثر إطاعة لزعمائهم من أكثر مجتمع آخر، أكثر طأطأة لزعمائهم من أي مجتمع آخر، وهذا أمر ملحوظ بالوجدان. الحضارة الفارسية أفرزت قيمة خلقية تختلف عن الحضارات الأخرى، وهي إطاعة الزعيم القائد، الزعيم القائد ينبغي إطاعته، وإجلاله، وطأطأة الرؤوس له. ولذلك، ورد عن النبي محمد  : ”لا تقوموا لي قيام الأعاجم“، أي أن هناك نوعًا من طبيعة الإجلال يستخدمها الفرس لزعمائهم، فيها نوع من طأطأة الرأس وتقبيل الأعتاب، النبي
: ”لا تقوموا لي قيام الأعاجم“، أي أن هناك نوعًا من طبيعة الإجلال يستخدمها الفرس لزعمائهم، فيها نوع من طأطأة الرأس وتقبيل الأعتاب، النبي  رفض هذه المراسيم، رفض هذه البرتوكولات.
رفض هذه المراسيم، رفض هذه البرتوكولات.
إذن، هناك قيمة فارسية وهي إطاعة الزعيم القائد، وهذه القيمة الفارسية تتعدى لكل من هو قائد، فالأسرة ترى الأب قائدًا فتطيعه، والمرأة ترى زوجها قائدًا فتطيعه، والعشيرة ترى شيخ العشيرة قائدًا فتطيعه... وهكذا. وقد استفادت من هذه القيمة الفارسية السلطات، السلطة الأموية والسلطة العباسية، السلطة الأموية سخّرت سالم بن أبي العلاء وعبد الحميد بن يحيى لتطويع العرب للخليفة الأموي، فقالا للناس: أخلصوا للقائد، أطيعوا القائد، فهو ولي أمركم. وكذلك السلطة العباسية، نفس الشيء، استخدمت ابن المقفّع، نحن نعتبره أديبًا مفكرًا! هو كان مترجمًا، لم يكن أديبًا، كان عنده لغة فارسية جيدة، وكان يترجم الأدب الفارسي إلى العربي، وتقرؤه الناس على أنه أدب ابن المقفّع، وعلى أنه فكر ابن المقفّع، والحال أنه كان مترجمًا، وقد ترجم القيم الفارسية إلى العربية، وبثّها في صفوف المجتمع العربي، وبذلك تخلّق المجتمع العربي بهذه القيمة، وهي قيمة إطاعة القائد والزعيم، وإلا فالعرب ليس عندهم هذا الخلق ولا هذه السجية.
القسم الثالث: القيم الصوفية.
الصوفية أيضًا لهم أسس في القيمة تختلف عن غيرهم، التصوّف يرى أنَّ ركيزة الأخلاق بالبعد عن الدنيا والزهد فيها، إذا قرأت أدبيات المتصوفة - كالحسن البصري وشقيق البلخي وإبراهيم بن أدهم - ترى أنهم يركزون على مسألة البعد عن الدنيا والإعراض عنها.
القسم الرابع: القيم العربية.
يقول الدكتور الجابري: العرب ليسوا فاضيين لا قيم عندهم! بل العرب قبل الإسلام كان عندهم موروث معرفي، ولأجل هذا الموروث المعرفي تكوّنت عندهم قيم أخلاقية يتميزون بها على غيرهم. ولذلك، النبي محمد  قال: ”إنما بُعِثْتُ لأتمّم مكارم الأخلاق“، كانت هناك أخلاق موجودة عند العرب، وأنا متمّمٌ لها. ركيزة الأخلاق عند العرب هي المروءة، العربي هو صاحب المروءة، والمروءة خصلتان: الكرم والنجدة. العرب عندهم الخلق هو الكرم، إذا كنت كريمًا فأنت إنسان عربي، فأنت إنسان صاحب خلق، من يتلقى الضيوف التائهين الجائعين ويطعمهم ويكرمهم فهو صاحب الخلق لدى المجتمع العربي، والخصلة الثانية هي النجدة، أي: من يدافع عن عشيرته، إذا غُزِيَت العشيرة فاستنجد فأنجد العشيرة فهو صاحب الخُلق العظيم؛ لأنه يمتلك نجدة، كما كان حاتم الطائي رمز الكرم عند العرب، وعنترة العبسي رمز النجدة عند العرب، وكان يفتخر بأنه يمتلك خلق النجدة.
قال: ”إنما بُعِثْتُ لأتمّم مكارم الأخلاق“، كانت هناك أخلاق موجودة عند العرب، وأنا متمّمٌ لها. ركيزة الأخلاق عند العرب هي المروءة، العربي هو صاحب المروءة، والمروءة خصلتان: الكرم والنجدة. العرب عندهم الخلق هو الكرم، إذا كنت كريمًا فأنت إنسان عربي، فأنت إنسان صاحب خلق، من يتلقى الضيوف التائهين الجائعين ويطعمهم ويكرمهم فهو صاحب الخلق لدى المجتمع العربي، والخصلة الثانية هي النجدة، أي: من يدافع عن عشيرته، إذا غُزِيَت العشيرة فاستنجد فأنجد العشيرة فهو صاحب الخُلق العظيم؛ لأنه يمتلك نجدة، كما كان حاتم الطائي رمز الكرم عند العرب، وعنترة العبسي رمز النجدة عند العرب، وكان يفتخر بأنه يمتلك خلق النجدة.
| ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها | قيل الفوارس ويك عنتر أقدمِ |
القسم الخامس: القيم الإسلامية.
المركزية في الفكر الإسلامي للقيم هي التقوى، المركزية للتقوى، التقوى هي ركيزة القيم في الفكر الإسلامي، القرآن الكريم يقول: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾، ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾. التقوى تعني عنصرين: عنصرًا نفسيًا، وهو عنصر الإيمان، وعنصرًا سلوكيًا، وهو عنصر العمل الصالح للفرد وللمجتمع، ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾.
إذن، الدكتور الجابري يقول: ليست عندنا أخلاق ثابتة، بل إنَّ الحضارات تختلف فتختلف الأخلاق، الحضارة الفارسية لها قيم، الحضارة العربية لها قيم، الحضارة اليونانية لها قيم، إذن القيم تختلف باختلاف الجذور الحضارية، وباختلاف التراكمات المعرفية، فليس عندنا شيء اسمه قيم ثابتة وأخلاق ثابتة، هذه هي النظرية الأولى.
النظرية الثانية: الأخلاق نزعة أصيلة.
النظرية التي نؤمن بها هي أنَّ أصول الأخلاق قيمٌ ثابتةٌ، وأنَّ أصول الأخلاق نزعةٌ أصيلةٌ عند الإنسان، ومتجذّرةٌ في فطرة الإنسان، وحتى نبرهن على هذا نذكر عدة أمور:
الأمر الأول: رجوع القيم إلى جمال العدل وقبح الظلم.
جميع الأخلاق والقيم ترجع إلى قضية واحدة: العدل جميل والظلم قبيح، كل شيء يرجع إلى هذا، جمال العدل وقبح الظلم ليس قضية تختلف باختلاف الحضارات أبدًا، بل جميع الحضارات على الإطلاق وجميع المعارف البشرية منذ يوم آدم إلى يومنا هذا متفقة على هذين الأصلين: العدل جميل والظلم قبيح، لا تختلف الحضارات ولا تختلف المعارف في هذين الأصلين، وحتى الظالم - كهتلر أو صدّام - لا يرى نفسه ظالمًا، بل يرى الظلم، حتى الظالم المستبد يقول: أنا عادل ولستُ ظالمًا! هو يؤمن بأن العدل جميل والظلم قبيح، لكنه يبرّر أفعاله، ويدرجها تحت عنوان العدل، وحتى الإرهابي الذي يسفك دماء الأبرياء عندما تقول له: هل تؤمن أن الظلم شيء حسن؟ يقول لك: العدل جميل والظلم قبيح، ولكنني لا أظلم، بل هؤلاء يستحقون القتل ولذلك أنا أقتلهم! فالكل يعترف في قرارة نفسه أن فطرته تنادي بجمال العدل وقبح الظلم.
أنت عندما تراجع منظمات حقوق الإنسان، لائحة حقوق الإنسان أجمعت عليها البشرية بين المسلم والمسيحي واليهودي وغير الموحّد، وبين الليبرالي والاشتراكي والماركسي، وجميع المدارس. جميع الحضارات اتفقت على لائحة حقوق الإنسان، وهذا يعني أن جميع الحضارات تعترف بأن للإنسان حقوقًا، وأن إعطاءه حقوقه عدل، وعدم إعطائه حقوقه ظلم، وأن العدل جميل والظلم قبيح، فإذن اتفاق المدارس المختلفة على لائحة حقوق الإنسان معناه اعتراف الجميع بأن هذين الأصلين لا مجال للنقاش فيهما.
إذن، هناك نزعة فطرية، وليست مكتسبة من حضارة يونانية ولا من حضارة فارسية، هناك نزعة فطرية متأصّلة، وهي حكم الفطرة بجمال العدل وقبح الظلم، ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾، ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى﴾.
الأمر الثاني: اختلاف الأيدلوجيات في المصاديق.
جميع القيم ترجع إلى مسألة العدل والظلم، فمثلًا: عندما نقول بأنَّ الأمانة خلق جميل، والخيانة خلق قبيح، فإنما اعتبرنا الأمانة خلقًا جميلًا لأنها ترجع للعدل، الأمانة ليست خلقًا مستقلًا، بل هي مجرد تطبيق، الأمانة تدخل في العدل، إذا ائتمنك شخص على أمواله، فإن أديت له أمواله كان ذلك عدلًا، وإن سلبت منه أمواله كان ذلك ظلمًا، فالأمانة جميلة لأنها عدل، والخيانة قبيحة لأنها ظلم. إذن، رجعت المسألة إلى العدل والظلم، الأمانة ليست خلقًا مستقلًا، والخيانة ليست خلقًا مستقلًا، بل الأمانة جميلة لأنها عدل، والخيانة قبيحة لأنها ظلم.
كذلك حال الصدق مثلًا، الصدق أحيانًا يكون جميلًا وأحيانًا يكون قبيحًا، وليس جميلًا دائمًا، والكذب ليس قبيحًا دائمًا، بل قد يكون جميلًا أحيانًا، فمثلًا: لو كان هناك إنسان يبحث عنه أعداؤه يريدون أن يفتكوا به، وسألوك عنه: أين هو فلان؟ هنا إذا صدقت في الكلام، وأخبرتهم عن موقعه، سوف يعتدى عليه، أو سوف تزهق نفسه، وفي مثل هذا المورد يكون الصدق قبيحًا، ويكون الكذب حسنًا؛ لأنَّ الصدق في هذا المورد ظلمٌ للشخص الذي يُسْأل عنه، والكذب في هذا المورد عدلٌ، فالصدق ليس خلقًا حسنًا دائمًا، وإنما يكون حسنًا إذا دخل تحت عنوان العدل، والكذب إنما يكون قبيحًا إذا دخل تحت عنوان الظلم، وأما لو افترقا، فدخل الصدق في الظلم، أو دخل الكذب في العدل، كان الكذب حسنًا، وكان الصدق قبيحًا.
إذن جميع الأخلاق ترجع إلى مسألة العدل والظلم، وقد يقع خلاف بين الأيدلوجيات، أحيانًا يحصل خلاف في التطبيقات، كما في الحرية الجنسية مثلًا، حيث يرى الفكر الليبرالي - الذي تحدثنا عنه في ليلتين سابقتين - أن الحرية الجنسية شيء جميل لا شائبة تشوبه، بينما الأيدلوجية الإسلامية تقول: الحرية الجنسية بدون عقد شرعي، وبدون عقد قانوني، ليست أمرًا جميلًا، بل هي أمرٌ قبيحٌ، أين مرجع هذا الخلاف؟
مرجعه إلى العدل والظلم تمامًا، فإن الأيدلوجية الليبرالية تقول: الحرية الجنسية عدلٌ؛ لأنَّ من حق الإنسان أن يكون حرًا في إشباع غريزته الجنسية كيفما أراد، فإعطاؤه هذا الحق عدلٌ، بينما الأيدلوجية الإسلامية تقول: الحرية الجنسية بدون عقد ظلمٌ للمجتمع؛ لأنَّ من حق المجتمع وجود الأسرة، وجود الأسرة ضروريٌ، الإنسان الذي يعيش في محيط الأسرة يتخرّج إنسانًا مستقرًا نفسيًا، قادرًا على العطاء والإبداع، قادرًا على بناء الحضارة، ابن الأسرة أكثر استقرارًا وأكثر عطاءً من الولد الذي لا يعيش في الأسرة.
إذن، من حق المجتمع أن تكون فيه أسرة، ولو فتحنا باب الحرية الجنسية، وقلنا: أشبع غريزتك بأي طريقة تريد، وفي أي وقت تريد، فحينئذ سيستغني الإنسان عن بناء الأسرة، إذ بإمكانه أن يشبع غريزته من دون تكاليف، ومن دون أن يتحمّل أعباء الأسرة، ومن دون أن يتحمّل الوظائف الثقيلة في الأسرة، وهكذا يشبع غريزته بأي لون، وبأي طريقة، وبالتالي: إذا فُتِح باب الحرية الجنسية بدون قيود، لم تقوَ الدافعية داخل الإنسان نحو بناء الأسرة، ونحو مؤسّسة الأسرة، فبالتالي يخسر المجتمع هذه المؤسسة الضرورية، وهي مؤسسة الأسرة.
إذن، تقييد الحرية الجنسية بالعقد والميثاق إعطاءٌ للمجتمع حقَّه في بناء الأسرة، فيكون عدلًا، وفتح باب الحرية الجنسية بدون قيود يعتبر ظلمًا؛ لأنَّه قضاءٌ على حق المجتمع في وجود المؤسّسة الأسرية، فهذا خلافٌ بين الأيدلوجيات في تطبيق العدل أو تطبيق الظلم.
الأمر الثالث: الفرق بين الخلق والأدب.
النظرية التي طرحها الدكتور الجابري تشتمل على خلط بين الخلق والأدب، فقد ذكرنا أن الخلق نزعة فكرية داخل الإنسان، محلها روح الإنسان، ولكن الأدب مجرد ممارسة خارجية يمارسها الإنسان كتعبير عما في نفسه، فمثلًا: قبل ثلاثين سنة، كان من الأدب أن يكون الولد صامتًا مع أبيه، الولد لا يتكلم مع أبيه، قبل ثلاثين سنة كان الصمت من آداب البنوة، ولكن الزمان تغير، وصار الصامت بعد ثلاثين سنة بليدًا غبيًا، وصار من أدب الولد مع أبيه أن يكون صديقًا له، يحاوره ويشاوره ويستنصحه، ويكون متحدثًا مع أبيه، هذا هو الأدب، وليس الأدب هو الصمت.
لذلك، ورد عن الإمام أمير المؤمنين  : ”لا تقصروا أبناؤكم على آدابكم؛ فإنَّهم خُلِقوا لزمانٍ غير زمانكم“، فالأدب يختلف باختلاف الزمان، وباختلاف الحضارات. الأدب ممارسة سلوكية، والممارسة السلوكية تختلف، في الحضارة الفارسية شكل، وفي الحضارة العربية شكل آخر، وفي الحضارة اليونانية شكل ثالث، فهذا اختلافٌ في الأدب، وأما الخلق فهو لا يختلف باختلاف الحضارات.
: ”لا تقصروا أبناؤكم على آدابكم؛ فإنَّهم خُلِقوا لزمانٍ غير زمانكم“، فالأدب يختلف باختلاف الزمان، وباختلاف الحضارات. الأدب ممارسة سلوكية، والممارسة السلوكية تختلف، في الحضارة الفارسية شكل، وفي الحضارة العربية شكل آخر، وفي الحضارة اليونانية شكل ثالث، فهذا اختلافٌ في الأدب، وأما الخلق فهو لا يختلف باختلاف الحضارات.
مثلًا: الحضارة الفارسية عندما.. حتى إذا قرأت الشعر الفارسي تجد مسألة الخضوع للقائد طاغية حتى على الأدب الفارسي، من أدبيات الحضارة الفارسية الخضوع والطاعة للقائد المخلِص، هذا لا يعتبره الفرس خُلُقًا، لماذا نظلم الفرس ونقول: عندهم أخلاق غير أخلاقنا! يعتبرونه أدبًا، وفرق بين الأدب والخلق، الحضارة الفارسية ليس عندها قيم غير القيم الإنسانية، وهي العدل والظلم، وإنما الحضارة الفارسية تختلف في الآداب، فتقول: من حق القائد المخلِص الخضوع له، من حقه أن يخضع له المجتمع، فالخضوع له عدلٌ؛ لأنَّنا أعطيناه حقَّه، وعدم الخضوع له ظلمٌ؛ لأنَّنا سلبناه حقَّه، فإذن الخضوع للزعيم في نظر المجتمع الفارسي ليس خلقًا مستقلًا، وإنما هو أدبٌ يعبّر به عن العدل وعن الظلم ليس إلا.
نفس الشيء في المجتمع العربي، المجتمع العربي عندما يقول: الكرم جميل، أو النجدة أمر جميل، فهذا لا يعني أن النجدة خُلُقٌ مستقلٌ، فلو فرضنا أنَّ أخاك قتل إنسانًا آخر مثلًا، وقال لك: أعنّي على قتله، فهل تنجده على قتل الإنسان الآخر، أو تدافع عنه مع أنه قتل إنسانًا بريئًا؟! لا، النجدة هنا ليست خلقًا حسنًا. كذلك الكرم مثلًا، الإنسان في سبيل أن يعتبر كريمًا يتلف أمواله، ويغدق العطاء إلى حد الإسراف أو التبذير، هذا ليس خلقًا حسنًا. العرب لا يعتبرون الكرم خلقًا مستقلًا، ولا يعتبرون النجدة خلقًا مستقلًا، وإنما يعتبرونهما أدبًا، والأدب غير الخلق، فالكرم والنجدة أدبٌ، والأدب ممارسة سلوكية، يعبّر بها الإنسان عن الخُلُق.
العرب تقول لك: من حق الضيف إكرامك، فإذا لم يُكْرَم كان عدم إكرامه ظلمًا، وكان إكرامه عدلًا، فالكرم تعبيرٌ عن العدل، والبخل تعبيرٌ عن الظلم، والنجدة تعبيرٌ عن العدل، وعدم النجدة تعبيرٌ عن الظلم، فالنجدة والكرم مجرد آداب - لا أخلاق - يعبّر بها عن العدل والظلم. لأجل ذلك، هناك خلطٌ وقع في كلام الدكتور الجابري بين الخُلُق والأدب.
الأمر الأخير: اتحاد بعض النظريات.
نلاحظ من خلال النظرية أنّه جعل نظرياتٍ ثلاثًا: النظرية اليونانية التي ترى الأخلاق في السعادة الروحية والسيطرة على القوة الشهوية والقوة الغضبية، والنظرية الإسلامية التي ترى الأخلاق في التقوى، والنظرية التي طرحناها، وهي التي ترى الأخلاق في العدل والظلم، وكأنما هناك نظريات ثلاث متقابلة! ليس الأمر كذلك.
أولًا: لا فرق بين مقالتنا - أن الأخلاق هي العدل والظلم - وبين المقالة التي تقول بأنَّ ركيزة الأخلاق هي التقوى، لا فرق بين النظريتين؛ لأنَّ الإسلام - وسأشرح هذا في الليلة القادمة بشكل معمّق - لم يبتكر أخلاقًا، لم يؤسّس أخلاقًا، الإسلام لم يأتِ بأساس جديد للأخلاق، الإسلام ما جاء بركيزة جديدة في عالم الأخلاق أبدًا، بل إنَّ قيم الأخلاق، القيمة الأخلاقية هي قيم إنسانية أصيلة قبل الإسلام وبعده، الإسلام ما أتى بقيمة جديدة، وما أتى بركيزة جديدة للأخلاق، وإنما تدخل في المصاديق لا في الأخلاق نفسها، تدخل في عالم التطبيق ولم يتدخل في المفاهيم، فالإسلام يقول لك: العدل جميلٌ، كما يقول به المجتمع الإنساني، ولكنني أرى أن التقوى هي العدل، وأن الفسق هو ظلم، فالإسلام لم يتدخل في الأخلاق، بل أقرَّ الإنسانية على أنَّ الأخلاق هي العدل، ولكنه تدخل في التطبيق، فقال: العدل هو التقوى، والظلم هو الفسق، فتدخل في عالم التطبيق، ولم يتدخل في مفهوم الأخلاق، وفي ركيزة الأخلاق، ألا وهي العدل والظلم. الإسلام قال: التقوى هي عدلٌ مع الله عز وجل، والفسق ظلمٌ لله عز وجل، ولأجل ذلك فالتقوى مصداقٌ من مصاديق العدل، فهنا تدخلٌ في التطبيق، وليست هناك منافاة بين المقالتين.
ثانيًا: لا توجد منافاة أيضًا بين النظرية اليونانية التي طرحها السيد الطباطبائي في الميزان، وبين النظرية التي ذكرناها، فإننا نقول: القيم الأخلاقية هي كلمتان: العدل جميل والظلم قبيح، وهذا يعترف به اليونانيون، ويعترف به السيد صاحب الميزان، وإنما الكلام في الآلية، أنت تقول: العدل جميل، فكيف أصبح عادلًا؟ ما هي الآلية التي من خلالها أصبح إنسانًا عادلًا؟ العدل جميل، لكن كيف أصبح إنسانًا عادلًا؟ ما هي الآلية وما هو الطريق الذي من خلاله أصبح إنسانًا عادلًا؟
هنا جاء الفكر اليوناني ليتحدث عن الآلية، لا ليتحدث عن نظرية مستقلة، يقول لك: الآلية في أن تصبح إنسانًا عادلًا هي في السيطرة على القوة الشهوية، بأن تجعلها بلا إفراط ولا تفريط، ولكن في حالة وسط، وأن تسيطر على القوة الغضبية فتجعلها بلا إفراط ولا تفريطه، ولكن في حالة وسط، وأن تسيطر على القوة العقلية فتجعلها لا في الجربزة ولا في البلادة، ولكن في الحكمة. السيطرة على القوى وجعلها في حال وسط، ليست نظرية جديدة في الأخلاق، وإنما هي بيانٌ لآلية تحقيق العدل، كيف يصبح الإنسان عادلًا؟ بهذه الآلية، بأن يسيطر على قواه، وأن يجعلها في حالة الوسط، فلا فرق بين النظرية اليونانية والنظرية التي ذكرناها.
من هنا نرى النصوص الشريفة تؤكد على مسألة العدل والظلم، حيث ورد عن الإمام أمير المؤمنين  : ”الظلم ثلاثة: ظلمٌ لا يُغْفَر، وهو الشرك بالله“، الله تبارك وتعالى أنعم علينا بالوجود، بالرزق، بالحياة، بالعلم، بالقدرة، مقابل المنعِم إذا كفرنا بنعمة المنعِم وأشركنا به، فالكفر بنعمته ظلمٌ له، وهذا ظلمٌ لا يُغْفَر، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾، ”وظلم لا يُطْلَب“ وهو ظلم الإنسان لنفسه، وظلم الإنسان لنفسه على قسمين: ظلم بمعنى أن من حقي أن أتعلم مثلًا، ولكنني لا أتعلم، بل أبقى جاهلًا، فهذا ظلمٌ لا أحاسَب عليه يوم القيامة، ومن حقي أن أبني الحضارة، ولكنني جلست في البيت ولم أبنِ شيئًا، هذا ظلمٌ للنفس، ولكنه ظلمٌ لا يُطْلَب، بينما يوجد نوعٌ من ظلم النفس، وهو الذي يعدَّ جنايةً على النفس، الجناية على النفس ظلمٌ يحاسَب عليه الإنسان؛ لأنَّه ظلمٌ لله عز وجل.
: ”الظلم ثلاثة: ظلمٌ لا يُغْفَر، وهو الشرك بالله“، الله تبارك وتعالى أنعم علينا بالوجود، بالرزق، بالحياة، بالعلم، بالقدرة، مقابل المنعِم إذا كفرنا بنعمة المنعِم وأشركنا به، فالكفر بنعمته ظلمٌ له، وهذا ظلمٌ لا يُغْفَر، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾، ”وظلم لا يُطْلَب“ وهو ظلم الإنسان لنفسه، وظلم الإنسان لنفسه على قسمين: ظلم بمعنى أن من حقي أن أتعلم مثلًا، ولكنني لا أتعلم، بل أبقى جاهلًا، فهذا ظلمٌ لا أحاسَب عليه يوم القيامة، ومن حقي أن أبني الحضارة، ولكنني جلست في البيت ولم أبنِ شيئًا، هذا ظلمٌ للنفس، ولكنه ظلمٌ لا يُطْلَب، بينما يوجد نوعٌ من ظلم النفس، وهو الذي يعدَّ جنايةً على النفس، الجناية على النفس ظلمٌ يحاسَب عليه الإنسان؛ لأنَّه ظلمٌ لله عز وجل.
لو أنَّ الإنسان أراد أن يقتل نفسه، ألا يحاسَب؟! أو لو أراد أن يتلف عضوًا من أعضاء بدنه، أو أراد أن يجرح بدنه جرحًا يؤدي إلى مرض مزمن أو مرض خطير، هذا جناية على النفس، والجناية على النفس ظلمٌ يحاسَب عليه الإنسان يوم القيامة؛ لأنَّه ظلمٌ لله من جهة أخرى، حيث إنَّ الله تبارك وتعالى نهى عن الجناية على النفس ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾.
”وظلمٌ لا يُتْرَك“ وهو ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، يوم القيامة يقف معك المظلوم ليطالب بظلامته، ظلمٌ لا يُتْرَك، ”وأدنى هذا الظلم سوء الظن“، هذا أدنى ظلم، أنا إذا أسأت الظن بك، أسمع منك كلمة معينة فأفسّرها بتفسير سيئ، أو أرى منك حركة معينة فأحملها على محمل سيئ، سوء الظن ظلمٌ، فكيف إذا أصبح غيبة؟! الغيبة أشد من سوء الظن، ﴿يا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ أي: لا تتبعوا عورات الآخرين، كما ورد عن الرسول محمد  : ”من تتبع عورة المؤمن تتبع الله عورته، حتى يفضحه ولو في بيته“. هناك أشخاص ليس شغلهم إلا البحث عن العيوب والأخطاء والزلات، يحصيها حتى يتحدث بها، وقد ورد عن أمير المؤمنين
: ”من تتبع عورة المؤمن تتبع الله عورته، حتى يفضحه ولو في بيته“. هناك أشخاص ليس شغلهم إلا البحث عن العيوب والأخطاء والزلات، يحصيها حتى يتحدث بها، وقد ورد عن أمير المؤمنين  : ”رحم الله اشتغل بعيوبه“ أي: بإصلاح عيوبه ”عن عيوب الناس“.
: ”رحم الله اشتغل بعيوبه“ أي: بإصلاح عيوبه ”عن عيوب الناس“.
| لسانك لا تذكر به عورة امرئ وعينك إن أبدت إليك مساوئا |
فكل عورات وللناس ألسنُ فصنها وقل: يا أعينُ للناس أعينُ |
إذن فبالنتيجة: فكيف إذا وصل إلى حد الغيبة؟! الغيبة يعبّر عنها القرآن: ﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾، تصوّر أنك جالس على الوليمة، وموضوع على الوليمة لحم نتن، لحم إنسان مذبوح مقتول، لحم نتن وهو يأكله بشراهة، هذا المنظر البشع هو منظر الإنسان عندما يغتاب الآخرين، وعندما يتناول شخصيات الآخرين، فكيف إذا تطور الأمر في ظلم الناس إلى الاعتداء عليهم بالسب والشتم؟! الاعتداء على كرامتهم أو شخصياتهم، أو الاعتداء على أموالهم، أو الاعتداء على أنفسهم، هذا من أشد أنواع الظلم التي لا تُتْرَك يوم القيامة، هذا إذا كان اعتداءً على إنسان عادي، فكيف إذا كان اعتداءً على مؤمن؟! وكيف إذا كان اعتداءً على أهل بيت الرحمة «صلوات الله وسلامه عليهم»؟! فإن من أشد أنواع الظلم ظلم أهل البيت.
نحن عندما نذكر ظلم أهل البيت يذهب ذهن الإنسان إلى بني أمية وبني العباس، الذين ظلموا أهل البيت بقتلهم، والحال أننا نحن نظلم أهل البيت  أيضًا، الذي لا يخرج الحقوق الشرعية يظلم أهل البيت، الذي لا يُخْرِج الخمس من أمواله يظلم أهل البيت، لأنه حقهم، هو يبلعه يوميًا، يأكله في بطنه، يبكي على أهل البيت وهو يأكل حقَّهم
أيضًا، الذي لا يخرج الحقوق الشرعية يظلم أهل البيت، الذي لا يُخْرِج الخمس من أمواله يظلم أهل البيت، لأنه حقهم، هو يبلعه يوميًا، يأكله في بطنه، يبكي على أهل البيت وهو يأكل حقَّهم  ، يحيي شعائر أهل البيت وهو يأكل من حقهم، قد ترى هذا الإنسان يتفانى في شعائر أهل البيت، يلطم، يعزي، يصر على أن يحيي شعائر أهل البيت باللطم والعزاء، ولكنه لا يخرج فلسًا من حقوق أهل البيت
، يحيي شعائر أهل البيت وهو يأكل من حقهم، قد ترى هذا الإنسان يتفانى في شعائر أهل البيت، يلطم، يعزي، يصر على أن يحيي شعائر أهل البيت باللطم والعزاء، ولكنه لا يخرج فلسًا من حقوق أهل البيت  .
.
لذلك، ورد عن الإمام الباقر  : ”من أكل شيئًا من حقنا فكأنّما أكل من لحمنا“، وورد عن الإمام الباقر
: ”من أكل شيئًا من حقنا فكأنّما أكل من لحمنا“، وورد عن الإمام الباقر  يخاطب أبا بصير: يا أبا بصير، ما أيسر ما يدخل به العبدُ النار؟ قلتُ: لا أدري سيدي، قال: ”من أكل من مال اليتيم درهمًا“، إذا أخذت درهمًا واحدًا من مال اليتيم دخلت النار، ثم قال: ”ونحن اليتيم يا أبا بصير، فمن أكل من حقنا درهمًا كان مصيره مصير أعدائنا“ أي: في النار. إذن فبالنتيجة: ظلم أهل البيت من أشد أنواع الظلم، فكيف إذا كان ظلمًا سافرًا، وإبادةً لذرية أهل البيت ولوجودهم «صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين»؟!
يخاطب أبا بصير: يا أبا بصير، ما أيسر ما يدخل به العبدُ النار؟ قلتُ: لا أدري سيدي، قال: ”من أكل من مال اليتيم درهمًا“، إذا أخذت درهمًا واحدًا من مال اليتيم دخلت النار، ثم قال: ”ونحن اليتيم يا أبا بصير، فمن أكل من حقنا درهمًا كان مصيره مصير أعدائنا“ أي: في النار. إذن فبالنتيجة: ظلم أهل البيت من أشد أنواع الظلم، فكيف إذا كان ظلمًا سافرًا، وإبادةً لذرية أهل البيت ولوجودهم «صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين»؟!