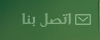بسم الله الرحمن الرحيم
﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾
صدق الله العلي العظيم
أتعرض إلى دفع الشبهات الواردة من قِبَل بعض الحداثيين والعلمانيين حول القرآن الكريم، ونبدأ اليوم بالشبهة الأولى، وهي شبهة التفاوت البلاغي بين سور وآيات القرآن الكريم، وبيان هذه الشبهة يتم بذكر أمرين:
الأمر الأول: تفاوت المستوى البلاغي بين سورة القرآن.
إذا قمنا بالمقارنة بين سور القرآن، نجد أن بعض سور القرآن أبلغ من بعض السور الأخرى، أي أن بعض سور القرآن أكثر بلاغةً من بعض السور الأخرى، فمثلًا: إذا قمنا بالمقارنة بين سورة المسد وبين سورة الرحمن، نجد أن سورة الرحمن أكثر بلاغة من سورة المسد، والوجه في ذلك: متى نستطيع أن نقول بأن هذا النص أكثر بلاغةً من النص الآخر؟ إنما يتم ذلك إذا كان كلا النصين واردين في مقام واحد وموضوع واحد، فإذا وجدنا أن كلا النصين وردا في موضوع واحد ومقام واحد، لكن أحدهما أكثر تأثيرًا في ذلك المقام وفي الوصول إلى الغرض من الآخر، إذن فالنص الثاني أبلغ من الأول.
ونأتي لنطبقه الآن على سورة المسد وسورة الرحمن: كلتا السورتين وردتا في مقام واحد، وهو مقام الوصف، فسورة المسد في مقام وصف ظالم من الظلمة وطاغية من الطغاة، وهو أبو لهب، بغرض تنفير الناس من الظلم، وتربيتهم على رفض الظلم والطغيان، جاءت سورة المسد لتصف هذا الظالم وصفًا شنيعًا ينفّر الناس من الظلم. وسورة الرحمن أيضًا جاءت في مقام الوصف؛ لأنها جاءت في وصف الجنة، ترغيبًا للناس في الجنان، وترغيبًا للناس في طاعة الرحمن، فإذا نظرنا إلى سورة الرحمن وجدناها تتضمن وصفًا جذّابًا مؤثرًا في تقريب الناس إلى الطاعة، وفي ربط الناس بالجنة.
تقول السرة المباركة: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * ذَوَاتَا أَفْنَانٍ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾. هذه السورة جاءت بأبلغ الأوصاف، ووفت الغرض الذي من أجله وردت، وهو ترغيب الناس في الطاعة من خلال ترغيبهم في الجنة، وأثارت صورًا خيالية للجنة يبحر بها الخيال ليعطي للإنسان مزيدًا من الرغبة في الطاعة ما دامت الطاعة وسيلة لهذه الجنة الموعودة.
وأما إذا جئنا إلى سورة المسد التي هي في مقام وصف أبي لهب أحد الطغاة، فإنها في مقام الوصف أيضًا، والغرض منها التنفير من الظلم والردع عن الظلم، لأنها تبيّن مصير الظلمة والطغاة، فقالت: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ * مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ * سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ * وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ * فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ﴾، فيقال بأن هذه السورة أولًا تتضمن تكرارًا؛ لأنها قالت: تبت يدا أبي لهب، ثم قالت: وتب، فما هي الفائدة من ذكر التب مرة أخرى؟! وثانيًا: بأنها تتضمن أوصافًا مستدركة، كقوله: سيصلى نارًا ذات لهب، ومن المعروف أن كل نار ذات اللهب، فلماذا يبيّن أن النار ذات لهب؟! كما أنها تتضمن ثالثًا أوصافًا لا دخل لها في الغرض من السورة، الغرض من السورة تنفير الناس من الظلم، فلماذا قالت: ﴿وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾؟! ما دخل حمل الحطب في تنفير الناس من الظلم؟! سواء حملت امرأته حطبًا أو حملت شجرًا، أي دخل لذلك في الغرض من السورة، وهو تنفير الناس من الظلم؟! ﴿فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ﴾ أي أن حول عنقها حبلًا ملفوفًا وملتفًا.
إذن، كلتا السورتين واردتان في مقام واحد وهو الوصف، لكن السورة الثانية - أي سورة الرحمن - أكثر بلاغة لأنها تضمنت أبلغ الأوصاف المؤثرة في جذب النفوس نحو الطاعة والبعد عن المعصية.
الأمر الثاني: علاقة التفاوت بالبشرية.
بعد أن نلاحظ التفاوت في درجة البلاغة بين سورة تبت وسورة الرحمن نقول: المتكلم بهذا الكلام متفاوت، تفاوت الكلام يدل على تفاوت المتكلم، وأن هذا المتكلم كان في مستوى ثم تطور إلى مستوى آخر، لأن المتكلم بطبيعته يتفاوت؛ لأنه يخضع إلى إطار التكامل، فما ينطقه الإنسان قبل عشرين سنة غير ما ينطقه الإنسان بعد عشرين سنة، فمن الطبيعي أن المتكلم إذا كان خاضعًا لإطار التطور والتكامل فإن كلامه يتفاوت، وإن كلامه يختلف. إذن، تفاوت درجة البلاغة بين سورة المسد وسورة الرحمن يكشف عن أن المتكلم بهاتين السورتين كان على مستوى معين من البلاغة، ثم تطور وتكامل، ووصل إلى مستوى أعلى من البلاغة، فأتى بسورة الرحمن. وحيث إن هاتين السورتين متفاوتان زمنًا - لأن سورة المسد في مكة، وسورة الرحمن في المدينة - فهذا يعني أن هذا المتكلم بهذا الكلام كان في أوائل شبابه وتجربته بمستوى معين من البلاغة، ثم نضج، وتكاملت خبرته ومهارته، فأتى بسورة أبلغ من السورة الأولى.
وحيث إن الله «تبارك وتعالى» لا يُعْقَل فيه التفاوت؛ لأنه الكمال المطلق، فلو كان متفاوتًا في زمن دون زمن لكان ذلك خلف كونه كمالًا مطلقًا، فالكمال المطلق لا يصدر عنه إلا الكمال المطلق، ولو صدر منه ما هو أقل أو ما هو أنقص لكان ذلك مباينًا لحقيقته وواقعه، وهو كونه عين الكمال المطلق، فالنتيجة أن المتكلم بهاتين السورتين ليس هو الله، لأنه لو كان هو الله لما تفاوتت السورتان في درجة البلاغة، إذن فالمتكلم بهاتين السورتين هو النبي  .
.
هذا يعني أن القرآن جاء من صياغة النبي  ، فالله عز وجل أوحى إليه القرآن مضامين ومعاني، وهو قام بالتعبير عنها وبصياغتها بحسب قدرته ومهارته، فحيث كان في مكة أقل مستوى مما كان عليه في المدينة، لذلك جاءت منه سورة تبت أقل مستوى من حيث درجة البلاغة من سورة الرحمن، فالغرض من هذه الشبهة التي يثيرها بعض الحداثيين بيان أن هذا القرآن بششري، وصياغته صياغة بشرية، والدليل على ذلك هو تفاوت المستوى البلاغي بين سوره، والتفاوت البلاغي كاشف عن أن المتكلم متفاوت، ولا يكون المتفاوت إلا بشرًا، فهذا يعني أن الصياغة جاءت من قِبَل بشر.
، فالله عز وجل أوحى إليه القرآن مضامين ومعاني، وهو قام بالتعبير عنها وبصياغتها بحسب قدرته ومهارته، فحيث كان في مكة أقل مستوى مما كان عليه في المدينة، لذلك جاءت منه سورة تبت أقل مستوى من حيث درجة البلاغة من سورة الرحمن، فالغرض من هذه الشبهة التي يثيرها بعض الحداثيين بيان أن هذا القرآن بششري، وصياغته صياغة بشرية، والدليل على ذلك هو تفاوت المستوى البلاغي بين سوره، والتفاوت البلاغي كاشف عن أن المتكلم متفاوت، ولا يكون المتفاوت إلا بشرًا، فهذا يعني أن الصياغة جاءت من قِبَل بشر.
الرد على هذه الشبهة:
بعد أن اتضحت معالم الشبهة، ندخل في الرد عليها، وقد يستغرق الرد يومًا أو يومين، بحسب الشبه وقوتها وضعفها. الجواب الأول عن هذه الشبهة هو منع التفاوت، فنقول: لا يوجد تفاوت في درجة البلاغة بين سور القرآن الكريم، والسر في ذلك: لا بد لنا من ذكرين أمرين في هذا المقام لنعرف أنه لا يوجد تفاوت بين سور القرآن.
الأمر الأول: النكات البلاغية في سورة المسد.
عندما نرجع إلى علم البلاغة، هناك علم يسمى علم البلاغة، وله متخصصون، يقولون: البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، البلاغة غير الفصاحة، عندما يقال: هذا كلام فصيح، غير إذا قيل: هذا كلام بليغ، البليغ غير الفصيح، الكلام الفصيح هو الكلام الخالي من التعقيد، الخالي من تنافر الألفاظ، الخالي من السماجة والتكرار، يقال: هذا كلام فصيح، أما الكلام البليغ فهو أن يتطابق الكلام مع المقام، ولذلك يقال: لكل مقام مقال، أي: لكل مقام مقالٌ يتناسب مع ذلك المقام، ومقتضى الحكمة أن يضع الإنسان مقاله في المقام المناسب له، ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾.
مطابقة الكلام لمقتضى الحال هي التي تسمى بالبلاغة، وكلما كان الكلام وافيًا بمقتضى الحال، وافيًا بالغرض الذي من أجله صدر هذا الكلام وسيق هذا الكلام، كان الكلام أبلغ وأمتن. لذلك، لا بد أن نعرف ما هو المقام لسورة المسد، لكي نعرف أن سورة المسد وفّت بالغرض الذي من أجله جاءت لتكون أبلغ السور في مقامها، وأبلغ السور في موردها، أم لا. ما هو الغرض من سورة المسد؟
ذكرنا أن سورة المسد هي في مقام الوصف لأبي لهب، وأبو لهب من أوائل الظلمة والطغاة الذين تصدوا لمحاربة الدعوة المحمدية، مع أنه عم النبي  ، ولكن كان نطفة من الشر، ونطفة من الكفر، فلذلك ترصّد لمحاربة النبي
، ولكن كان نطفة من الشر، ونطفة من الكفر، فلذلك ترصّد لمحاربة النبي  ، ولا غرابة، فبنو أمية أيضًا أبناء عم لبني هاشم، وينحدرون من جد واحد، إلا أن بني أمية اتخذوا جانب العداء، وجانب المواجهة والمحاربة لبني هاشم، واستمرت هذه الحرب إلى يومنا هذا، فبنو أمية وأعوانهم وأتباعهم وذيولهم حربٌ لبني هاشم وأتباعهم ومن مشى على دربهم وخطهم.
، ولا غرابة، فبنو أمية أيضًا أبناء عم لبني هاشم، وينحدرون من جد واحد، إلا أن بني أمية اتخذوا جانب العداء، وجانب المواجهة والمحاربة لبني هاشم، واستمرت هذه الحرب إلى يومنا هذا، فبنو أمية وأعوانهم وأتباعهم وذيولهم حربٌ لبني هاشم وأتباعهم ومن مشى على دربهم وخطهم.
فالنتيجة: أن أبا لهب، حيث كان من أوائل الظلمة، والمواجهين والمحاربين للدعوة المحمدية، أراد القرآن الكريم أن يصف أبا لهب وصفًا دنيويًا وأخرويًا، ليس الوصف وصفًا دنيويًا، بل هو وصف دنيوي وأخروي يساهم في تصوير الظلم ونتيجته تصويرًا بشعًا مقزّزًا ينفّر الناس من مزاولة الظلم، ويربي الناس على رفض الظلم والطغيان، فجاءت هذه السورة لأجل هذا الغرض.
أولًا قالت: ﴿تَبَّتْ﴾، التب هو القطع والخسارة، عندما يقال: «تب فلان» فمعنى ذلك أنه قُطِع قطعًا يوجب الخسارة، «تبت تجارة فلان» أي: خسرت، «تب عمر فلان» بمعنى أنه انقطع، فالتب هو القطع المساوق للخسارة والفقدان، فالآية الأولى من سورة المسد نصت على الخسارة الدنيوية والأخروية، هو لم يخسر في الدنيا فحسب، هو خسر في الدنيا، افتقر في آخر حياته، وأصابه ما أصابه، خسر الدنيا والآخرة، فقالت: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ إشارة إلى الخسران الدنيوي، حيث خسر يديه، أي: فقد قدرته المادية والاجماعية، ﴿وَتَبَّ﴾ إشارة إلى الخسارة الأخروية، فليس هنالك تكرار في الآية، تبت يداه إشارة إلى الخسارة في الدنيا، وتب إشارة إلى الخسارة في الآخرة، كأنه قال: هذا شخص خيّم وأطبق عليه التب والخسارة دنيا وآخرةً.
ولذلك، عطف عليها: ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ﴾ في الدنيا ﴿وَمَا كَسَبَ﴾ أي: وما كسب ربحًا ولا نعيمًا في الآخرة، عطف الآية الثانية لبيان معنى التب في الآية الأولى. ثم بيّن مصيره في الآية، فقال: ﴿سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾، وفي العرف العربي معروف أن النار على نوعين: نار مغشوشة بالدخان، تدخن فقط، ليست حارة كثيرًا، وفي المقابل توجد نار ذات لهب، أي: اللهب الصافي من الدخان، ومن الاغتشاش، والنار الحارقة المؤلمة هي النار ذات اللهب، التي لا يشوبها دخان، لا يشوبها ضعف، لا يشوبها استدارة، نار محضة وصرفة، ﴿سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾ أي: نارًا حارقةً.
ثم أراد أن يتحدث عن امرأته لا في الدنيا، بل يريد التحدث عنها في الآخرة، وهذا من بديع التعبير في القرآن الكريم: أن يجعل الصورة في الآخرة مسانخةً للصورة في الدنيا، وقد ورد في بعض الأحاديث الشريفة أن المبتسم في الدنيا مبتسم في الآخرة، أي أن الإنسان صاحب الخلق، صاحب التواضع، صاحب البشاشة في الدنيا، يظل مبتسمًا بشوشًا في الآخرة، صورته الأخروية سنخ صورته الدنيوية. وهذا الإنسان الذي تراه غالبًا كئيبًا متجهمًا يبقى كئيبًا متجهمًا حتى في الآخرة، فحسن الخلق من العبادة، وحسن الخلق له امتداد ملكوتي من الدنيا إلى الآخرة.
لذلك، القرآن الكريم يريد أن يثير عندنا الخيال بصورة بديعة. امرأة أبي لهب كانت في الدنيا بصورة أمام الناس، وهي أنها تحمل الحطب على صدرها، وتربطه بحبل في عنقها، هناك حبل قوي مشدود في عنقها، وقد رُبِط به حزمة، تضع الحطب في تلك الحزمة وتحمله، هذه الصورة التي رئيت بها في الدنيا، يريد أن يقول القرآن الكريم أن نفس هذه الصورة تتجسد بها في جهنم، فهذا الحطب يتحول إلى وقود على صدرها في قعر جهنم يغلي منه عنقها وصدرها، نفس الصورة الموجودة في الدنيا ستوجد لها في الآخرة، ﴿وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ * فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ﴾ هذا ليس وصفًا لها في الدنيا، وإنما هذا تصويرٌ لوضعها الأخروي، وأن صورتها في الآخرة بهذه الكيفية في الدنيا.
وفي هذا بيان لشدة بشاعة الظلم، وسوء عاقبته، ومن أجل الوصول إلى غرض تنفير الناس من الظلم والظلمة. إذن، سورة تبت إذا لاحظنا المقام الذي جاءت فيه فهي أبلغ سورة في مقامها، فإن كل سورة هي الأبلغ في مقامها، سورة تبت جاءت في مورد وصف الظلم والظلمة في الدنيا والآخرة بأبشع الأوصاف المنفّرة، فهي وافيةٌ بالغرض الذي جاءت من أجله، إذن هي الأبلغ في موردها وفي مقامها.
وأما سورة الرحمن فإنها لما جاءت في مقام الترغيب، جاءت بهذه الأوصاف المرغّبة، ومجرد أن الإنسان يجهل.. حيث إن بعض الأشخاص يجهل القيمة البلاغية للتعبير، فلأجل ذلك يرى أن هذه السورة أبلغ من السورة الأخرى لأنه يجعل القيمة البلاغية للسورة الأخرى، ويجهل نكات التعبير التي اختيرت في السورة الأخرى، هذا لا ينفي كون كل سورة هي في مقامها الأبلغ، فإن الجهل بنكات التعبير في بعض السور دون بعض لا يعني أن هذه السورة أبلغ من تلك الصورة، فهذا لقصور في المتلقي للقرآن الكريم، وليس لقصور في نفس القرآن الكريم، وليس لتفاوت في درجة البلاغة في القرآن الكريم.
الأمر الثاني: رجوع تفاوت التأثير النفسي إلى تفاوت المتلقي.
ربما يقال بأنَّ الأوصاف المذكورة في سورة الرحمن أكثر تأثيرًا على النفوس وجذبًا لها وإثارةً للخيال من الأوصاف المذكورة في سورة المسد، وصحيح أن المناط في البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، لكن كلما كان الكلام متضمنًا لأوصاف أكثر تأثيرًا في النفوس وأكثر جذبًا لها كان أبلغ في مقامه، وأوفى بمقتضى الحال من أي مقال آخر.
ربما يقال هكذا، ولكن الجواب الصحيح عنه: عندما نقول: هذه الآية أكثر تأثيرًا في النفوس من السورة الأخرى، فما هو المراد بالأكثرية في التأثير؟ هل المراد الأكثرية النوعية، أم المراد الأكثرية الشخصية؟ إذا كان المراد الأكثرية النوعية، بمعنى أن هذه السورة تتضمن أوصافًا أكثر تأثيرًا من السورة الأخرى بلحاظ النوع البشري كله، أي أن هذه السورة لو عُرِضَت على أي مجتمع، على أي جماعة، على أي فئة من البشر، ستكون أكثر تأثيرًا في نفوسهم من السورة الأخرى، فالمراد بالأكثرية الأكثرية النوعية، فنقول: هذا ليس صحيحًا.
إذا التفت المجتمع البشري إلى نكات التعبير في سورة المسد، والتفت إلى التطابق والانسجام بين التعبير فيها وبين مقامها والغرض من صدورها، لن يجد أن سورة الرحمن أكثر تأثيرًا في النفوس من سورة المسد بلحاظ مقامها وغرضها، وأما إذا كان المراد الأكثرية الشخصية، بمعنى أن بعض الناس تؤثر عليهم سورة الرحمن أكثر، فيرتاحون ويفرحون بمجرد قراءتها، بينما لا يلتذون ولا يتفاعلون بقراءة سورة تبت، فحينئذ نقول: الأكثرية الشخصية ليست ميزانًا في التقويم؛ لأن هذا يرجع إلى تفاوتٍ في المتلقي، لا إلى تفاوت في الكلام نفسه، فإن المتلقين يختلفون.
البشر أنواع وأشكال، كما ورد في الحديث عن النبي محمد  : ”الناس معادن كمعادن الذهب والفضة“، هذا ذهب، هذا فضة، هذا عيار 21، هذا عيار 18، هذا عيار 24، هذا فضة مغشوشة، هذا فضة خالصة، وهذا ليس فضة ولا ذهبًا بل هو فحم، وذاك تراب! الناس تختلف، الناس معادن، وهذه المعادن ترجع إلى الأعراق، ينحدر من أي عرق، ينحدر من أي جذور، الجذور والأعراق المتداخلة والمتشابكة التي تنحدر منها هذه النطفة تؤثر على صياغتها، صياغة هذه الشخصية صياغةً تتناسب مع الفحم أو مع الذهب أو مع الفضة.
: ”الناس معادن كمعادن الذهب والفضة“، هذا ذهب، هذا فضة، هذا عيار 21، هذا عيار 18، هذا عيار 24، هذا فضة مغشوشة، هذا فضة خالصة، وهذا ليس فضة ولا ذهبًا بل هو فحم، وذاك تراب! الناس تختلف، الناس معادن، وهذه المعادن ترجع إلى الأعراق، ينحدر من أي عرق، ينحدر من أي جذور، الجذور والأعراق المتداخلة والمتشابكة التي تنحدر منها هذه النطفة تؤثر على صياغتها، صياغة هذه الشخصية صياغةً تتناسب مع الفحم أو مع الذهب أو مع الفضة.
ولذلك، ترى بعض الناس كريمًا بطبعه، وترى بعض الناس قابضًا بخيلًا، وترى بعض الناس غضوبًا سريع الغضب، وترى بعض الناس باردًا ثلجًا. يقال أن شخصًا دخل المباحث للتحقيق معه، وكان باردًا جدًا جدًا ثلجًا، حتى سبّب للمحقِّق القرحة، قال له: أنا لم يمر عليَّ طوال حياتي شخص بهذه البرودة، سبّبت لي القرحة، قطّعت قلبي! هذا حتى يجيب وينتهي من الجواب يحتاج إلى سنة! فالناس يختلفون، هذا شخص سريع الغضب، هذا شخص بارد الطبع، هذا شخص كريم، هذا شخص بخيل، هذا شخص خوّاف، هذا شخص مقدام، هذه صفات يختلف فيها البشر.
لذلك، النفس التي يسكنها الخوف غالبًا تتفاعل مع الأوصاف التي تخوّف وتردع أكثر مما تفاعل مع الأوصاف المرغِّبة، والنفس التي يسكنها الرجاء غالبًا والأمل تتفاعل مع الأوصاف المرغّبة أكثر من الأوصاف المخوّفة، هذا اختلاف في المتلقي، وليس اختلافًا في الكلام، الكلام يبقى على مستواه من البلاغة والروعة، وإن كان المتلقي لهذا الكلام قد يختلف تفاعله نتيجة لقصور في ذاته، نتيجة لقصور في طبعه، فاختلاف تفاعل الناس بين سورة الرحمن وسورة المسد يرجع إلى اختلاف في الطباع، ويرجع إلى اختلاف في النفس، لا أنه يرجع إلى تفاوت في الكلام نفسه من حيث درجة البلاغة والروعة، كي يقال بأن تفاوت القرآن يكشف عن تفاوت في المتكلم، بل المتكلم واحد، ومستواه البلاغي واحد، المتكلم هو الكمال المطلق، وما صدر منه هو الكمال المنسجم مع كماله، لكن التفاوت في التفاعل إنما هو لقصور في المتلقي لهذا الكلام، لذلك تراه يأنس بسورة الرحمن؛ لأنه يعيش الأمل، وتراه لا يأنس بسورة المسد لأنه لا يتفاعل مع هذا النوع من الجو.
وإلا فحتى سورة الرحمن، قد يقول قائل: والله أنا لا أحب الخيام! ﴿حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾، ماذا أفعل بالخيام؟! فأنا لا أتفاعل مع سورة الرحمن؛ لأنها لو قالت: حور مقصورات في شيرتون أو هيلتون أو في هذه القصور لكان ذلك جميلًا، أما الخيام! أنا لا أتفاعل مع هذا الوصف. إذن، قد يكون هناك تفاوت في المتلقي لاختلاف في طبعه يقتضي أن يتفاعل مع وصف دون وصف، ويأنس بوصف دون وصف، لكن هذا لا يعني الاختلاف في درجة البلاغة وروعة الوصف في الكلام نفسه. وسنأتي إن شاء الله في اليوم القادم لذكر بقية الأجوبة عن هذه الشبهة المطروحة.