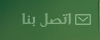بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
ذكرنا أنّ كلامنا في العنصر الثاني من عناصر النية ِألّا وهو التقرّب، والكلام في هذا العنصر من جهات:
الجهة الأولى: ما هو الدليل على اعتبار التقرّب في صحّة الصلاة، وقلنا إنّ الدليل الناهض هو الارتكاز المتشرعي القطعي أن لا تصح الصلاة من دون تقرّب.
ولكن مع ذلك اُستدل على اعتبار قصد التقرب في صحة الصلاة بأدلة خاصّة وأدلّة عامّة، فالأدلة الخاصّة: نحو ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾، أو نحو ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ قد سبق التأمّل فيها في الدرس السابق، ووصل الكلام إلى الوجه الثالث من الأدلة الخاصّة التي أُستدل بها على اعتبار قصد التقرّب في صحة الصلاة:
وهو ما ورد في - الباب 8 من ابواب مقدمة العبادات، حديث 6 - صحيحة عبد الله بن سنان، قال: «كنّا جلوسا عند ابي عبد الله  إذ قال له رجلٌ أتخاف عليّ أن أكون منافقاً؟ فقال
إذ قال له رجلٌ أتخاف عليّ أن أكون منافقاً؟ فقال  : إذا خلوت في بيتك نهارا أو ليلا أليس تُصلي؟ فقال: بلى، فقال: فلمن تصلِّ؟ قال: لله عزّ وجل، قال: فكيف تكون منافقا وأنت تصلِّ لله عزّ وجل لا لغيره».
: إذا خلوت في بيتك نهارا أو ليلا أليس تُصلي؟ فقال: بلى، فقال: فلمن تصلِّ؟ قال: لله عزّ وجل، قال: فكيف تكون منافقا وأنت تصلِّ لله عزّ وجل لا لغيره».
فيُقال: بأن ظاهر الرواية أنّ صحة الصلاة متقومة بكونها لله ولأجل المفروغية عن هذا الاعتبار قال له «فلمن تصلِّ» وإلّا لو لم يكن هذا الشرط مفروغا عن اعتباره في الصلاة لما قال له «فلمن تصلِّ؟ قال: لله عزّ وجل، قال فكيف تكون منافقا وأنت تصلِّ لله عزّ وجل لا لغيره» والنتيجة: أنّ الرواية دالّة على المفروغية عن اعتبار قصد التقرّب في صحّة الصلاة.
والإنصاف: أنّ غاية ما يُستفاد منها خصوصا بقرينة ذيلها: «وأنت تصلِّ لله عزّ وجل لا لغيره» أنّها تدل على مركوزية مانعية الصلاة لغير الله الموجب للنفاق، لا على شرطية قصد التقرّب، مضافا إلى أنّه إذا اُستفيدت شرطية قصد التقرّب بالمدلول الالتزامي فالرواية ليست في مقام بيانه وإنّما اُستفيد من باب أنّه أمر مفروغ عنه.
الرواية الأخرى - من الأدلة الخاصة -: هذه الرواية التي نقلها في التنقيح في الجزء 5 ص 413 وهي حديث3 في باب24 من أبواب مقدمة العبادات، معتبرة يونس عن أبي عبد الله  قال: «قيل له - أي للإمام - وأنا حاضر الرجل يكون في صلاته خاليا فيدخله العُجب - أثناء الصلاة -؟ فقال: إذا كان أوّل صلاته بنية يريد بها ربه فلا يضرّه ما دخله بعد ذلك فليمض في صلاته وليخسأ الشيطان». فيُقال بأنّ مدلولها الالتزامي المفروغية عن اعتبار قصد التقرب؛ لذلك فرّع عليه أنّه لو كان قصد التقرب موجودا في أوّل الصلاة فلا يضرّه ما يدخله بعد ذلك.
قال: «قيل له - أي للإمام - وأنا حاضر الرجل يكون في صلاته خاليا فيدخله العُجب - أثناء الصلاة -؟ فقال: إذا كان أوّل صلاته بنية يريد بها ربه فلا يضرّه ما دخله بعد ذلك فليمض في صلاته وليخسأ الشيطان». فيُقال بأنّ مدلولها الالتزامي المفروغية عن اعتبار قصد التقرب؛ لذلك فرّع عليه أنّه لو كان قصد التقرب موجودا في أوّل الصلاة فلا يضرّه ما يدخله بعد ذلك.
ويرد على الاستدلال بها أنّها في مقام بيان الجملة الشرطية، وهو أنّ من دخل صلاته متقربا لم يضره العجب، وأمّا أنّه يُشترط في صحة صلاته أن يدخل متقربا فلا دلالة لها على ذلك، فما لم نقل بالارتكاز المتشرعي القطعي فلابد أن نلجأ للادلة العامّة، حيث لم يقم دليل خاصّ على اعتبار قصد التقرّب فلابد أن نذهب ِإلى الأدلّة العامّة.
الأدلّة العامة: قد اُستدل على اعتبار قصد التقرّب بدليلين من الكتاب ومن السنّة،
أمّا من الكتاب، فقوله عزّ وجل ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ بدعوى: أنّ ظاهر الآية أنّ المأمور به هو العبادة، ف «اللام» لام التعلّق لام التعدية، يعني أُمروا بالعبادة ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ يعني أُمروا بالعبادة، اللام لام التعدية، أي أنّ المأمور به العبادة مع الإخلاص، وما أُمروا إلا بالعبادة مع الإخلاص، ومقتضى هذا العموم أن يكون المأمور به في الصلاة هو العبادة مع الإخلاص؛ لأنّهم لم يُأمروا إلا بالعبادة مع الإخلاص.
وأشكل سيّدنا «قده» على ذلك: - في التنقيح ص 409 - بالنقض والحل،
أمّا النقض فقال: إنّ لازم هذا الكلام انحصار الأوامر الواردة في الشريعة بالاوامر المتعلقة بالعبادات، فكل ما تعلّق به امر فهو عبادة لا محالة لا يسقط امره إلا بقصد الامتثال، ودون اثبات ذلك خرط القتاد.
وأمّا الحل: فإنّ ظاهر الآية المباركة أنّ العبادة غاية، يعني أنّ اللام ليست لام التعدية بل لام الغاية، «أُمروا لأجل ذلك»، أنّ العبادة غاية، كما أنّها غاية للخلق كما صرح به في قوله عزّ من قائل ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ فمفاد الآية أنّ العبادة هي الغاية القصوى، أي ما أُمروا بأمر في الشريعة إلا لكي يصلوا إلى العبادة التي هي الغاية من خلقهم، لا أنّهم لم يؤمروا إلا بالعبادة، أُمروا بالتوصليات لكن الغاية من أمرهم بالتوصليات أيضا أن يكونوا عابدين لله عزّ وجل لا أنّهم أمروا أن تكون جميع أفعالهم على نحو تعبدي.
ولكن قد يُقال: بأنّ ظاهر العطف في الآية أنّ العبادة هي المأمور بها لا أنّها غاية؛ لأنّه قال: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ﴾ وحيث إنّ المعطوف ممّا أُمروا به وهو اقامة الصلاة وايتاء الزكاة، فهو قرينة على أنّ المعطوف عليه أيضاً ممّا أُمروا به لا أنّه غاية للامر، أي وما أُمروا إلّا بالعبادة واقامة الصلاة وايتاء الزكاة، من باب عطف الخاص على العام، لا أنّه إنّما أمروا لأن يصلوا إلى عبادة الله تبارك وتعالى، فيكون السياق قرينة على أن اللام «لام التعدية» وليست «لام الغاية» وحينئذ وجود اوامر توصلية في الشريعة يكون من باب التخصيص لا أنّه يتنافى مع دلالة الآية على الحصر، نظير قوله «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب اربع خصال» ثم خصصّ هذا الحصر بعدّة مفطرات، فاستخدام لسان الحصر مع وجود مخصصات في الواقع إنّما هو لبيان اهمية ما حُصر فيه الخطاب لا أنّه يتنافى مع تخصيصه، نظير قوله عزّ وجل «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلّا من ظلم» النساء 148 مع أنّ هناك مبررات اخرى لجواز الجهر بالسوء غير المظلومية.
وأشكل سيّدنا «قده» إشكالا آخر على الاستدلال بالآية: قال: لو تنزلنا وبنينا على أنّ اللام بمعنى الباء، يعني لام التعدية، فايضا لا يمكن الاستدلال بها على المدعى، وذلك لأنّها إنما تدل على أنّ العبادة لابد أن تكون منحصرة في الله، ولا عبادة لغيره من الأوثان، فهي في مقام بيان نفي الشرك لا في مقام بيان اعتبار قصد التقرّب، والشاهد على ذلك: السياق، ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ * رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً* فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ * وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ أي في العبادة هذا عبد عُزير وهذا عبد عيسى، وهذا عبد الصنم، أي وما تفرقوا عن العبادة ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ * وَمَا أُمِرُوا﴾ أي وما اُمروا بتلك العبادات التي تفرقوا بها إنّما أُمروا بعبادة الله وحده، فهي في مقام بيان أنّهم لم يؤمروا بالعبادات الرائجة بينهم، وهي عبادة غير الله وإنّما الذي أُمروا به هو عبادة الله وحده، لا أنّها في مقام بيان اعتبار قصد التقرّب، ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ﴾ فهي بصدد بيان انحصار المعبود بالله العظيم، واين هذا من اعتبار قصد التقرّب والامتثال في الواجبات فالآية اجنبية عمّا نحن بصدده بالكليّة.
ويُلاحظ على هذه المناقشة: أنّ الآية اعتبرت عدّة قيود، قالت: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ ومن الواضح أن اخلاص العبادة فرع اعتبار قصد التقرّب لأنّ اعتبار الاخلاص مرتبة عالية من التقرّب إلى الله تبارك وتعالى، والنتيجة: أنّه مجرد ورود الآية في سياق نفي الشرك في العبادة لا يُوجب انحصارها في هذا المدلول، فغايته أنّ الآية شاملة لمدلولها لما هو مورد سياقها، فكأنّ الآية قالت: ما أُمروا بالعبادات الرائجة بينهم إنّما الذي امروا به بعبادة الله مع الإخلاص، الدال على اعتبار قصد التقرب دلالة تضمنية. هذا من حيث الاستدلال بالكتاب.
وأمّا من حيث الاستدلال بالسنّة:
فقد ذكر صاحب الوسائل بابا من ابواب مقدمة العبادات ألّا وهو باب 5، قال: باب وجوب النية في العبادات الواجبة واشتراطها بها مطلقا. وذكر من روايات هذا الباب، ما ورد من أنّ «الاعمال بالنيّات»، «ولا عمل إلّا بنية» ونحو ذلك، فربّما يُستدل بظاهرها كما ذكر السيّد الإمام في كتاب الخلل من أنّه لمّا كان كل عمل مشروطا بالنية والنية عبارة عن قصد العمل متقربا إلى الله عزّ وجل كان ذلك دليلا عاما على اعتبار قصد القربة في كل ما هو مأمور به خرجت التوصليات بالدليل الخاص.
ولكنّ سيّدنا «قده» اشكل على ذلك: قال: إنّ المحتملات في عنوان «النية» امور:
الأوّل: أنّ المراد بالنية قصد الامتثال، قال: ولكن يرده أنّ النية عرفا ليست بمعنى قصد القربة، ولو حُملت النية على قصد القربة لزم تخصيص الأكثر، وهو مستهجن، فإنّ العبادات في جنب التوصليات قليلة في النهاية، والصحة في التوصليات لا تنتفي بعدم قصد الامتثال.
المحتمل الثاني: أن يُراد بالنية قصد العنوان، كأن يقصد الصلاة، يقصد الصيام، وعلى هذا الاحتمال تكون الاخبار اجنبية عن المدعى وإنما تدلنا على أنّ العمل الاختياري يُعتبر في صحته أن يكون صادرا بقصد عنوانه ولا يُستفاد منها اعتبار قصد القربة.
لكنّ الاخبار المذكورة أيضا لا دلالة لها على هذا المعنى الثاني؛ لأنّ بيان اعتبار قصد العنوان بالاضافة إلى الافعال القصدية يُعتبر من قبيل توضيح الواضحات، غير المناسب للامام  لوضوح إن تلك الافعال حيث إنّها قصدية فهي متقومة بقصد عنوانها. وأمّا بالاضافة إلى التوصليات التي لا تتقوم بقصدها وارادة عناوينها، فهو يستلزم محذور تخصيص الأكثر.
لوضوح إن تلك الافعال حيث إنّها قصدية فهي متقومة بقصد عنوانها. وأمّا بالاضافة إلى التوصليات التي لا تتقوم بقصدها وارادة عناوينها، فهو يستلزم محذور تخصيص الأكثر.
الاحتمال الثالث: أنّ المراد بالنية الداعي المحرّك نحو العمل، فكأنّ الرواية قالت: حسن العمل بحسن داعيه، فهذا هو معنى «إنما الاعمال بالنيات» أي إنما حسنها بحسن داعيها، فإن كان الداعي لها حسنا كان العمل حسنا وإلّا كان قبيحا، كضرب اليتيم مثلاً، فإنّه إن كان بداعي التأديب كان حسنا، وإن كان بداعي الإيذاء كان قبيحا، وكالنوم إن كان بداعي الاستراحة المهيئة للعبادة لصلاة الليل اتصف بالحسن، وإن كان بداعي الاستراحة لقتل مؤمن اتصف بالقبح، وهكذا الصلاة فإنّ الداعي لها إن كان قصد الامتثال اتصفت بالحسن وإن كان هو الرياء اتصفت بالقبح، وبهذا يصح أن يُقال: «لا عمل إلا بنية» وأنّ الميزان في القبح والحسن على الداعي، والقرينة أنه قال في بعض هذه الروايات وهو حديث 10 باب 5 «فمن غزى ابتغاء ما عند الله فقد وقع اجره على الله، ومن غزى يريد عرض الدنيا او نوى عقالا لم يكن له إلّا ما نوى»، وهذا هو المناسب ايضا لقوله في بعض هذه الروايات «لا قول إلا بعمل ولا عمل إلا بنية ولا قول ولا عمل بنية إلّا بإصابة السنة» كما في الحديث 2 و4 ألّا وهو باب 5، حيث يُستفاد منها أنّ المراد بالنية ليس هو قصد القربة؛ إذ لو كان المراد بها قصد القربة لكانت مصيبة للسنة على كل حال، فلا معنى لأن يقول «ولا قول ولا عمل بنية إلا باصابة السنة» ممّا يشهد على أنّ المراد بالنية في هذه الروايات الداعي والمحرّك، وكلامه متين كسائر متانة كلماته «قده»، يأتي الكلام في بقية الكلام.
والحمد لله رب العالمين